
أرسل بريدا إلكترونيا2025-04-14
هي رسومات لفضاء جغرافيّ تمّ صوغه بصريًّا عبر عين استشراقيّة سابقة للنظر، مصقولة بخيال جماليّ متداخل مع سلطة التسمية والامتلاك الرمزيّ. من هذا المنظور، لا يُمكن التعامل مع رسوم فان دي فيلد عن جبل عامل– بما فيها بنت جبيل وصور والشقيف وجزين وغيرها– كتوثيق واقعيّ أو انعكاس محايد، بل كوسيط بصريّ يخلق زمنًا مؤطَّرًا، ويعيد ترتيب الجغرافيا ضمن نسق رمزيّ يخدم رؤية تتجاوز المبنى إلى المعنى.
إنّ قوّة هذه الرسوم لا تكمن في واقعيّتها التقنيّة فحسب، بل في قدرتها على تشكيل نوع من ”الوعي البصريّ“ الجماعيّ تجاه المكان. فالفنّان لا يُعيد إنتاج الطبيعة مثلما هي، بل يُعيد إنتاج العين التي تراها– عين مدهوشة، مسحورة، لكنّها أيضًا مهيمنة رمزيًّا. وهنا تتقاطع المسألة الجماليّة مع الأدلجة البصريّة: فالجمال الظاهر في الخطوط، الظلال، والتكوينات المعماريّة هو جزء من بنية تمثيليّة تجعل من المكان الشرقيّ ”قابلًا للتملّك“، لا فقط للتأمّل.
مسح مكانيّ
تتوزع هذه اللوحات بين القلاع والينابيع والجسور والقرى والجبال، من قلعة تبنين والشقيف وهونين، إلى شلّال جزّين، جسر القاعقعيّة، نبع الطاسة وصور، ومنها إلى جبل الشيخ (حرمون) وقاموع الهرمل، في مشهد بانوراميّ شامل يمتدّ من رأس الناقورة حتّى سفوح البقاع. كلّ مشهدٍ مصوَّر يحمل اسمه بالفرنسيّة، ويقف شاهدًا على طبقات من الزمن والجغرافيا والوظيفة. وعلى رغم أنّ هذه الرسوم أنجزت في إطار استشراقيّ أوروبّيّ أراد الإمساك بالشرق إلّا أنّ قيمتها التوثيقيّة والفنّيّة لا يمكن إنكارها، خصوصًا أنّها سبقت التصوير الفوتوغرافيّ بزمنٍ قليل، وسجّلت ملامح عمرانيّة وطبيعيّة لقرى ومناطق تعرّضت لاحقًا للتحوّل، الطمس، أو الزوال. هي وثائق تنتمي إلى حقل ”الفنّ الوثيقة“، حيث تتقاطع الخطوط والألوان مع التاريخ والأنثروبّولوجيا.
لكنّ المدهش في رسوم جبل عامل، هو أنّ هذه الليتوغرافيّات، على الرغم من انغراسها في الخطاب الاستشراقيّ، تُقدّم طبقات من الدلالة التي تتجاوز النيّة الأصليّة للفنّان. فمن خلال تحليل مكوّناتها البصريّة (الزوايا المختارة، خطوط الأفق، توزيع الضوء، حضور الإنسان القرويّ، هندسة القباب، حركة القوافل) نلاحظ تشكّل جغرافيا شعوريّة للمكان، لا تختلف كثيرًا عن تلك التي نشهدها في أعمال الفنّ المعاصر المهتمّ بالذاكرة والهويّة.
موضوع اللوحة سؤال مفتوح
الخطّ هنا لا يُحدّد الشكل فقط، بل يعيد ترتيب الحضور، يمنح المشهد هشاشة أثريّة، كأنّ الرسّام لا يرسم ما يراه، بل ما يخشى أن يضيع منه. هذه الهشاشة تلتقي تمامًا مع تصوّر هال فوستر عن ”عودة الواقعيّ“، حيث لا يُستعاد الماضي بوصفه حقيقة مكتملة، بل بوصفه شرخًا بصريًّا، أثرًا مقاومًا للطمس، قابلًا للقراءة أكثر ممّا هو قابل للمشاهدة.
في لوحات: بنت جبيل، شلال جزين، قبر حيرام، نبع أفقا، وحاصبيا، لا نرى المكان فقط، بل نرى تموضع الإنسان فيه، نرى كيف تتجاور الطبيعة مع المعمار، وكيف تُصبح الجغرافيا أداة لقول شيء عن الناس، عن علاقتهم بالماء، بالحجر، بالساحة، بالظلّ، وبالعبور. ليست بنت جبيل وصور وصيدا وجباع في هذه الأعمال، موضوعات مغلقة، بل أسئلة مفتوحة، تنتقل من الناظر إلى المنظور، ومن الذاكرة إلى اللغة البصريّة، لتصوغ سرديّة معقّدة حول الهويّة والتغيّر والامّحاء.
في لوحات: بنت جبيل، شلال جزين، قبر حيرام، نبع أفقا، وحاصبيا، لا نرى المكان فقط، بل نرى تموضع الإنسان فيه، نرى كيف تتجاور الطبيعة مع المعمار، وكيف تُصبح الجغرافيا أداة لقول شيء عن الناس
وفي هذه الوثائق، لا يظهر جبل عامل مجرّد بقعة جغرافيّة، بل نسيج حيّ: فيه القباب والأسواق والنُزل والقلاع والحقول والبرك والمشاهد الزراعيّة التي توثّق نظام حياةٍ شاقٍّ ولكنّه منتظم وبسيط، ولكنّه مشحون بالرموز والذاكرة. ونحن إذ نقرأ اليوم هذه اللوحات، لا نبحث عن جماليّات الماضي وحسب، بل عن أدلّته؛ عن مفاتيح لفهم البنية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والعمرانيّة لجبل عامل قبل أن يُعاد تشكيله قسرًا في العقود التالية بفعل الاحتلال والحداثة وسياسات الإعمار. إنّها ليست مجرّد صور، بل بقايا من حلمٍ معلّق على صفحات التاريخ.
مائيّات وليتوغرافيا
في التحليل البصريّ لهذه الأعمال، نلحظ حضورًا كثيفًا للزمن كعنصر سرديّ، وكبنية تحتيّة للشكل. الألوان المائيّة المستخدمة تمنح المشاهد شفافيّة خاصّة، تُشبه ذلك النوع من الحنين الذي لا يُقال، بل يُلمس. أمّا الخطوط الدقيقة التي ترسم ملامح البناء أو الحقول أو الجبال، فهي ليست محاولة لإعادة إنتاج الواقع، بقدر ما هي سعي لتثبيت أثره قبل أن يتلاشى.
ويُلاحظ أنّ التكوينات المعماريّة، مثل الأعمدة والتاجيّات والزخارف والمقامات، لا تُنقل مجرّد مكوّنات عمرانيّة، بل تُستعاد كعناصر في نظام شعائريّ يعكس علاقة الإنسان بالمكان المقدّس، وارتباط الجسد المعاش بالجغرافيا المتحوّلة. إنّ حضور جبل الشيخ في خلفيّة بعض الأعمال، مثلًا، ليس بوصفه تضاريس وحسب، بل كرمز لمراقبة صامتة، لتاريخٍ لا يزال حيًّا في ملامح الأرض.
كذلك، إنّ تقنيّات الرسم الليتوغرافيّ التي استُخدمت لطباعة هذه الأعمال تُضيف بعدًا إجرائيًّا ذا أهمّيّة. فالليتوغرافيا، كعمليّة فنّيّة تعتمد الرسم على الحجر ونقله بالضغط إلى الورق، تسمح بخلق عدد من النسخ ”الأصليّة“ في آن، ما يجعل من كلّ نسخة أثرًا مباشرًا من لحظة الإبداع الأولى. هذه التقنيّة، التي ازدهرت في القرن التاسع عشر، لا تنقل الشكل فقط، بل تحتفظ بطاقة اليد التي رسمت، بضغوطها الدقيقة، وبتفاوت الظلّ والضوء، وباهتزازات الخطّ التي تعكس طبيعة الارتجاف الداخليّ لحظة الإمساك بالمشهد.
وهكذا، فإنّ هذه الأعمال في بُعدها الليتوغرافيّ، لا تمثّل المكان وحسب، بل تحمل أثرَ ”كيفيّة تمثيله“، وهي بذلك ليست نسخًا متكرّرة بل تجارب شعوريّة مكرّرة، يتقاطع فيها الجماليّ مع الإجرائيّ، والحسّيّ مع المادّيّ. إنّ القيمة الجماليّة لهذه الرسوم لا تنفصل عن بعدها التأويليّ، حيث يصبح المكان مادّة لتفكيك أنماط التمثيل لا لتأكيدها. ليست بنت جبيل وصور وصيدا وجباع في هذه الأعمال موضوعات مغلقة، بل أسئلة مفتوحة، تنتقل من الناظر إلى المنظور، ومن الذاكرة إلى اللغة البصريّة، لتصوغ سرديّة معقّدة حول الهويّة والتغيّر والامّحاء.
رماد التحوّلات
من هنا، فإنّ إعادة قراءة هذه الرسوم اليوم، في سياقنا الراهن، تعني استعادة أثرٍ بصريٍّ لحقيقة لم تعُد قائمة كما كانت، ولكنّها لا تزال تنبض كاحتمال جماليّ، وكوثيقة مقاومة ضدّ النسيان، ضدّ التبسيط، وضدّ طغيان الصورة السريعة.
إنّ تحليل هذه الوثائق كخطاب فنّيّ، وتفكيك بنيتها التقنيّة والأيقونوغرافيّة، لا يهدف إلى مقارنتها بالنماذج الغربيّة الكبرى، بل إلى كشف خصوصيّتها كمرآة خافتة لحياة متحوّلة، نعرف يقينًا أنّها لم تعُد مثلما كانت، لكنّنا نستطيع من خلال هذه الرسوم أن نسمع صداها، أن نرى انعكاسها الحالم، أن نعاين ملامحها تحت رماد التحوّلات والحروب والإعمار المفاجئ. إنّها ذاكرة مرسومة، لا تقدّم التاريخ كيقين، بل كحسرة. لا ترسم الماضي، بل تخلقه من جديد بلونٍ مائيّ هشّ، فوق ورقٍ خائف من النسيان.

شلال جزين، رسم فان دو فيلد

قلعة هونين

نهر الزهراني
 الخيام | khiyam.com
الخيام | khiyam.com 






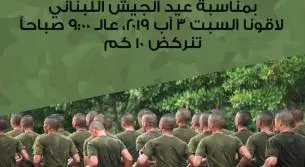




تعليقات: