
سوق السمك صار في بيروت: عمري 16 سنة
بلاد «المؤقت»... الذي صار دائماً
يرتاح سوق بيروت منذ 26 عاماً على أرضٍ محاذية لملعب المدينة الرياضية (هيثم الموسوي)
ما بني على باطل فهو باطل. هذه المقولة لا يمكن الاستعانة بها في لبنان، حيث يبدو وكأن كلّ شيء فيه بني على باطل. هنا، تتساوى الأبنية الشرعية مع غير شرعية. بل قد يتفوّق الثاني على الأول. وهنا، قلّما تجد مستورد دواء نظامياً. وهنا أيضاً، من الصعب أن تجد سياسياً لا يعمل على طريقة الحريري الأب والابن: مقاولاً ناجحاً فتحت له أبواب الدولة لتفصيل قوانين على مقاس شركاته وأعماله. كلّ ما ذكر أعلاه قد يراه البعض عادياً، على اعتبار أن «هيدا لبنان وهيدا جوّو»، لكن ما ليس عادياً أن تنشئ الدولة قصوراً لا حاجة لها على آلاف الأمتار المهدورة وبملايين الدولارات، وتعجز عن إيجاد أماكن للقمة عيش فقراء، فتتركها في المؤقت سنوات طويلة لتعذّر إيجاد البديل، حتى تصبح دائمة بصفة المؤقت. الأمثلة كثيرة عن هذا المؤقت، من المسلخ الذي يعيش في المؤقت منذ 30 عاماً، إلى سوق السمك منذ 16 عاماً، إلى سوق الخضار المركزي لبيروت منذ 26 عاماً إلى ثكنة الجيش على أملاك الناس في الكرنتينا إلى، إلى... في مقابل هذه المرافق الحيوية، تشرعن مؤقتات مخالفة لاستفادات شخصية، والبيال مثال.
سوق السمك صار عمري 16 سنة
راجانا حمية
في تلك الزاوية الصغيرة التي استأجرها بسعر يفوق ربحه، يجلس أبو علي القرفصاء، منادياً على «سمكاته» الطازجة. كان النهار قد انتصف، والعمّ لم يبع من السمك المطروح أمامه إلا ستة كيلوغرامات، وقد لا يبيع أكثر منها، فما بقي من نهار العمل «هو ربع ما مضى». وعلى أساس هذا الربع المتبقي، يحسب الرجل «غلّته الصافية» التي لن تكون أكثر من عشرين ألف ليرة لبنانية. من هذه العشرين، سيضع البائع العتيق 5 آلاف ليرة جانباً، ويضيفها لاحقاً إلى «الخمسات» المتبقية، لتسديد أجرة محلّه البالغة 550 ألف ليرة لبنانية يدفعها عند رأس كل فصل للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
هو راضٍ تماماً عن هذا الربح، ففي «بحر» الأسبوع تكون العشرون «نعمة»، بسبب قلّة قاصدي السوق المركزي في الكرنتينا. لكن، في بحر ذلك الأسبوع الذي قصدنا فيه السوق، كان أبو علي «ريّس» البائعين هناك، وواحداً من اللبنانيين القلائل الموجودين، وسط «زحمة» العاملين السوريين. السبب الظاهر الذي يقوله هو أن «البائع اللبناني يشتري البضاعة ويبيع الجملة فجراً، ويترك بيع المفرّق للعمال السوريين». ومن يبقى من البائعين اللبنانيين «هم من يبيعون غلّتهم بأيديهم»، يتابع. لكن، ثمة سبب آخر لهذا الحضور اللبناني الخجول، والذي لا يعرفه إلا هم. فهنا، في السوق «المخنوق» برائحة «بقايا» المسلخ الحديث المجاور، صادق أبناء بلدة كونين الجنوبية البحر، فصاروا هم الأساس، صيداً وبيعاً وتجارة. لهذا، كان الفراغ كبيراً في ذلك اليوم، لأن معظم التجار كانوا في «البلد» يشيعون جاراً لهم.
هؤلاء الذين يعتاشون من البحر وسوقه، هم أنفسهم الذين يكوّنون «تتمة» الحكاية التي بدأت في سوق أبو النصر، الذي كان في «ساحة البرج»، والتي صارت نفسها قصة «المؤقت» في الكرنتينا، المستمر منذ 16 عاماً.
في العام 1976، هجّرت الحرب أبو علي من سوق أبو النصر. يومها، لم يكن الرجل، الذي يقترب اليوم من سبعينه، بائعاً مستقلاً. كان يساعد والده في البيع. لكن، عندما انتقل السوق إلى المنطقة التي تسمّى اليوم «جسر سليم سلام» صار أبو علي «معلّماً». في ذلك الوقت، كانت تجارة السمك لا تزال «معزوزة»، حيث «كنا نشتري الكذا كيلو بليرة ونبيعهم بليرتين». بقي أبو علي في المنطقة حتى بدأ العمل بالجسر، لينتقل بعدها إلى سوق المدينة الرياضية. من هناك، تهجّر الرجل مرة ثالثة، حين بدأ الرئيس الراحل رفيق الحريري «تنظيم المدينة الرياضية». يومها، «نقلنا الحريري إلى الكرنتينا، على أساس أن تكون النقلة مؤقتة ريثما يجد مجلس الوزراء الذي يتبع له السوق البديل».
مرت أعوام، وبقي المؤقت. لم يوجد البديل، كما هو الحال بالنسبة للمسلخ المجاور وثكنة الجيش الرابضة على أملاك الناس المجاورة أيضاً. وهناك، انطبق المؤقت على كل شيء: الكهرباء. خزان المياه. سقف الزينكو. كل شيء، حتى على البائعين الذين يعيشون حيواتهم يوماً بيوم.
في سوق «الدولة» ـ بما أنه تابع لمجلس الوزراء مباشرة ـ ثمة شبه كبير بين المياه والكهرباء فيه ومياه وكهرباء «الضاحية»، يقول رئيس نقابة بائعي الأسماك في بيروت عبدالله غزال. فهناك، «تكّت» و«إجت» وهنا أيضاً. وإذ حسّنت «سلطة الوصاية» الأمور قليلاً عبر تأمين اشتراك بمياه بيروت عندما تنقطع المياه الموجودة، إلا «أننا في كثير من الأحيان قد نفقدها تماماً».. وقد لا تغسل حينها «سمكات الزبائن».
والطريق؟ حدّث ولا حرج، فعدا رائحة المسلخ التي «تهرّب» نصف الزبائن، يهرب النصف الآخر من الطريق المسدود بالشاحنات التي لم تُبق فسحة للسوق. وفي هذا الإطار، يشير غزال إلى أن «البائعين احتجوا في فترة من الفترات، فلم يكن من أصحاب الشاحنات إلا أن أبدوا حسن نية، وركنوا شاحناتهم جانباً». وبعد يومين عادت الشاحنات إلى مكانها ولا تزال.
أما سقف الزينكو، فصار «في الصيف حريق وفي الشتاء غريق». لم يعد سقفاً أصلاً. تشظى. صار قطعاً. في الصيف، «يشوى» البائعون والزبائن، وفي الشتاء يغتسلون.. مرتين. من السقف ومن المياه الجارية مما تبقى من نهر بيروت. أما ما هو «ماشي» صيفاً وشتاء فهو رائحة اللحم النتن الذي تفرزه فرّامة المسلخ والدماء الجارية التي تصل إلى السوق. يقول غزال.
مع ذلك، لا يمكن بأية حالٍ من الأحوال تسوية ما هلك، لأن الأمر مرهون بقراراتٍ تتخذ في مجلس الوزراء كونها هي السلطة المسؤولة عنه. لكن، بما أنه مؤقت، فلا يمكن التصرّف بشيء هنا. ثمة سبب آخر، وهو الخلاف «السياسي» على هذا المرفق من جهة، وربط تسويته بتسوية المسلخ، رغم أن الأخير تابع للبلدية. يعني «تسوية سوق السمك الذي تسيطر عليه أغلبية شيعية معروفة الانتماء يفترض من جهة أخرى تسوية مرفق السنة المجاور: المسلخ»، يقول أحدهم.
لهذا السبب، ولأسباب المؤقت، لا شيء سيغيّر الحال في السوق. وعلى شاكلة ما يجري اليوم، فقد تصبح الـ16 عاماً، عشرين وربما أكثر. والبائعون «متأكدون» من هذه الاستمرارية، والسبب بسيط «لو بدها تشتي كانت غيمت»، يقول البائع الشاب حسن ديب، الكونيني هو الآخر، الذي ورث المهنة عن والده. بدأ ديب العمل «بناء على نصيحة الأهل»، وهو، بعد هذه السنوات، يشعر بشيء يشبه «الرضا، فطالما أن لي بسطة في السوق، فقدّ ما بعت بيع». لكن، في كل الأحوال، لا تنقص «جمعيتي عن 200 ألف وقد أصل إلى 300 ألف، إذا عملت شيء تنقيرة بنصف الأسبوع». وهذه الـ300 قد يجنيها حسين بسهولة قبل الوصول إلى آخر الجمعة، فيما لو «طار» سعر السمك. فهنا، «السمك مثل البورصة، بلحظة يطلع وبلحظة ينزل». وعندما «يطلع»، تكبر الرزقة. هذه الرزقة ضُربت مرتين: مرة بعد حرب تموز التي «أتلفت كل شيء، حتى وجودنا في السوق»، ومرة أخرى مع «ضربة سوريا التي أقفلت سوق سوريا أمام التجار».
لكن الضربة الأخيرة لم تنته، ولها مفاعيلها المباشرة أيضاً على السوق. فهنا، الكل ـ تجار جملة ومفرق ـ يعتمد على السمك المستورد. وعندما تصاب «عبّارة طرابلس» بسوء نتيجة سوء الأوضاع، يغيب «السمك التركي عن السوق»، يقول غزال. وقبل أكثر من شهر، حدث هذا الأمر، وفرغت السوق، كونها تعتمد على «التركي بنسبة 60%». والبقية «مصري 20% وموريتاني وسنغالي». أما المحلي، فـ«شم ولا تدوق»، وهو أكثر الأصناف ندرة في السوق. ولذلك أسباب، منها أن «تصريفها صعب، كونها باهظة السعر وعدد مستهلكيها قليل جداً، إلا في مواسمها»، يتابع غزال. هناك أسباب أخرى يذكرها ديب، ومنها أن «سمكنا على عمق ومراكبنا غير مجهزة وأزمة الصيادين الجائرين».
لكل هذه الأسباب، من دون المستورد «لا سوق». هكذا يقولون. لكن، مع المستورد ومن دونه «السمك لا يسدّ جوعاً»، يقول جهاد درويش. فالشاب الذي «ينظف كيلو السمك بـ500 ليرة»، يعرف أن «ساعتين من المرض ستكلفني ما جنيته طيلة الشهر، بما أنه لا ضمان ولا تأمين هنا». أما ديب فيعرف أكثر. يعرف بأن مهنته «أغلبها تركيب طرابيش، بنتشري من هون لنسكّر من هون». ومن دون هذا «الطربوش»، لا تمشي الحياة، ولا السوق.
6 و6 مكرر
جيران سوق السمك لا «يبيّضون» الوجه. والمقصود بهؤلاء، هم «الغالبية المسيّسة في المسلخ»، يقول أحدهم. فالعلاقة بين الجيران في السوق والمسلخ «مشوشة». بالظاهر جيدة، وبالباطن تشبه تماماً حال العلاقة بين حزب الله والمستقبل. فهنا، يوجد خط تماس أيضاً. بين «شيعة يحتكرون سوق السمك وسنة يصبغون المسلخ بوجودهم». هذا الأمر أثر سياسياً أيضاً في حال الجارين، «فأي شيء بدو ينعمل هنا بدهن متلو هناك». وعلى قاعدة الـ«6 و6 مكرّر»، خسر الجاران.
في المدينة الرياضية سوق ينتظر
في العام 1986، افتتح سوق الخضار المركزي لبيروت في قلب المدينة الرياضية على أن يكون مؤقتاً في انتظار البديل. في العام 2012، صارت المدينة الرياضية المكان الثابت للسوق بصفة المؤقت
لم يكنس عمال النظافة أرض السوق بعد. كان النهار قد انتصف، وبقايا الخضار المسحولة تملأ المساحات الفارغة بين محال الزينكو. في هذه الساعة من النهار، لا أحد يكترث لهذا التفصيل، فثمة وقت «مقدّس» للراحة يستغلّه أصحاب المحال في سوق الخضار المركزي لمدينة بيروت لتنظيم حسابات ليلٍ متعب.
في تلك الساعة من النهار، يرتاح سوق بيروت للجملة، المؤقت منذ 26 عاماً على أرضٍ محاذية لملعب مدينة بيروت الرياضية، من الأجساد المتلاصقة التي لا تتركه إلا لترتاح. لا يعود السوق هو نفسه كما في ساعات الذروة. تخفت الجلبة التي تتسبب فيها حركة الشاحنات العابرة في ممراتٍ رسمت بعشوائية المؤقت، وتتثاقل أقدام العابرين القلائل. أما في ساعات الذروة، التي تستغرق ليلاً طويلاً و«صبحية»، فلا يشبه الدخول إلى السوق الخروج منه، حيث تفقد القدم موطئها ويصبح الدخول مغامرة غير محسوبة أبداً.
هنا، في سوق بيروت، حيث الهدوء حدث نادر، كل شيء عشوائي، حتى هو. فالسوق البيروتي، الذي أنشأته بلدية بيروت على أرض، تابع جزء منها لبلدية الغبيري على سبيل المؤقت، لا يزال مؤقتاً منذ 26 عاماً. هذه الصفة التي لم تسعفه في تغيير حاله المستقرة منذ سنين على الوتيرة نفسها.
160 محلاً لم تتغير منذ العام 1986، تاريخ افتتاح السوق. لا تزال هي هي، لم تكبر ولم تزد تفاصيلها. محال من الزينكو لا ترف فيها. أما أصحابها، فهم أنفسهم الذين كانوا في معظمهم بائعين في ساحة البرج في وسط العاصمة، والمسجلين في السجل التجاري، فيما القلة الجديدة منهم هم من اشتروا «الأسماء التجارية» من أصحابها الذين ماتوا أو ملّوا مهنة تتكرر كل يوم.
أما من بقوا على مهنتهم، فلن يغادروها بعدما نسجوا شبكة زبائنهم. يتحدث هؤلاء عن الأسعار التي «تكون حسب الزبون، تضاف إليها الكمية والنوعية والصنف»، يقول ابراهيم فاضل، المنتسب إلى النقابة والمرشح لانتخاباتها المقبلة. ينتقل الرجل للحديث عن «عمولة الـ10%»، التي يتقاضاها صاحب المحل من صاحب البضاعة. وهي النسبة التي «يمكن التلاعب بها، كأن يعطي صاحب المحل فاتورة لصاحب البضاعة أقل من الفاتورة الاجمالية»، يقول نادر، أحد العاملين في السوق. وكما يلعب «الحظ» في العمولة، يلعب أيضاً في التصريف، إذ «في بعض الأحيان أصرّف جلّ بضاعتي وفي أيام أخرى قد أرمي الكثير منها»، يقول أحمد عجاج، صاحب أحد المحال.
هكذا هي حال السوق. عرض وطلب وسعر يخضع عادة للزبون والكمية والنوعية. أما الوزارات المعنية بمراقبة الأسعار، فـ«طنّش تعش تنتعش». فهنا، السوق لا يرعاه إلا الله ومجلس نقابة «سمعته على قد الحال»، مقسّم على الطريقة اللبنانية: 4 شيعة و8 سنّة، فيما غاب المسيحي بعد الرحيل من ساحة البرج وانتقال المسيحيين إلى سوق سن الفيل. أما مهام مجلس نقابة معلمي وتجار سوق الخضار، فلا تعدو كونها مهام بلدية «من كهرباء وصيانة ونظافة»، يشير فاضل. ولتغطية نفقات تلك المهام، تتقاضى النقابة من أصحاب المحال 250 ألف ليرة لبنانية شهرياً قد تزيد مطلع العام «50 ألفاً»، يتابع عجاج.
نسبة لم تكن شيئاً يذكر في السوق الأساس في ساحة البرج، حيث كانت المحال مستأجرة من الأوقاف «وكانت القيمة زهيدة جداً»، يقول فاضل. هناك، كان السوق جزءاً من أسواق كثيرة وثابتة حتى أتت الحرب اللبنانية عام 1975 وهجرت الأسواق. هكذا، طفر السوق وأهله. تشتتوا سنوات لعدم وجود مكانٍ بديل يتسع لكل هؤلاء البشر. وحين بدأ العمران يكثر في قلب العاصمة، بدأ البحث عن مكانٍ آخر للسوق، وهو الذي وجد لاحقاً في العام 1983 على أرض مملوك عقار منها لوزارة المالية وآخر لبلدية الغبيري، وافتتح في العام 1986 على أنه مؤقت. في فترة التسعينيات، بدأ البحث عن مكانٍ آخر ثابت للسوق، فكان الإقتراح الأول «ساحة العبد» على المتحف، إلا أن الاقتراح لم يمر بعدما رفضت «سكة الحديد والقوى السياسية الأمر، على اعتبار أنه يضرب المنطقة عقارياً»، كما لم يمر اقتراح ثانٍ في صحراء الشويفات وثالث في الحدث ورابع... والرافضون «القوى السياسية والناس أيضاً». هكذا، نبذ السوق، وبقي حيث هو ثابتاً بصفة المؤقت. أما السبب المتعلق بضرب المنطقة عقارياً، فلم تنفد منه المنطقة المحيطة، التي نبتت على أطرافها عشوائيات وحياة مؤقتة لعائلات قطنوا هناك في مساحاتٍ «استثمروها» هم أيضاً.. مؤقتاً.
راجانا...
مجمع «بيال»: المخالفة الدائمة
كان من المفترض أن يقام هذا المكان لمرة واحدة فقط يستضيف فيه لبنان القمة الفرنكوفونية. لكن، ما أقيم لمرة واحدة صار لمدى العمر. وبدل الخيم المستعارة صار هناك ما يسمى البيال، المجمع الضخم للثقافة والترفيه
إذا كنت تنوي الزواج، فلا تتزوج.. في مجمع «بيال» أو مركز بيروت الدولي للمعارض والترفيه، خصوصاً إن كنت لا تنتمي إلى الطبقة الميسورة. هنا، في البيال، تتجاوز تكلفة الزفاف العادي، من دون إضافات «برجوازية»، الـ50 ألف دولار «بالميتة»، إذا كان الحجز «كاملاً، أي حوالى 450 مدعواً»، تقول إحدى العاملات في قسم المبيعات في المجمّع.
هذه القيمة، العالية نسبياً، لا تستهوي إلا البرجوازيين... أو المخبولين. لا أحد من خارج الصف. لكن، هذه البقعة التي صارت «محجوزة» لأصحاب المال الوفير، إن كان في مطاعمها أو في صالات حفلاتها أو في قاعات المؤتمرات، تتحدّد «فاتورتها» من ذلك المكان الذي أقيمت فيه. على عتبة البحر الذي احتجزته شركة سوليدير.
لكن، هل يعرف أحدكم كيف بني هذا «الصرح» العالي الفخامة؟
في العام 2000، نبتت الفكرة في رأس الرئيس الراحل رفيق الحريري. في حينها، كانت الحكومة تبحث عن مكان تستضيف فيه القمة الفرنكوفونية. طرحت الكثير من الأماكن، مثل البيروت هول والفوروم دو بيروت. وبعد البحث والتمحيص، ارتأى الحريري الأب أن تنقل بعض خيم البيروت هول وتوضع على تلك الردمية التي كانت في حينها ملكاً للدولة، وصارت اليوم البيال، الملحقة بـ«سوليدير» تحت إدارة محمود جويدي، المدير العام للبيروت هول. في ذلك الحين، أصر المحافظ يعقوب الصراف، بعد «التعاقد» مع مجلس الوزراء، على إدراج هذا المكان تحت خانة «الإنشاءات» المؤقتة، على أن تزال عند أول طلب للإدارة (المحافظة). لكن القمة الفرنكوفونية تأخرت عامين، إذ نظمت عام 2002. خلال هذه الفترة الفاصلة، أقيمت جدران «مؤقتة» للخيم. وبعدما عقدت القمة الفرنكوفونية صارت إعادة العقار إلى ما كان عليه أمراً صعباً. أضف إلى ذلك، تغيّر المحافظ، وبدا تقطيع الوقت على الطريقة اللبنانية.
سُقف البيال، وصارت الخيم غرفاً. وفي كل مرة، يضاف حائط ثم سقف.. ثم مطعم ثم قاعة مؤتمرات ثم صالة.. ثم صار البيال على هذا الشكل. لكن، ثمة سؤال ملحّ يتعدى أمر الخيم «المستعارة» من البيروت هول على أساس قمّة «وبتروح»، وهو: كيف بنيت الجدران والمنشآت الأخرى تحت سقف البيال؟ على أية اعتبارات؟ على اعتبار أنها إنشاءات مؤقتة؟ وكيف ينسحب عليها قرار المؤقت، إن كانت قد أتت بعده بسنوات، وبعد الشرط الذي ينصّ على إلغائها بعد انتهاء القمة الفرنكوفونية؟
لكن، من يسأل هنا. صار البيال منشأة بعد عشرة أعوام. وصار المؤقت مخالفة دائمة، بعدما تمّ العمل على التسوية القانونية، بطريقة مخالفة. هنا، تجدر العودة إلى الوراء سنوات كثيرة، وتحديداً إلى المرسوم رقم 5665 في 21 أيلول 1994، الذي صدّق بموجبه الاتفاق المعقود بين مجلس الإنماء والإعمار وسوليدير المتعلق بتمويل وتنفيذ أشغال البنى التحتية بمنطقة الوسط وأعمال ردم البحر وأقسام الأراضي المستحدثة الناتجة عن هذا الردم. وهذا الإتفاق ينصّ بطبيعة الحال على تسوية سوليدير للبنى التحتية مقابل الحصول على آلاف الأمتار من الردميات المخالفة هي أيضاً وشرعنتها.
هكذا، كان البيال على تلك الردمية التي لم تكن قد سوّيت بعد، والتي لا يمكن تسويتها تالياً، لأنه يفترض أن يجري الفرز والشرعنة بعد الانتهاء من العمل. وهنا، لم يكن «يفترض بالدولة أن تتسلم أملاكها وتعطي سندات لأن المقاول لم ينه عمله أصلاً»، يقول أحد المتابعين لما حصل في حينها. أضف إلى ذلك أنه بحسب المرسوم الأساسي للبنى التحتية في سوليدير، فقد كانت التكلفة مبالغاً فيها إذ وصلت إلى حدود نصف مليار دولار، منها بيروت القديمة التي كلفت 100 مليون دولار و300 مليون دولار حماية بحرية و100 مليون «تظبيطات»، ولم تكن معقولة. وهنا، كانت المخالفة التالية.
ر. ح.

سوق السمك صار في بيروت: عمري 16 سنة
 الخيام | khiyam.com
الخيام | khiyam.com 




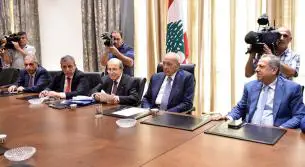






تعليقات: