
أحيطك علماً يا قارئي أن عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في العراق يزيد عن عدد الاميركيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى الذين قتلوا يوم الحادي عشر من ايلول عام 2001 في مركز التجارة العالمي في نيويورك، وفي البنتاغون، وفي بنسلفانيا على متن طائرة الرحلة 93. كما أن نقطة العلام الإنسانية المريبة هذه لا تداني ولو باليسير مقدار خسارة الأرواح البشرية الأخرى التي نتجت عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق تحت وهم أنها ستجعل العالم مكاناً أكثر أمناً "لمحبي الحرية" على حد تعبير الرئيس جورج بوش. صار صعباً الآن على أكثر الأميركيين وطنية أن يستمر في المضي داخل هذه الصحراء من الأضاليل الآتية من البيت الأبيض حول ما يسمى الحرب على الإرهاب التي جاءت سيئة التخطيط والتنفيذ.
قمت أخيراً بزيارة إلى الولايات المتحدة، موطني الأصلي، وفي المطار حصلت على نسخة من جريدة "الولايات المتحدة اليوم". هذه الجريدة، كغيرها، تقدم نشرة يومية عن الجنود الاميركيين الذين قضوا في العراق، وغالباً ما تنشر صورة الجندي القتيل. وفي هذا اليوم، وأمام كشك الصحف اليومية في المطار، وقفت وجهاً لوجه أمام الجندي القتيل الذي كان يرمقني من على الصفحة الأولى. العراق كانت حربه التي مضى على أساسها في خدمة وطنه، أما أنا فسبق أن كانت فيتنام. كلانا ذهب "يحارب من أجل الحرية" تحت غمامة الأكاذيب التي حبكتها حكومتنا. أعلم الآن أن حكومتنا كذبت علينا، أما الجندي القتيل، الذي وجهي في وجهه، لن يعرف أبداً.
كان عمره 22 عاماً. وكان عمري 20 عاماً حين جندوني وأرسلوني إلى فيتنام. حربي انتهت منذ 38 عاماً، عشت بعدها ما يكفي لاكتشاف الأكاذيب التي حيكت عن تلك الحرب. اليوم أرى الناس يذهبون إلى فيتنام للعطلة، وكأن شيئاً لم يكن. أما أنا فلا أرى فيها سوى مقبرة.
لو عاش الجندي الشاب، الذي وجهي في وجهه، 38 سنة بعد انتهاء حربه، لابد أن يكتشف كل الأكاذيب التي صدرت عن رجل يتباهى وكأن الرب مسدس سداسي الطلقات على جنبه. لكنه مات، ومهما يرى الآن، لن يرى الأكاذيب التي أدت إلى موته. ولن يرى يوماً يذهب الناس فيه للعطلة في المكان الذي صار مقبرته، وكأن شيئاً لم يكن.
لو استطعت، ماذا أقول للجندي الميت الذي يلبس وجهه وجهي؟
حسناً، سأقول له إنني غادرت بلد ولادتي بعد عودتي من الحرب. وسبق لي أن خلفت ورائي عديداً من القتلى في فيتنام، أعمارهم مثل عمرك. لثمت ثغر الخوف وتقيأت، ولاشك عندي أن هذا ما حصل لك. لم أمت مثلك، لكن شيئاً ما مات بداخلي. ما عدت أتجول كالشبح، مع أنني فعلت ذلك كل يوم وعلى مدى سنين عديدة بعد عودتي إلى ما كنا نسميه "العالم" (كما كنا نقول في فيتنام عن الولايات المتحدة). شعرت أنني طعنت في الظهر جراء هجمة الأكاذيب التي استغلت حياتي، لكنني صممت أن لا تكون بقيتي الباقية من نصيب الدولة التي ولدت فيها. لا أعلم كيف كنت ستسير بعد 38 سنة لو لم تمت، لكنني آمل أنك كنت ستجد مثلي هذه الكلمات لجيمس بالدوين: "يجب ألا نسمح لصانعي الدمار أن يكونوا أبرياء أيضاً." حريتي بدأت من هذه الكلمات.
لو استطعت، ماذا أقول للجندي الميت الذي يلبس وجهه وجهي؟
حسناً، سأقول إنك مذ فقدت حياتك، حين سألوا الرجل الذي أرسلك إلى حربه أن يلقي الضوء على جانب هام من جوانب فترته الرئاسية، أجاب أنه ذهب للصيد وعاد بسمكة كبيرة. مهما يكن السبب وراء هذا الجواب، حتماً لم يكن الاهتمام بحياتك. والآن زال اللحم عن عظامك؛ ولسوف يعود الرجل الذي أرسلك إلى الحرب إلى مزرعته في كروفورد، تكساس ولاشك أنه سيعكف فوراً على التخطيط لبقعة جيدة أخرى يمارس فيها صيده. لكنني أتذكر كلمات ريتشارد سيلزر: "أن تمعن النظر في العظام، فإنما تتأمل مصير الإنسان. العظام تذكار الأرض، فهي كل ما يتبقى من الإنسان بعد أن تذوب أجزاؤه الأخرى وتتفتت وتتسرب في أديم الأرض". عظامك لازالت فتية وستبقى شاهدة على الأكاذيب.
لو استطعت، ماذا أقول للجندي الميت الذي يلبس وجهه وجهي؟
حسناً، سأقول إننا ما كان يجب أن نسمح للسياسيين المجانين أن يغتصبوا حياتك القصيرة بتلك الطريقة. إن كان ثمة "محور للشر"، فلا شك أنه يعيش داخل قلوب الكهول الذين يرسلون الشباب ليموتوا في حمى البحث عن العظمة الدولية وفي أتون الجشع. لايمكن تصحيح هذا الوضع بمجرد تغطية تابوتك بعلم البلاد.
لو استطعت، ماذا أقول للجندي الميت الذي يلبس وجهه وجهي؟
----------------
جلسة مع لويس سكوت
لويس سكوت كاتب وشاعر أميركي من أصل إفريقي، سبق له الإقامة في أوستراليا بضع سنوات قبل استقراره الأخير في نيوزيلندا. لكنه دائم التجوال، يمضي ستة أشهر في نيوزيلندا ويمضي باقي السنة بين دول العالم خصوصاً الولايات المتحدة وأفريقيا، يجمع بين حضور المؤتمرات والندوات الأدبية والمشاركة فيها، وبين تجارة التذكارات فيتبضع ما يستطيع لتزويد متجره في نيوزيلندا بالتحف الإفريقية.
يزورنا كلما حضر إلى سيدني، والتقيت به مؤخراً خلال غداء في قلب المدينة استحضرنا فيه علاقتنا القلمية يوم كان مستشاراً ومن أبرز كتّاب "كلمات" المجلة التي كنت أصدرها.
تناولت أحاديثنا موضوعات شتى، لكنها صبت جميعها في لجين واسع من الشعور بالظلم السياسي والاجتماعي الذي يسود العالم ومسؤولية صانعي القرار عن ذلك، ونفاقهم سواء أكانوا من يدير دفة هذه الكوارث متستراً بقوة وتقدم الولايات المتحدة، أم من يخضع لإرادتهم من حكام العالم الثالث الذي لا يجد غضاضة في بيع شعوبه لأجل البقاء في الحكم. شعرنا مثلاً اننا لانريد الوضع الحالي في العراق، وما كنا نريده كما كان، لكن لابد أن هنالك طريقة أخرى يمكن اعتمادها، لا تتكل على الاحتلال أو الاستبداد. هذه الطريقة التي تترك للشعب تأسيس وطنه وفقاً لأساليب العدالة والحرية والمساواة تحتاج إلى ديموقراطية تتأصل في ثقافة الأمة، وهي ما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها، ومع الأسف الشديد أبناء الوطن أنفسهم القضاء عليه بالرجوع إلى صيغة توافقية عرقية طائفية.
تميزت مواقف لويس سكوت عبر السنين بمعدنها المصقول من الكرامة والإباء، يعبر عنها دائماً في شعره وكتاباته. طرح مسألة العنصرية في الولايات المتحدة واستعرض مأساة المضطهدين السود فيها، وتعداها إلى السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم، على غرار ما فعل في مجموعته "ألوان أرضية" حيث يمكننا أيضاً تلمس مرارته الشخصية في نصوصه التي وصفت الشارع الذي كان يعيش فيه وحيث تشارك السود واللاتينيون بتلقي قذائف تمييز البيض ضدهم. وتناول في المجموعة نفسها تجربته في حرب فيتنام ومقته الشديد لها، ووصف ذلك بتهكم شديد، وبفلسفة إنسانية عميقة.
وهكذا كان من الطبيعي لشخص مثلي يعاني مثل كل العرب من تداعيات هزيمة 1967، وأحداث الحاضر في فلسطين والعراق أن يهتم ويستجيب لمعاناة لويس سكوت، وأن يشترك معه في حوار فكري إنساني لا ينتهي.
من أهم مميزات لويس سكوت، حسبما كنت أستحضر وأنا أستمع إليه، أنه على الرغم من توظيفه وسائله القلمية في التعبير عن تلك الحالات الإنسانية، فإنه يحافظ على إبداعه الأدبي ما يبعده عن أن يكون "ملتزماً" بالمعنى التقليدي. بعبارة أخرى، ليس الالتزام بحد ذاته، ولا الإبداع وحده غاية لويس سكوت. ربما لا يفكر بأية غاية محددة، بل يعبر عن إنسانيته مستخدماً تلك الوسيلة الراقية التي يحسن استخدامها. ربما أناقش معه هذه الفكرة في لقاء آخر.
أهداني نسخة من مجموعته الشعرية الأخيرة "الكلام بأكثر من لسان" التي لفت نظري أنه اختتمها بمقالة بعنوان "جندي أميركي" تعزز مواقفه السابقة وتدل على أنه يواصل تجربته الإنسانية بطريقة متكاملة لا يعدم فيها الإنسان الشاعر ولا الشاعر الإنسان. يشرفني أن أقدم هنا ترجمتي لها:
رغيد النحاس - سيدني
 الخيام | khiyam.com
الخيام | khiyam.com 




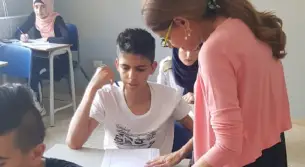
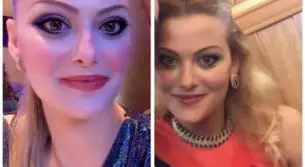





تعليقات: