
مشهد من شريط «كيف صوّر ستانلي كيوبريك «أبوللو 11»»
بعد خمسين عاماً على خطوة نيل أرمسترونغ الأولى على سطح القمر، لم يعد كثيرون يصدّقون السردية الأميركية الرسمية عن مشروع «أبوللو 11». ليس ذلك فقط لتعمّق موقف أصحاب نظريّة المؤامرة، بل أيضاً بسبب انهيار مصداقيّة النخبة الأميركيّة بعد فضائحها الكثيرة منذ 1969 على نحو لا يشجّع الناس العاديين على قبول مزاعمها بسهولة. لكن قراءة هادئة للمرحلة في السياق التاريخي والعلمي الكلي، تظهر أن دوافع المشروع المكُلف لم تكن سوى مزيد من الانخراط في سباق التسلح المميت سعياً لتمديد هيمنة الإمبراطورية الأميركية على العالم
في عشرين تموز (يوليو) عام 1969 تسمّر أكثر من 600 مليون من البشر أمام شاشات التلفزيون حول العالم ليشاهدوا في بث حيّ ومباشر الأميركي نيل أرمسترونغ في بدلته الفضائيّة البيضاء المزين كتفها بعلم الولايات المتحدة وهو يخطو على سطح القمر. قال لهم من هناك: «هذه الخطوة الصغيرة لي كإنسان هي قفزة هائلة للإنسانيّة جمعاء». وبالفعل، مثّلت تلك الخطوة لكثيرين نقلة نوعية في طريقة نظرهم إلى العالم: فها هو القمر الذي رافقنا من عليائه منذ بدء الحياة الإنسانية قد أصبح موطئ قدم، وها هو كوكبنا الذي كان بمثابة كل شيء لنا كبشر مرئياً من القمر ليس أكثر من جرم فضائي صغير سابح في بحر من عدم لا نهائي. لقد كانت لحظة مذهلة بكل المقاييس.
القراءة الهادئة للحدث اليوم في ذكراه الخمسينيّة ــ وبينما تقترب الرحلة الشهيرة من مغادرة عالمنا لتدخل التاريخ بعدما غيّب الموت ثمانية من أعضاء فريق «أبوللو11» ويقترب حثيثاً من الباقين ـــ ينبغي لها أن تسمح لنا بوضع الأمور في سياقها التاريخي والعلمي المحض، وإزاحة أكوام البروباغندا السّاذجة التي راكمتها الإمبراطوريّة الأميركيّة خلال مرحلة الحرب الباردة، وصوّرت الأمر بوصفه انتصاراً للعقل الأميركي، ونقلة متقدّمة في دنيا الاختراعات العلميّة والاكتشافات الإنسانيّة الممكنة في ظل المشروع الرأسمالي المعولم (رغم أن كلفة المشروع بالكامل أنفقت من الضرائب التي يدفعها المواطنون).
بالعودة إلى السياق التاريخي، فإن المشروع الذي قُدّم للمشاهدين بوصفه منتجاً علمياً إنسانياً مدني الطابع، كان في الواقع جزءاً لا يتجزّأ من المجهود الحربي الأميركي في إطار الحرب الباردة التي اندلعت عقب تواجه الدبابات السوفياتية والأميركية بين شطرَي برلين لدى انتهاء الحرب العالميّة الثانية (1945)، واستكمالاً لانخراطٍ محمومٍ للإمبراطورية في سباق تسلّح هائل مع المنظومة الشيوعية التي كانت صدمت العالم بتفوقها في تكنولوجيّات الفضاء، لا سيّما بعدما أرسلت في عام 1957 العالم السوفياتي يوري غاغارين خارج قبضة الجاذبيّة الأرضية، ليصبح أول إنسان يحلّق في الفضاء.
قبل اللحظة الغاغارينيّة، كان الأميركيون على ثقة تامة بأن قدراتهم التقنيّة متفوقة بما لا يقاس مقارنة بالدولة السوفياتية الزراعية الطابع والمنهكة بعد الخسائر الضخمة في الأرواح والمعدات أثناء المواجهة الدموية القاسية مع ألمانيا النازية، بينما اكتفى الأميركيون حينها بالمشاركة في المراحل الأخيرة من الحرب ـ على جبهة أوروبا ـ بعدما أنهكت كل الأطراف، وكجزء من تحالف عريض من دون أيّ مساس بالبنية التحتيّة للبلاد البعيدة عن مسرح العمليات. كانوا كذلك قد أسقطوا لتوهم قنابلهم النووية على هيروشيما وناغازاكي في حركة استعراضيّة محضة، رغم أن اليابان حينها كانت على وشك الاستسلام ومسألة سقوطها العسكري في يد القوات السوفياتيّة لن تتعدى أياماً معدودات. لكنّ سر ثقتهم الحقيقي كان نتاج المشروع السري الذي سُمّي حينها بـ «مشبك الورق» (Paper Clip) وتمّ في إطاره نقل أكثر من 1600 ضابط نازي من نخبة العاملين في برامج التسليح الألمانية المتقدّمة بما فيها الطاقة النووية، وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية الاستراتيجية والطيران وبدايات الأقمار الاصطناعية إلى الولايات المتحدّة وإلحاقهم بالجيش الأميركي. ثم جاءت الصفعة الغاغارينيّة، وقبلها بقليل كان السوفييت أيضاً قد سبقوهم إلى إطلاق «سبوتنيك -1» كأول قمر اصطناعي في مدار الأرض.
قرّرت النخبة الأميركية الحاكمة أن شرعيتها المحليّة والعالميّة قد اهتزت، وأنه لا بدّ للحفاظ على هيمنتها من كسب سباق التسلّح في نسخته الفضائيّة تحديداً مهما كان الثمن. وقتها نُقل عن ليندون جونسون قوله: «لا أتقبّل فكرة النوم بينما يطلّ عليّ قمر شيوعيّ». لقد كانت نخبة مرتعبة من فقدان كلّ شيء لمصلحة المارد السوفياتيّ الصاعد. وهكذا أنشأ الأميركيون وكالتهم القوميّة للأبحاث الفضائيّة (ناسا) في 1958 كواجهة علميّة للأبحاث العسكرية السريّة بشأن الفضاء. وتولت ناسا إطلاق سلسلة مشاريع «أبوللو» لارتياد الفضاء بداية من عام 1961 (استمرت لغاية 1972).
أصبح كتاب «لم نذهب مطلقاً إلى القمر» مصدر إلهامٍ لتيار عريض من النقّاد داخل الولايات المتحدة
النخبة الأميركية التي كانت نتيجة التفوّق الفضائي السوفياتي الظاهر وتململ قطاعات متزايدة من المواطنين من تورط بلادهم في حرب دموية طويلة في فيتنام (بدءاً من 1955) وجدت نفسها بحاجة ماسة إلى إيجاد صيغة ما لاستعادة ثقة المواطنين والحلفاء في العالم الرأسماليّ «الحر». ودفعت الضغوط المتراكمة الرئيس جون ف. كينيدي إلى إلقاء خطابه المشهور عام 1961 حيث تعهّد علناً بإرسال إنسان إلى القمر قبل انصرام العقد.
صرفت السلطات الأميركية أكثر من ثلاثين ملياراً من الدولارات ـ بسعر الستينات طبعاً ـ على مشروع «أبوللو»، وكرّست له خدمات أكثر من 400 ألف شخص أي ثلاثة أضعاف ما خصصته لمشروع مانهاتن الذي أنتج القنبلة النووية الأولى. كانت تلك الاستثمارات ـ إضافة إلى التكاليف الباهظة للحرب العبثيّة في فيتنام التي تكبدتها الميزانيّة العامة ـ قادرة في مجموعها على توفير العلاج الطبي والتعليم المدرسي والجامعي والنقل داخل المدن مجاناً لكل أميركي. لكن أولويات النخبة كانت في مكان آخر تماماً.
منيت «أبوللو – 1» الرحلة التجريبيّة الأولى لوضع ملاحين في مدار القمر عام 1967 بفشل ذريع، فانتهت إلى مقتل أفراد الطاقم الثلاثة، وتأكد لدى الناسا أنّ إجراءات السلامة لديها لم تكن قد طُوّرت بعد إلى المستوى الكافي. لكن النخبة الأميركية التي مستها البارانويا وباتت تخشى من إهانة سوفياتيّة جديدة إذا أعلنت موسكو عن نجاحها في هبوط ملاحيها على القمر قبلها، أصرّت على تحقيق وعد كينيدي بأي طريقة. في تلك اللحظة تماماً، ولدت رواية بديلة عن موضوعة الهبوط على القمر بداية على يد وليام كايسينغ أحد أهم خبراء صناعة محرّكات الصواريخ الأميركيين ولاحقاً عدّة علماء بارزين آخرين. كايسينغ كان متأكداً بأن الولايات المتحدة لم تمتلك حينها التكنولوجيا اللازمة لإرسال ملاحين إلى القمر ومن ثم استعادتهم، وأن النخبة الأميركية قررت نتيجة ذلك شراء الوقت للناسا لإجراء مزيد من التجارب من خلال الإعلان عن الوصول إلى القمر عبر بث مشاهد فيلميّة تنتج على الأرض. فإذا كان السوفييت ملوك الفضاء، فنحن ــ الأميركيين ـ أرباب السينما. كايسينغ الذي وضع ملاحظاته على «الفيلم الأميركي» في كتاب طبعه على حسابه الخاص بعدما رفضت دور النشر الكبيرة قبوله وقتها بحجة أنه أوهام نظريّة مؤامرة سوفياتيّة تستهدف معنويات الأميركيين. ومع ذلك، فإن كتاب «لم نذهب مطلقاً إلى القمر: خدعة الـ 30 ملياراً الأميركيّة»، أصبح مصدر إلهامٍ لتيار عريض من النقّاد داخل الولايات المتحدة ـــ أساساً ـــ نبش كل الصور والأفلام والوثائق التي نشرتها ناسا سعياً لإثبات المؤامرة التي نفذتها السلطات وكشف تفاصيل عدّة تظهر أن البث التلفزيوني من القمر لم يكن بالفعل سوى مشاهد صورت بسريّة تامة في استديو تصوير أقيم لتلك الغاية تحديداً في مكان في الصحراء. وأظهر آخرون وثائق تظهر تلاعب ناسا بالصّور الفضائيّة قبل ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الهبوط المزعوم (رالف ريني في كتابه «الناسا التي خدعت أميركا: كيف لم نذهب مطلقاً إلى القمر ولماذا»)، بينما لم تساعد بلاهة الملاحين الـ 12 الذين يفترض بهم أنهم قاموا بالرحلة الأولى «أبوللو 11» ــ والرحلات الخمس اللاحقة ـ عند إجابتهم على أسئلة المشككين في تهدئة الخواطر. ورغم كل الجهود الاستثنائية التي بذلتها ماكينة الدعاية الأميركية الهائلة لتدعيم السردية الرسمية، فإن 52% من البريطانيين مثلاً يعتقدون بصحة ادعاءات كايسينغ ورفاقه، بل يؤمن كثيرون بأن ستانلي كوبريك مخرج فيلم «2001: أوديسة الفضاء» هو ذاته مخرج فيلم الناسا للهبوط على القمر.
المشروع كان جزءاً من المجهود الحربي الأميركي في إطار الحرب الباردة
بالطبع يحبّ كثيرون نظريات المؤامرة، ويمتعهم اكتشاف الأسرار والخدع المرتبطة بها وتمنحهم قدرة نقدية على التعاطي مع الوقائع ولا عيب في ذلك بالطبع، ولعل كايسينغ ورفاقه مجرّد موهومين، لكن الفضائح المتكررة التي كشفت عن طرائق عمل السلطات الأميركيّة بداية من «ووترغيتس» وانتهاء بـ «ويكيليكس» وسنودن، مروراً بالتآمر على الأقلية السوداء وتورط المخابرات الأميركية في الانقلابات العسكريّة وإسقاط الأنظمة وإدارتها لصناعة المخدرات العالميّة، لم تترك للناس العاديين هامشاً كبيراً لتصديق الروايات الرسميّة الأميركيّة.
لكن حتى لو هبط الأميركيون بالفعل على القمر، فهل كانت تلك المهمّة تستحق كل تلك الجهود والتكاليف الفلكيّة؟ لقد أرسلت آخر مهمة إلى القمر عام 1972، وأغلق برنامج «أبوللو» كليّة في 1975 «نظراً إلى تراجع الاهتمام العام» وفق بيان ناسا في هذا الشأن، وتبيّن للجميع بأن كل تلك الهمروجة كانت مجرد مناورة أخرى لتسجيل النقاط في حروب الهيمنة.
بالتأكيد، فإن فريقاً من العقول البشريّة المبدعة قادر عند توفر الإرادة والموارد على تحقيق أعظم الإنجازات العلميّة. لكن المأساة أن النخبة التي تنفرد بإدارة شؤون الإمبراطوريّة ليست معنيّة إطلاقاً بالتقدّم الإنساني الشامل وهي توّظف تلك القدرات البشريّة دائماً لغايات مؤدلجة تتعلق بتكريس هيمنتها العسكريّة والماديّة على بقيّة سكان الكوكب. اسألوا وليام كايسينغ.

 الخيام | khiyam.com
الخيام | khiyam.com 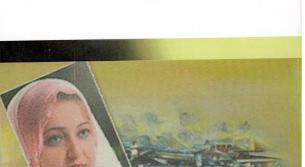











تعليقات: