
من مسيرة الأمهات في عيد الأم (نبيل اسماعيل)
لحظاتُ عناقٍ أخيرة تحاول إطالتها الأمُّ عندَ وداعِ ابنِها أو ابنتها في المطار. تحتبسُ الدموعَ لتعود وتذرفها لاحقاً في الخفاء. تشتمُّ رائحةَ طفلها للمرّة الأخيرة. تشدُّ على كيانٍ من جسدٍ وروحٍ وُلِدَ من أحشائِها بالألم وكبر بالشقاء فتتمنّى ألّا يفلتَ منها إلى الأبد. وما أكثر لحظات الوداع الأخيرة التي تختبرها الأمّهات في لبنان قبل أن يتوارى عن نظرها، جارّاً حقيبة سفره، ذاكَ الطفل الذي أنشأته على الإيمان وحبّ الحياة والوطن. عملت على تغذيته بالعلم والثقافة. هَمست في أذنيه أعذب الأغاني والحِكَم، وكَدَحَت يوميّاً في سبيل تربيتِهِ أفضل تربية حتى صار الإنسان الذي هو عليه. أحياناً، جاهدت إلى جانب زوجها وأحياناً اضطرّت إلى الكفاح لإعالته بمفردها في دولة، مهما جدَّ فيها المواطن، لا يحصد سوى النكبات والعذابات والخيبات والألم.
"دُنيا" وهذا اسمها المستعار لأنَّ الدنيا أمّ، في العقد السادسِ من العمر، تُقَلِّبُ أَلبومَ الصور، تحاول إخفاء دموعها التي تخذلها فتنزلق قطراتٍ قطرات كلؤلؤات الندى من عينيها المتعبتين فتتهادى على خدّين أنهكتهما صعوبة الحياة في لبنان... تقول بالعاميّة وهي تمسحهما متعثّرة: "سامحيني يا بنتي، الوجع غَلبني".
يعمُّ الصمت غرفة الجلوس في شقّة عائلة صغيرة من الطبقة الوسطى. على الطاولات إطارات صور تَخَرُّج وصور عائلية وشهادات. تدلّ عليها السيدة وتروي قصّتها بهدوء محاولة امتصاص انفعالها. لكنّ تعابير وجهها وحركة يديها كافية لتعكس شدّة الوجع: "هُدِرَ شبابي في الملاجئ في ظلّ الحرب في لبنان". تكشف عن علامة على جسدها: "أصبت في منزلي وخضت عملية جراحية. لازمت الفراش في الملجأ أشهر عديدة. المرّة الأخيرة التي تحدّثت فيها عن الحادثة كانت لزوجي منذ سنوات". تبرّر موقفها: "تفاديتُ إخبار أولادي عن الأيام السوداء التي عرفتها. أردت أن أربّيهم على السلام وعلى تقبّل الآخر وفرح الحياة".
بين ذكريات الحرب التي أخفتها لعقود من الزمن وواقع عائلتها اليوم، تتابع دُنيا سردها مشدّدة على الجهود التي بذلتها تحت القصف كي تنال شهادتها الجامعية. "في أحلك الليالي، كان أهلي يدفعون بي للسير قدماً ولتحقيق ذاتي، مؤمنين أنّ لا بدّ من نقطة ضوء بعد النفق المظلم. لم أتخصّص في المجال الذي أحبّ لكنّني نلت شهادة جامعية".
في بداية التسعينات، التَقَت شريك حياتها وقرّرا معاً تأسيس عائلة جميلة وطيّ صفحة الماضي المؤلم والتعالي على الجراح. "تمسّكنا زوجي وأنا بالوظائف المتاحة. عملنا دون كلل كي نتدبّر أمور الأولاد. أدخلناهم المدرسة، سهرنا على نجاحهم. أتقنوا ثلاث لغات. طفولتهم كانت هادئة، الحمد لله".
ثمّ تسحب صورة عمرها 29 سنة، أي منذ ولادة ابنها البكر في يومه الأول في المستشفى. تبتسم وتغُصُّ: "عندما عرفتُ أنني حامل للمرة الأولى، طرتُ من الفرح. حلمت يومياً بطفلي، بمستقبله الزاهر. تخايلتُ صوته وضحكته قبل ولادته. صلّيت ألّا يعرف ابني العذاب والخوف نفسه الذي اختبرته في الحرب".
تتأسّف على الخيبات التي مرّ بها في شبابه: "خلوق، مهذّب، مارس الرياضة والأعمال الاجتماعية لمساعدة المحتاجين والعطاء دون مقابل. دخل الجامعة، تخرّج منها بعلامات مميّزة. بحث كثيراً عن عمل. قُبِلَ لفترة في وظيفة ضمن مجاله. لكنّ عمله اعتُبِرَ بمثابة تدريب فقط. قَبِلَ تقاضي ما دون الحد الأدنى للأجور معزّياً نفسه بأنّ هذه الخبرة تطوّر سيرته الذاتية. رفض فكرة الهجرة معلّلاً "ماتوا وعاشوا أهلنا تَعَلَّمونا. مِن حقُّن يفرَحوا فينا. وصار دورنا نِخدِمُن".
تستطرد: "شابٌ طموحٌ، مفعمٌ بالحياة، عانى من عدم الاكتراث لحالته ولحالة الشباب في بلده حتى شعر أن لا قيمة لحياته ولمستقبله في لبنان. مرّ بفترة اكتئاب. شكّك بذاته، لامَ نفسه. لكنّه في سنّ الـ26 انتفض على الواقع. فَهِمَ أنّ السلطة السياسية مصدر المشاكل. كان يحزن كُلّما عرف بأن أحد رفاقه الذين لا يتمتّعون بالكفاءة، تَبَوَّأوا بفضل المحسوبيات والزبائنية مناصب بأفضل المعاشات وهم غير جديرين بتحمّل المسؤوليات المُناطة بهم".
تسكتُ دُنيا من جديد. تحفُّ جبينها. ثمّ تخبر أنّ ابنها قرّر بعد أشهر عديدة من النضال أن يهاجر. حتى اللحظة الأخيرة حاول إعادة حساباته والبقاء إلى جانب عائلته ورفاق عمره. غالباً ما ردّد لوالدته: "كيف فيني اتركِك وفِلّ يا إمّي؟ كيف فيني إكسِرلِك ضهرِك بعد كلّ اللي عمِلتيه معي؟."
تُفصحُ عن الألم الذي اختبرته. "لم أستطع أن أقول له بحزم: ارحل، لأنني كنت أتمزّق من الداخل؛ وبالمقابل لم أسمح لنفسي أن أقف عائقاً أمام مستقبلِهِ. لم أنجبهُ إلى الحياة كي يتعذّب ويُذَلّ في بلده. الحياة أمامهُ".
تستكمل: "قدّم ملفّه إلى إحدى الجامعات. قُبل للالتحاق بماجيستير. أواخر آب 2017 رافقتُه إلى المطار. مسّدتُ شعره. قلتُ له كلمات صغيرة رقيقة. أعطيته جرعة معنويات. وحين استدار رافقته بنظري حتى اختفى. جلست في الكافيتيريا. أقلّب الهاتف والساعة. أراسلهُ. يُراسلني حتى أقلَعَت الطائرة. حين عدتُ إلى البيت، أقفلتُ باب غرفتي وأجهشتُ بالبكاء".
بقيَت دُنيا قويّة أمام نجلها وأمام ابنتيها اللتين تصغراه سناً فيما كانت روحها منهارة. تلك اللحظة كانت بمثابة كابوس.
مع الوقت تقبّلت دُنيا الوضع: "ابني صار رجلاً مستقلاً. أراه مرّة في السنة. عمل في مقاهٍ صغيرة كي يسدّد إيجار غرفته، ويتابع دراسته. لو بقي هنا، لنَهشَت حياته التعاسة وظلّ دون أمل بالغد".
دُنيا مطمئنة نوعاً ما إلى مستقبل ابنها إلا أنها تخاف كثيراً في ظلّ الانهيار، على ابنتيها العاطلتين عن العمل. لا تخفي أن إحدى الشابتين تفكرّ بالهجرة لكنها لم تحسم خيارها بعد، فيما الثانية ترفض المسألة تماماً وتسأل: "لمن نترك البلد؟ للمجرمين؟ لا ليسوا خالدين، المستقبل لنا!".
تدخل دُنيا غرفة نوم ابنها، تجلس على سريره. الغرفة مرتّبة، نظيفة، كل شيء موضّبٌ في مكانه: الألعاب، الكتب، ميداليات أحرزها. تعتني الأمّ بهذه الغرفة يومياً وكأن ابنها لم يغب. ثم تنفجر غاضبة: "دموعي ليست أغلى من دموع أمهات شهداء المرفأ. الله يحرق قلوب أمّهات أرباب السلطة ومن يعاونهم كما تحترق قلوبنا على تدمير عائلاتنا".
تضيف: "غادر ابني إلى دولة سلطتها السياسية تصون الكرامة البشريّة لا تقتلُ الإنسان، لا تذلّهُ، لا تجوّعهُ، كما في مجتمعنا. هنا الحكام يحدّون من طاقات الشباب، من مواهبِهِم وهي عطيّة من الله. سلُطاتنا تخنق الإنسان".
تقف دُنيا. تفتحُ الدُّرج. تسحبُ قطعة ثياب صغيرة خضراء. تغمرها: "في هذا القميص رائحة ابني. من يعيده
 الخيام | khiyam.com
الخيام | khiyam.com 




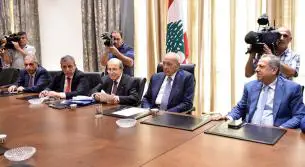






تعليقات: