
عبثاً يحاول المعنيون في ضاحية بيروت الجنوبية وسكانها فكّ طلاسم أسباب زحمة السير فيها. كل التفسيرات المكانية والزمانية والمناخية خابَت، كساعات الذروة المرتبطة ببدء دوامَي العمل والمدارس وانتهائهما، أو بتساقط الأمطار، أو بقرب موعد الإفطار في شهر رمضان، أو بموسم الأعياد... أو بكل هذه الأسباب معاً كما هي الحال هذه الأيام. الاختناق المروري، لسكان الضاحية، صار «قدَراً» في كل شوارعها وفي مختلف الأوقات، لا تغيّره «خطة سير» ولا ضائقة مالية ولا أزمة محروقات. ورغم غياب الأرقام الدقيقة، يمكن «رؤية» الأزمة بوضوح في طوابير السيارات المتحركة ببطء، وسط فوضى عارمة يتسبّب بها العدد الكبير من السيارات و«جيش» الدراجات النارية التي لا تخضع لقانون سير وركن السيارات عشوائياً على جوانب الطرق واستباحة «الإكسبرسات» والمحال التجارية للأرصفة.
بعد أربع سنوات على إطلاق اتحاد بلديات الضاحية «خطة سير» بقيت الأزمة «مكانك راوح». يعيد الباحث في مجال النقل علي الزين فشل الخطة إلى «الترقيع في قطاع نقل بري مهشّم يعتمد كلياً على السيارات، إذ يصل استخدام السيارات في لبنان إلى 350 سيارة لكل 1000 مقيم، وهي نسبة تتجاوز نسبة استخدام السيارات في مصر، مثلاً، حيث تصل إلى 100 سيارة لكل 1000 مقيم». ويلفت الزين إلى أنّ «كلّ خطط السير التي تقوم على تحسين البنى التحتية وتوسيع الطرقات لتسهّل حركة العدد الكبير من السيارات يجب أن تلحظ المفعول العكسي للخطة، وهو ازدياد زحمات السير بدلاً من تراجعها بعد فترة وجيزة، لأن هذه الخطط تشجع، في نهاية المطاف، على التنقل بالسيارة». ويشدد على أن الخطأ في خطة السير في الضاحية هو «عدم معالجة أصل المشكلة المتمثل في غياب النقل العام والمشترك المنظّم». والنتيجة، بحسب مهندس النقل رامي سمعان، أن «السيارات تُستخدم في أكثر من 80% من التنقلات، مقابل أقل من 20% فقط بواسطة النقل العام والمشترك». ويلفت إلى سبب آخر لفشل خطة السير في الضاحية، وهو «عدم اتساع حدود قياس الزحمة إلى المناطق المجاورة، وما يتطلبه ذلك من تشبيك مع البلديات المجاورة مثل بلدية الشويفات جنوباً وبيروت شمالاً، خصوصاً أن خطوط النقل متشابكة بين هذه المناطق. فالفان رقم 4، مثلاً، ينطلق من الضاحية (الليلكي) ويصل إلى الحمرا، ويحتاج تنظيمه إلى خطة أوسع من رقعة الضاحية».
مع رفع الدعم عن المحروقات، كبرت التوقعات بتخلي كثيرين عن استخدام سياراتهم الخاصة وحتى ترك وظائفهم لمصلحة وظائف قريبة من أماكن سكنهم، وكانت هذه، وفق سمعان، «فرصة للتحول إلى النقل العام والمشترك وإلى النقل السلس (المشي والدراجات الهوائية). غير أن هذه الفرصة فُوّتت، فلم تستثمر الحكومة في النقل العام ولم تشجّع السلطات المحلية على النقل السلس عبر إزالة التجاوزات عن الأرصفة لتسهيل المشي كأضعف الإيمان. عوضاً عن ذلك أنتجت الأزمة التوك توك، وانفلاش ظاهرة الدراجات النارية كوسائل نقل توفيرية لا توفر السلامة المرورية». وأضاف: «بهذه الطريقة تكيّف اللبنانيون مع أزمة النقل من دون تقبّل خيار النقل المشترك المتوفر، ومن كان يزور قريته مرة في الأسبوع صار يزورها مرة في الشهر ليوفر ثمن البنزين، من دون أن يفكّر باستخدام الفان».
صحيح أنّ أزمة النقل البري تتجاوز حدود الضاحية، لكن الأخيرة «حالة خاصة» فيما يخصّ زحمات السير لعوامل عدة، في مقدّمها الكثافة السكانية. لكن هذه تنقسم الآراء حول تأثيرها، بين من يرى أنها ليست بالضرورة مؤشراً سلبياً لأنها، من حيث المبدأ، يجب أن تؤدي إلى استخدام أقلّ للسيارات نظراً إلى قرب المسافات، شرط إدارة الكثافة السكانية وتوزع المدارس والمحال التجارية وأماكن الترفيه، ومن يرى أن الاكتظاظ السكاني يتسبّب في «ثقل التنقل»، عدا استقبال الضاحية وافدين يقصدونها لغايات مختلفة. ومن العوامل أيضاً فوضى التخطيط المدني التي تراكمت منذ الحرب الأهلية، وتجاهل قطاع النقل عند إنشاء الأسواق التجارية والمؤسسات الصناعية والمدارس وأسواق الخضر، وعدم مواكبة التغيرات الديموغرافية بتعديل خرائط التنظيم المدني، ما أدى إلى فوضى عمرانية، زادها سوءاً تداعي هيكل الدولة وإفلاس البلديات.
 الخيام | khiyam.com
الخيام | khiyam.com 

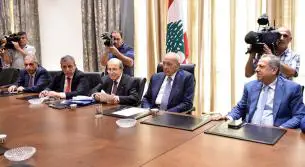









تعليقات: