
كنيسة آيا تريادا اليونانية الأرثوذكسية
كان من الطبيعيّ أن تنقسم الآراء في العالم الأرثوذكسيّ على رسامة السيّدة أنجيليك مولين، أوّل امرأة شمّاسة في العصر الحديث، التي جرت قبل نيّف وأسبوعين في زيمبابوي على يد المطران سيرافيم (كيكوتيس). بعضهم هلّل لقرار بطريركيّة الإسكندريّة استعادة الشموسيّة النسائيّة ولجرأة المطران كيكوتيس بالذات. بعضهم أفرط في النقد وتنبّأ بالويل والثبور وعظائم الأمور. وبعضهم آثر الالتزام بالصمت، أو لجأ إلى نقد مخفّف، أو انبرى يطرح أسئلةً تتّصل بمستقبل خدمة النساء في الكنائس. مناخ النقاش صحّيّ في المبدأ شرط أن يتّسم بالموضوعيّة وتبادل الحجج بهدوء، ويتفادى الوقوع في التهويل والتجريح والأبلسة.
يلفت لدى الذين شكّكوا في صوابيّة الخطوة حجّتان: الأولى تستدعي «مجمعيّة» الكنيسة الأرثوذكسيّة، أي إنّ خطوةً من هذا النوع كان يجب أن تحظى بإجماع الكنائس الأرثوذكسيّة قاطبةً، لا أن «تتفرّد» بها كنيسة الإسكندريّة، ولا سيّما أنّ الأرثوذكس يعيشون حالاً من الانقسام على عدد من المسائل الشائكة كالحرب الدائرة على أرض أوكرانيا وما تستتبعه من أسئلة عن العلاقة بين الكنيسة والدولة، فضلاً عن اختلافهم على ماهيّة الدور الذي يجب يقوم به بطريرك القسطنطينيّة، أي اسطنبول حاليّاً، ومعنى أن تكون له الأوّليّة بين بطاركة متساوين في الكرامة. مشكلة مثل هذا التفكير أنّه يرمي إلى معالجة عارض الداء بدلاً من التصدّي للداء ذاته، وذلك لأنّه يعتبر أنّ المجمعيّة الأرثوذكسيّة مسلّمة تمعن شمّاسيّة النساء، وظواهر أخرى طبعاً، في إفسادها، عوضاً عن الاعتراف بأنّ الأرثوذكس، في العصر الحديث، فشلوا في تقديم نموذج ناجع لهذه المجمعيّة. الكنائس الأرثوذكسيّة لم تبدأ تشرذمها برسامة شمّاسة في زيمبابوي، ولا بالانقسام على الحالة الأوكرانيّة. هذا التشرذم بدأ بعد سقوط جدار برلين وخروج كنائس أوروبّا الشرقيّة من عباءة الشيوعيّة. قبل سقوط المعسكر الشيوعيّ، كان البلاشفة يرسلون خيرة المفكّرين الكنسيّين إلى النفي أو إلى الغولاغ، ويستخدمون الكنائس لتحقيق أجندة الحزب الحاكم. لئن خنق هذا الصوتَ الكنسيّ وجعله يدور في فلك القياصرة الجدد ذوي المرجعيّة الماركسيّة، إلّا أنّه أعطى الانطباع أنّ الكنائس وحدة متراصّة. وحين انتهت المسرحيّة وانعتقت الكنائس من النير، ظلّت هذه أسيرة ترجّحها بين كراهية النموذج البلشفيّ واستدخال منهجيّته القمعيّة، وفشلت في أن تضطلع بدور رياديّ في تشكيل الفضاء القيميّ لزمن ما بعد الستار الحديديّ، حتّى إنّها راحت تنقسم وتتشرذم وتختلف على أصغر الأمور. وحين حاول بطريرك اسطنبول لمّ شمل الكنائس الأرثوذكسيّة في مجمع كريت العام 2016، شاب هذا المسعى لا مقاطعة كنائس روسيا وبلغاريا وجورجيا وأنطاكية فحسب، بل أيضاً حذف كلّ المسائل الخلافيّة الفعليّة من جدول الأعمال وتحاشي الخوض فيها. منذ ذلك الوقت، لم نشهد أيّ محاولة جدّيّة قام بها أحد قادة الكنائس الأرثوذكسيّة لاستخلاص العبر من فضيحة مجمع كريت، أو لتجديد الفكرة المجمعيّة وتأسيسها على قاعدة صلبة. إذا كان هذا التحليل صحيحاً، فإنّ «الوحدة» الأرثوذكسيّة التي كنّا نتغنّى بها قبل سقوط المعسكر الشرقيّ كانت، بالدرجة الأولى، صنيعة الخضوع القسريّ للسلطة، وحريّ بكلّ واحد منّا أن يشعل شمعةً في الكنيسة للرفيق ستالين وخلفائه، الذين نجحوا في فرض وحدة كنسيّة، ولو شكليّة، نفتقدها اليوم. وربّما يتعيّن علينا أيضاً أن نشعل شمعات مماثلةً لقياصرة روسيا القدماء، وللسلطان العثمانيّ، وحتّى للقيصر البيزنطيّ. ومن ثمّ، السؤال الذي يطرح ذاته هو عن إمكان قيام وحدة حقيقيّة بين الكنائس الأرثوذكسيّة من خارج الالتفاف بعباءة السلطة. فإذا كان الجواب إيجاباً، كيف يمكن تحقيق مثل هذه الوحدة وتظهيرها؟ فحوى القول، إذاً، أنّ الانقسام على شمّاسيّة النساء إن هو إلّا العارض. أمّا الداء، فيكمن في أنّنا نحتاج إلى تجديد فكرة المجمعيّة الأرثوذكسيّة، واختراع آليّات حقيقيّة لتجسيدها.
الحجّة الثانية التي تستوقف في خطاب المنتقدين والمسائلين هي ما يمكن تسميته «الحجّة السيكولوجيّة». فبعض هؤلاء يطرح السؤال عن المآلات السيكولوجيّة لوجود الجنسين معاً في الطقوسيّات ذاتها، وخصوصاً لدى الاحتفال بالقدّاس الإلهيّ. الاستنجاد بالبعد السيكولوجيّ في ذاته أمر جيّد، لكونه يحيلنا على الاحتمالات الإنسانيّة من خارج العمارات اللاهوتيّة ومنمّطات كتب العقيدة. ليس كلّ ما في الممارسة الكنسيّة لاهوت، بل كثير منه تتحكّم فيه عوامل سيكولوجيّة. هذا تعلّمناه من المفكّر الألمانيّ الفذّ أوجين دريفرمان، الذي وضع كتاباً مرجعيّاً في تحليل الآليّات السيكولوجيّة لدى الإكليريكيّين وفكّكها. وتعلّمناه كذلك من الفضائح الجنسيّة التي يحفل بها الجسم الكنسيّ اليوم، والتي راحت تتكشّف بشكل مطّرد إبّان السنين الماضية. بلى بلى. ليس كلّ ما في الكنائس لاهوت، بل كثير منه ذو جذور سيكولوجيّة، فضلاً عن عوامل اجتماعيّة وسياسيّة وتاريخيّة. إذا كان الأمر كذلك، لا مناص من طرح السؤال عن أثر العوامل السيكولوجيّة لا بالنسبة إلى استعادة شمّاسيّة النساء فحسب، بل حين يتّصل الأمر باندثارها أيضاً. بعبارات أخرى: هل نتج هذا الاندثار فعلاً من عوامل عملانيّة صرف، كانتفاء الحاجة إلى نساء شمّاسات، أم ارتبط خصوصاً بسيكولوجيا الخوف من الأنثويّ التي فرضت ذاتها على المجتمعات الكنسيّة، والتي نجد أصداء لها اليوم لا في الطقوسيّات فحسب، بل في الأدب النسكيّ وسلوك بعض الجماعات الرهبنيّة أيضاً؟ ومن ثمّ، إنّ فتح باب السيكولوجيّ على مصراعيه ضرورة في تحليل شؤون الكنائس وشجونها. بيد أنّ هذا يجب أن يحصل في الاتّجاهات جميعها. ومن أبرز هذه الاتّجاهات نقد التاريخ الكنسيّ عبر التبصّر لا في ما تقوله المصادر القديمة فحسب، بل في ما لا تقوله أيضاً، أو تتكتّم عليه عن قصد.
هكذا يبدو أنّ النقاش الدائر اليوم على شمّاسيّة النساء يختزن القدرة على أن يكشف جمهرةً من المسائل المختصّة بحياة الكنائس والتي لا يزال الكلام عليها خافتاً، لكونها تحتجب وراء أحابيل اللغة الدينيّة وإحالاتها شبه الأسطوريّة. والحقّ أنّه آن الأوان لطرح هذه المسائل على بساط البحث بكثير من الجرأة والنزاهة الفكريّة.
 الخيام | khiyam.com
الخيام | khiyam.com 



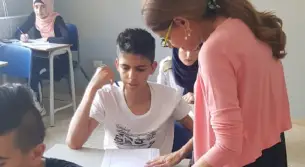
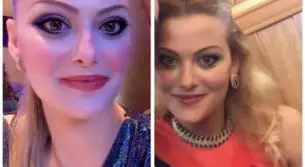






تعليقات: