
ўДўЕ ўКўГўЖ ўКЎ≠Ў™ўЕўД ЎІўДЎІЎ®Ў™ЎєЎІЎѓ ЎІўДЎЈўИўКўД ЎєўЖ Ў®ўДЎѓЎ™ўЗ ЎІўДЎЃўКЎІўЕЎМ ўБўКЎ™Ў≠ўКўСўЖ ЎІўДўБЎ±Ўµ ўГўК ўКЎµЎєЎѓ Ў•ўДўКўЗЎІ ўЕЎ™Ў£Ў®ЎЈўЛЎІ ўВЎµЎІЎ¶ЎѓўЗ ЎІўДЎђЎѓўКЎѓЎ©. ўИўВЎ™Ў∞ЎІўГ ўБўК Ў£ўИЎІЎЃЎ± Ў≥Ў™ўКўЖўКўСЎІЎ™ ЎІўДўВЎ±ўЖ ЎІўДўЕЎІЎґўКЎМ ўГЎІўЖ ўКўЖЎ™ЎЄЎ± Ў≤Ў≠ўБ ЎІўДЎєЎ™ўЕЎ© Ў≠Ў™ўСўЙ ўКЎµЎєЎѓ Ў•ўДўЙ ЎІўДЎ≥ЎЈЎ≠ЎМ ўЕўДўИўСЎ≠ўЛЎІ Ў®ўВўЖЎѓўКўДўЗЎМ ўБўКЎ™ўЖЎ®ўСўЗ ўВЎ±ўКЎ®ўЗ ЎєўДўК ЎІўДЎєЎ®ЎѓЎІўДўДўЗ ЎІўДўВЎІЎЈўЖ ЎєўДўЙ ўЕЎ≥ЎІўБЎ© ЎєЎіЎ±ЎІЎ™ ЎІўДЎ£ўЕЎ™ЎІЎ±ЎМ ўБўКЎ£Ў™ўК ЎєЎІЎ±ўБўЛЎІ Ў£ўЖўС ўЕЎ≠ўЕўСЎѓ ўГЎ™Ў® ўВЎµўКЎѓЎ©ЎМ ўИўКЎ±ўКЎѓ ўЕўЖўЗ ЎІўДЎ•ўЖЎµЎІЎ™ Ў•ўДўЙ Ў£Ў®ўКЎІЎ™ўЗЎІЎМ ўИЎєўДўК ЎІўДЎєЎ®ЎѓЎІўДўДўЗ ЎіЎІЎєЎ± ўЕўЖ ўГЎ™ўКЎ®Ў© ЎіЎєЎ±ЎІЎ° ЎҐўД ЎІўДЎєЎ®ЎѓЎІўДўДўЗ.
ўДўЕ ўКўЖЎ™Ў®ўЗ ўЕЎ≠ўЕўСЎѓ Ў£ўЖ Ў™ўДўИўКЎ≠ўЗ Ў®Ў∞ўДўГ ЎІўДўВўЖЎѓўКўД ўГЎІўЖ ЎІўДўВЎµўКЎѓЎ© ЎІўДўЕЎђЎ≥ўСЎѓЎ©.
ЎІўДЎЃўКЎІўЕўКўС ЎІўДЎ≥ўЖЎѓЎ®ЎІЎѓ
ўБўК ЎІўДЎЃўКЎІўЕ ЎІўДЎ≠ЎѓўИЎѓўКўСЎ© ўИўДЎѓ ўЕЎ≠ўЕўСЎѓ ЎІўДЎєЎ®ЎѓЎІўДўДўЗ Ў≥ўЖЎ© 1946ЎМ ўБЎІўЖЎђЎ®ўД ўЗўЖЎІўГ Ў®ЎІўДЎ™ўДЎІўД ўИЎІўДўИЎѓўКЎІўЖ ўИЎ®ўДўСўД ЎЂўКЎІЎ®ўЗ Ў®ўАвАЭЎІўДЎѓЎ±ЎѓЎІЎ±Ў©вАЭЎМ ўИЎєЎ±ўРўБ ЎІўДЎєЎµЎІўБўКЎ± ўЕўЖ Ў£ЎµўИЎІЎ™ўЗЎІЎМ ўИЎІўДЎ≤ўКЎ≤ЎІўЖ ўЕўЖ Ў£ЎђўЖЎ≠Ў™ўЗЎІЎМ ўИЎ£ўДўРўБ ЎІўДЎ®ЎєўИЎґ ўИЎІўДЎєўВЎІЎ±Ў® ЎµўКўБўЛЎІЎМ ўИЎ≠ЎіЎ±ЎђЎІЎ™ ЎІўДўВЎЈЎЈ ўИЎІўДўБЎ¶Ў±ЎІўЖ ЎІўДўЕЎ±Ў™ЎђўБЎ© ЎіЎ™ЎІЎ°ўЛ. ўДЎ∞ўДўГ ўБЎ™Ў≠ ЎєўКўЖўКўЗ ЎєўДўЙ ўГЎІўЕўД ўИЎ≥ЎєўЗўЕЎІ Ў≠ўКўЖўЕЎІ ўЗЎ®ЎЈ Ў•ўДўЙ Ў®ўКЎ±ўИЎ™ЎМ ўДЎІ ўДўКЎіЎІўЗЎѓ ўБЎ≠Ў≥Ў®ЎМ Ў®ўД ўДўКЎ≠ўБЎЄ Ў≠Ў™ўСўЙ ўКЎ£ўДўОўБ ўИўКЎ£ўЕўЖ.
ўЗўГЎ∞ЎІ Ў≠Ў™ўЙ ЎµЎІЎ±Ў™ Ў®ўКЎ±ўИЎ™ Ў±ўБўКўВЎ™ўЗЎМ ўБўКўЖЎІўД ўЕўЖ ЎђЎІўЕЎєЎ™ўЗЎІ ЎІўДЎєЎ±Ў®ўКўСЎ© Ў•ЎђЎІЎ≤Ў© ўБўК ЎІўДўБўДЎ≥ўБЎ© Ў≥ўЖЎ© 1973ЎМ ўИўКЎ≥Ў™Ў™Ў®ЎєўЗЎІ Ў®ЎіўЗЎІЎѓЎ© ЎІўДўГўБЎІЎ°Ў© ўБўК ЎІўДЎ£ЎѓЎ® ЎІўДЎєЎ±Ў®ўКўС ўЕўЖ ўГўДўСўКўСЎ© ЎІўДЎ™Ў±Ў®ўКЎ© ўБўК ЎІўДЎђЎІўЕЎєЎ© ЎІўДўДЎ®ўЖЎІўЖўКўСЎ©ЎМ ўИЎєўДўЙ ЎѓЎ®ўДўИўЕ ЎІўДЎѓЎ±ЎІЎ≥ЎІЎ™ ЎІўДўЕЎєўЕўСўВЎ© ўБўК ЎІўДЎ£ЎѓЎ® ЎІўДЎєЎ±Ў®ўКўСЎМ ЎЂўЕ ўКЎ≠ўИЎ≤ ЎєўДўЙ ЎіўЗЎІЎѓЎ© ЎІўДЎ≥ўИЎ±Ў®ўИўЖ ЎІўДЎЂЎІўДЎЂЎ© Ў≥ўЖЎ© 1977.
Ў®ЎєЎѓ Ў∞ўДўГ ЎєЎІЎѓ ўЕЎ≠ўЕўСЎѓ ЎІўДЎєЎ®ЎѓЎІўДўДўЗ ўДўКЎЇўЕЎ± Ў®ўКЎ±ўИЎ™ ўЕўЖ ЎђЎѓўКЎѓЎМ ўИўКЎ™ўСўГЎ¶ ЎєўДўЙ ўГЎ™ўБ ЎІўДЎЃўКЎІўЕ. ЎІўБЎ™Ў™ўЖ ЎіЎІЎєЎ±ўЖЎІ Ў®ўЕЎ≤ЎІўКЎІ ЎІўДЎ≥ўБЎ±ЎМ ўБЎ®ЎѓўСЎѓ ўГЎЂўКЎ±ўЛЎІ ўЕўЕўСЎІ ўГЎІўЖ ўКЎ™ўВЎІЎґЎІўЗ ўЕўЖ ЎІўДЎ™ЎєўДўКўЕ ўИЎІўДЎµЎ≠ЎІўБЎ© ўБўК Ў±Ў≠ўДЎІЎ™ўЗ ЎІўДўГЎЂўКЎ±Ў©ЎМ ўЕЎ≥Ў™ўДЎ∞ўСўЛЎІ Ў®ўЗўИЎІўКЎ™ўЗ Ў™ўДўГЎМ Ў®ўКўЖўЕЎІ Ў®ЎѓўСЎѓ ЎІўДўВЎ≥ўЕ ЎІўДЎҐЎЃЎ± ЎєўДўЙ ЎЈЎІўИўДЎІЎ™ ЎІўДўВўЕЎІЎ± ЎІўДЎ™ўК Ў£ўДўРўБўЗЎІ ўЕўЖ Ў£ЎµЎЇЎ± ўЕўВўЗўЙ Ў≠Ў™ўСўЙ вАЬўГЎІЎ≤ўКўЖўИ ўДЎ®ўЖЎІўЖвАЭЎМ ўИўЗўИ ўЕЎІ ўГЎ™ўЕўЗ ЎєўЖ ўЕўИЎІЎґўКЎє ўВЎµЎІЎ¶ЎѓўЗ ўИўЕўВЎІўДЎІЎ™ўЗЎМ Ў≥ЎІўЕЎ≠ўЛЎІ ўДЎєўДЎІўВЎ™ўЗ Ў®ЎІўДўГЎ£Ў≥ Ў£ўЖ Ў™Ў™Ў≥ўДўСўД Ў•ўДўЙ ЎѓўИЎІўИўКўЖўЗ Ў®ЎІўЖЎ≥ўКЎІЎ®ўКўСЎ©ЎМ ўЕЎЂўДўЗ ўЕЎЂўД Ў≥ўДЎ≥ўДЎ© ЎІўДЎіЎєЎ±ЎІЎ° ўЕўЕўСўЖ Ў£ЎЃЎ±ЎђўИЎІ ЎІўДЎЃўЕЎ± ўЕўЖ Ў™ўЕЎЄўЗЎ±ўЗ ЎІўДўБўКЎ≤ўКЎІЎ¶ўКўС ўЖЎ≠ўИ ўБЎґЎІЎ°ЎІЎ™ ЎІўДЎіЎЈЎ≠ ЎІўДЎµўИўБўКўС.
ЎђЎ±Ў£Ў© ЎІўДўВЎµўКЎѓЎ© ўИЎЇЎ±ЎІЎ¶Ў®ўКўСЎ™ўЗЎІ
ўЕЎЂўДўЕЎІ ўГЎІўЖЎ™ Ў≠ўКЎІЎ™ўЗ ЎЇЎ±ЎІЎ¶Ў®ўКўСЎ© ўИЎ£ўБўГЎІЎ±ўЗ ўЕЎіЎІўГЎ≥Ў©ЎМ ўГЎІўЖЎ™ ўВЎµўКЎѓЎ™ўЗ ЎђЎ±ўКЎ¶Ў© ўИўДЎІ ўЕЎ®ЎІўДўКЎ©ЎМ ўЕЎ≤Ўђ ўБўКўЗЎІ ЎІўДўЕЎ≠ўГўКўС Ў®ЎІўДўБЎµўКЎ≠ЎМ ўИўЕЎЂўДўЕЎІ ўВЎІЎ±Ў® ЎІўДЎ™ўБЎєўКўДЎ© ўИЎІўДўЖЎЂЎ± ўБўК ЎІўДЎѓўКўИЎІўЖ ЎєўКўЖўЗЎМ ўГЎ∞ўДўГ Ў™ўБўЖўСўЖ Ў®ЎєўЖЎІўИўКўЖ ЎѓўИЎІўИўКўЖўЗ ўЕЎЂўД вАЬЎ®ЎєЎѓ ЎЄўЗЎ± ўЖЎ®ўКЎ∞ Ў£Ў≠ўЕЎ±вА¶ Ў®ЎєЎѓ ЎЄўЗЎ± ЎЃЎЈЎ£ ўГЎ®ўКЎ±вАЭЎМ Ў£ўИ ўВЎµЎµўЗЎМ ўЕЎЂўД вАЬЎІўДЎ®ўКЎђЎІўЕЎІ ЎІўДўЕўВўДўСўЕЎ©вАЭ.
вАЬўЗўИ Ў•ўЖЎ≥ЎІўЖ ўЕЎЃЎ™ўДўБвАЭ Ў™ўИЎµўКўБ ўКЎђўЕЎє ЎєўДўКўЗ ўГўДўС ўЕўЖ Ў±ЎІўБўВ ЎІўДЎєЎ®ЎѓЎІўДўДўЗ Ў£ўИ Ў™ЎІЎ®Ўє Ў£ЎєўЕЎІўДўЗЎМ ўБўГЎІўЖ ЎІўДЎ™ўБЎ±ўСЎѓ Ў≥ўЕЎ© ўБўК Ў£ЎµўД ЎђЎ®ўДЎ™ўЗ ЎѓўИўЖ ЎІўБЎ™ЎєЎІўД Ў£ўИ ЎІўЖЎ™Ў≠ЎІўД ўДўДўЖўЕЎІЎ∞Ўђ ЎІўДЎ≥ўИЎ±ўКЎІўДўКўСЎ© ЎІўДЎ™ўК ЎєЎ±ўБўЗЎІ ЎђўКўСЎѓўЛЎІЎМ ўИўДўЕ ўКЎ≥ўВЎЈ ўБўК ўБЎЃўС ЎІЎ≥Ў™ўДЎ®ЎІЎ≥ўЗЎІЎМ ўБЎ®ўВўК ўЗўИ ЎІўДўЕЎЇЎ±ўСЎѓ ЎІўДўЕЎ™ўБЎ±ўСЎѓ.
ЎіЎєЎ±ўЗ ЎІўДўЕЎЇўЖўСўОўЙ
ўГЎЂўКЎ±Ў© ўЗўК ўВЎµЎІЎ¶Ўѓ ўЕЎ≠ўЕўСЎѓ ЎІўДЎєЎ®ЎѓЎІўДўДўЗ ЎІўДЎ™ўК ЎЇўЖўСЎІўЗЎІ ўЕЎІЎ±Ў≥ўКўД ЎЃўДўКўБЎ© ўИўДўЕ ўКЎєЎ±ўБ ЎІўДўЖЎІЎ≥ ЎІЎ≥ўЕ ўГЎІЎ™Ў®ўЗЎІЎМ ЎєўДўЙ ЎєўГЎ≥ ЎіўЗЎ±Ў© ўВЎµЎІЎ¶Ўѓ ўЕЎ≠ўЕўИЎѓ ЎѓЎ±ўИўКЎі ўИЎіўИўВўК Ў®Ў≤ўКЎє ўИЎЈўДЎІўД Ў≠ўКЎѓЎ± ЎІўДЎ™ўК ЎєЎ±ўБ ЎІўДўЖЎІЎ≥ Ў£ЎµЎ≠ЎІЎ®ўЗЎІ Ў®Ў£Ў≥ўЕЎІЎ¶ўЗўЕ ўИЎµўИЎ±ўЗўЕ. Ў≠Ў™ўСўЙ Ў≠Ў≥ўЖ ЎІўДЎєЎ®ЎѓЎІўДўДўЗ ЎєўПЎ±ўРўБ Ў®ўВЎµўКЎѓЎ© вАЬЎ£ЎђўЕўД ЎІўДЎ£ўЕўЗЎІЎ™вАЭЎМ ўИЎєЎ®ўСЎІЎ≥ Ў®ўКЎґўИўЖ Ў®ўАвАЭўКЎІ ЎєўДўКвАЭЎМ Ў®ўКўЖўЕЎІ ЎіўЗЎ±Ў© ўЕЎ≠ўЕўСЎѓ ўГЎІўЖЎ™ Ў£ўВўДўСЎМ ўИўЗўИ ЎІўДЎ∞ўК ўГЎ™Ў® вАЬЎІўДЎђЎ±ўКЎѓЎ©вАЭЎМ ўИвАЭўЕўЖ ўЗўЖЎІ Ў™Ў®ЎѓЎ£ ЎІўДЎЃЎІЎ±ЎЈЎ©вАЭЎМ ўИвАЭўЕўЖ ЎІўДўЕўИЎђ ўДўДЎЂўДЎђ ўЖЎ£Ў™ўКўГвАЭЎМ ўИЎµўИўДўЛЎІ Ў•ўДўЙ вАЬўДўДЎ∞ўК ўВўДЎ®ўК ЎІўДЎҐўЖ Ў™ўБўСЎІЎ≠Ў© ўБўК ўКЎѓўКўЗ/ ўДўДЎ∞ўК ўВўДЎ®ўК ЎІўДЎҐўЖ ўГЎ±Ў© Ў®ўКўЖ Ў±ЎђўДўКўЗ/ ўДўДЎ∞ўК ўДўИ ўЖЎІўЕ/ Ў±ўИЎ≠ўК Ў™Ў±ўБЎ±ўБ ўЕЎЂўД ўБЎ±ЎІЎіЎ© ўБўИўВ Ў≥Ў±ўКЎ±ўЗвАЭ.
Ў£ўЕўСЎІ Ў£ўЕўКўЕЎ© ЎІўДЎЃўДўКўД ўБўВЎѓ ЎЇўЖўСЎ™ ўДўЗ ўИЎІЎ≠ЎѓЎ© ўЕўЖ Ў£Ў±ўВўС ЎІўДЎІЎЇўЖўКЎІЎ™ ЎІўДЎ±ўИўЕЎІўЖЎ≥ўКўСЎ©: вАЬўИўВўДЎ™ Ў®ўГЎ™Ў®ўДўГ /ўЗўКўГ ўГЎІўЖўИЎІ ўКЎєўЕўДўИЎІ ЎІўДЎєЎіўСЎІўВ/ ўЗўКўГ ўГЎІўЖўИЎІ ўКўИўДўСЎєўИЎІ ўЖЎІЎ±ўЖ ЎєўДўЙ Ў™ўДЎђ ЎІўДЎ£ўИЎ±ЎІўВвАЭ.
вАЬўЗўИ Ў•ўЖЎ≥ЎІўЖ ўЕЎЃЎ™ўДўБвАЭ Ў™ўИЎµўКўБ ўКЎђўЕЎє ЎєўДўКўЗ ўГўДўС ўЕўЖ Ў±ЎІўБўВ ЎІўДЎєЎ®ЎѓЎІўДўДўЗ Ў£ўИ Ў™ЎІЎ®Ўє Ў£ЎєўЕЎІўДўЗЎМ ўБўГЎІўЖ ЎІўДЎ™ўБЎ±ўСЎѓ Ў≥ўЕЎ© ўБўК Ў£ЎµўД ЎђЎ®ўДЎ™ўЗ ЎѓўИўЖ ЎІўБЎ™ЎєЎІўД Ў£ўИ ЎІўЖЎ™Ў≠ЎІўД ўДўДўЖўЕЎІЎ∞Ўђ ЎІўДЎ≥ўИЎ±ўКЎІўДўКўСЎ© ЎІўДЎ™ўК ЎєЎ±ўБўЗЎІ ЎђўКўСЎѓўЛЎІЎМ ўИўДўЕ ўКЎ≥ўВЎЈ ўБўК ўБЎЃўС ЎІЎ≥Ў™ўДЎ®ЎІЎ≥ўЗЎІЎМ ўБЎ®ўВўК ўЗўИ ЎІўДўЕЎЇЎ±ўСЎѓ ЎІўДўЕЎ™ўБЎ±ўСЎѓ
Ў®ўКўЖўЕЎІ ЎЇўЖўСўЙ Ў£Ў≠ўЕЎѓ ўВЎєЎ®ўИЎ± ўЕўЖ ўГўДўЕЎІЎ™ўЗ: вАЬЎіўИ Ў®ЎєЎІЎѓ.. Ў®ЎєЎІЎѓ/ ўЕЎ™ўД Ў™ўЖўКўЖ ўЕЎ™ўД ўГўБўСўКўЖ Ўє ўЕўБЎ±ўВ/ Ў®ўКўДўСўИЎ≠ўИЎІ ўЕЎ™ўД ЎІўДЎ≥ўБўКўЖЎ© ўВЎ®ўД ўЕЎІ Ў™ЎЇЎ±ўВ/ ЎіўИ Ў®ЎєЎІЎѓ .. Ў®ЎєЎІЎѓ/ ўЕЎ™ўД ЎєўКўЖўКўЖ ўЕЎІ Ў®ўКўДЎ™ўВўИЎІ Ў•ўДўСЎІ Ў®ЎІўДўЕЎ±ЎІўКЎ©/ ўИЎ®ўКўЖЎІЎ™ўЖЎІ ўБўК ўВЎ≤ЎІЎ≤/ ўИўБўК Ў≤ўЕўЖ ўЗЎ≤ўСЎІЎ≤/ ЎµўИЎ±Ў© Ўє ЎµўИЎ±Ў© Ў®Ў™ўЕЎ≠ўКўЗЎІ/ ўИўИЎ±ўВ ЎІўДўЗўИўЙ ЎєўЕ ўКЎ±ўЕўКўЗЎІвАЭ. ўГЎ∞ўДўГ ўГЎ™Ў® ўДўВЎєЎ®ўИЎ± вАЬўЖЎ≠ўЖЎІ ЎІўДўЖЎІЎ≥вАЭ ЎІўДЎ™ўК Ў™ўЕўС Ў™ЎµўИўКЎ±ўЗЎІ ўГўАвАЭўБўКЎѓўКўИ ўГўДўКЎ®вАЭ ўЕўЖ Ў•ўЖЎ™ЎІЎђ Ў™ўДўБЎ≤ўКўИўЖ ЎІўДўЕЎ≥Ў™ўВЎ®ўДЎМ ўИЎ™ўВўИўД ўГўДўЕЎІЎ™ўЗЎІ: вАЬЎіўИЎІЎ±Ўє ЎІўДўЕЎѓўКўЖЎ© ўЕЎі ўДЎ≠ЎѓЎІ/ ЎіўИЎІЎ±Ўє ЎІўДўЕЎѓўКўЖЎ© ўДўГўДўС ЎІўДўЖЎІЎ≥/ Ў±ЎµўКўБ ЎІўДЎ®Ў≠Ў± ўЕЎі ўДЎ≠ЎѓЎІ/ Ў±ЎµўКўБ ЎІўДЎ®Ў≠Ў± ўДўГўДўС ЎІўДўЖЎІЎ≥вАЭ.
ўДўГўЖўСўЗ ўЕЎє Ў≥ЎІўЕўК Ў≠ўИЎІЎЈ ўДўЕ ўКўГўЖ Ў±ўИўЕЎІўЖЎ≥ўКўСўЛЎІ ЎІўДЎ®Ў™ўСЎ©ЎМ ўДЎ™ўГўИўЖ вАЬЎ£Ў≠Ўѓ ЎІўДЎ£ЎЃўИЎІўЖвАЭ ЎІўДЎ£ЎЇўЖўКЎ© ЎІўДЎ£ўГЎЂЎ± Ў™ўЗўГўСўЕўЛЎІ ўИўИЎђЎєўЛЎІ ўИЎ™ЎєЎ®ўЛЎІЎМ Ў®ўГўДўЕЎІЎ™ ўЕЎ£ЎЃўИЎ∞Ў© ўЕўЖ ўВЎІўЕўИЎ≥ ЎІўДЎіЎІЎ±Ўє: вАЭ Ў£Ў≠Ўѓ ЎІўДЎ•ЎЃўИЎІўЖ/ ўИЎ£ўЖЎІ Ў£Ў®Ў™ЎІЎє Ў±ЎЇўКўБ ўБўДЎІўБўД ўЕўЖ Ў∞ЎІўГ ЎІўДЎѓўГЎІўЖ/ ўДўЕ ўКЎєЎђЎ®ўЗ Ў£ўЕЎ±ўМ ўДЎІ Ў£ЎєЎ±ўБўЗ ўБўКўСЎІ/ Ў£Ў≠Ўѓ ЎІўДЎІЎЃўИЎІўЖ ўДЎ®ЎЈўЖўК/ ўИЎ£ўЖЎІ Ў•ўЖ ўВўРўКЎ≥ўО ЎІўДЎ•ўЖЎ≥ЎІўЖўП Ў®ўЗЎІўЕўОЎ™ўРўЗўР Ў≥Ў£Ў≥ЎІўИўК ўЕўЖ ўЗЎ∞ЎІ ЎІўДЎ£ЎЃ ЎІЎЂўЖўКўЖ/ Ў£ўИ ўВўКЎ≥ ЎІўДЎ•ўЖЎ≥ЎІўЖ Ў®ўБўГЎ±Ў™ўЗ Ў≥Ў£Ў≥ЎІўИўК Ў£ўДўБўКўЖ/ Ў£ўИ ўВўКЎ≥ ЎІўДЎ•ўЖЎ≥ЎІўЖ Ў®Ў±ўВўСЎ™ўЗ ўИЎіЎђЎІЎєЎ™ўЗ Ў≥Ў£Ў≥ЎІўИўК ўЕўДўКўИўЖўКўЖ/ ўВўДЎ™: Ў≥Ў£ўДўВўСўЖ ўЗЎ∞ЎІ ЎІўДЎ≠ўКўИЎІўЖ ЎѓЎ±Ў≥ўЛЎІ ўДЎІ ўКўЖЎ≥ЎІўЗ/ Ў≥Ў£ЎґЎ±Ў®ўЗ ўГўБўСўКўЖ/ ўИўДўГўЖЎМ Ў≠ўКўЖ ЎєўДўЕЎ™ Ў®Ў£ўЖўСўО ЎІўДЎ£ЎЃўО ЎІўДўДўСЎІЎ®ЎЈ Ў£ЎєўДЎІўЗ ўЕўЖ Ў≤ўРўДўЕўР ЎІўДЎ≥ўСўПўДЎЈЎІўЖ Ў£Ў≠ЎђўЕЎ™/ ўДЎ£ўЖўСўК Ў™ЎєЎ®ЎІўЖ/ ўВЎ≥ўЕўЛЎІ Ў®ЎєўДўКўСўН ўИЎІўДЎєЎ®ўСўОЎІЎ≥ Ў£ўЖЎІ Ў™ЎєЎ®ЎІўЖ/ ўВЎ≥ўЕўЛЎІ Ў®ЎµўДЎІЎ≠ ЎІўДЎѓўСўРўКўЖўР ўИЎ≠ЎЈўСўРўКўЖўР Ў£ўЖЎІ Ў™ЎєЎ®ЎІўЖ/ ўИЎђўЕўКЎє ЎІўДЎђЎ®ўЗЎІЎ™ ўДЎ™Ў≠Ў±ўКЎ± ўБўДЎ≥ЎЈўКўЖ Ў£ўЖЎІ Ў™ЎєЎ®ЎІўЖвАЭ.
ўЖЎµўБ ўЕЎ≥Ў±Ў≠ўКўС
вАЬўДЎѓўКўС ўЕЎ≥Ў±Ў≠ўКЎ© ўИЎ≠ўКЎѓЎ© ўЗўК вАЬўЕЎµЎ±Ўє ЎѓўИўЖ ўГўКЎіўИЎ™¬ї ўЕўЖ Ў•ЎЃЎ±ЎІЎђ Ў±ЎґўИЎІўЖ Ў≠ўЕЎ≤Ў©ЎМ ўЗўК Ў£Ў≥ЎІЎ≥ўЛЎІ ЎіЎєЎ± ўИўДўГўЖ ўБўК ЎіўГўД ўЕЎ≥Ў±Ў≠ўКўС ўДЎ£ўЖўС Ў®ўЖўКЎ© ЎІўДўВЎµўКЎѓЎ© Ў®ўЖўКЎ© ўЕЎ≥Ў±Ў≠ўКўСЎ©. ўГЎ™Ў®Ў™ ўЕЎ≥ўДЎ≥ўДўЛЎІ Ў•Ў∞ЎІЎєўКўСўЛЎІ ўИўЕЎ≥Ў±Ў≠ўКўСЎ™ўКўЖ Ў£ЎЃЎ±ўКўКўЖЎМ ўИЎІЎ≠ЎѓЎ© ўЖўПЎіЎ±Ў™ ўБўК ўЕЎђўДўСЎ© вАЬЎІўДЎЈЎ±ўКўВвАЭ ўИЎІўДЎ£ЎЃЎ±ўЙ ўДўЕ Ў™ўЖЎіЎ± Ў®ЎєЎѓвАЭ ўКўВўИўД ўЕЎ≠ўЕўСЎѓ ЎІўДЎєЎ®ЎѓЎІўДўДўЗ ўБўК Ў•Ў≠ЎѓўЙ ЎІўДЎ≠ўИЎІЎ±ЎІЎ™ ЎІўДЎ™ўК Ў£ЎђЎ±ўКЎ™ ўЕЎєўЗЎМ ўИўГЎ£ўЖўСўЗ ўБўК ЎєўДўКЎІЎ¶ўЗ ЎІўДЎҐўЖ ўКЎ±ЎѓўСЎѓ Ў≥ЎІЎЃЎ±ўЛЎІ: вАЬўЕЎµЎ±Ўє ЎѓўИўЖ ўГўКЎіўИЎ™ЎМ ўИўЕЎ≠ўЕўСЎѓ ЎІўДЎєЎ®ЎѓЎІўДўДўЗЎМ ўИЎ±ЎґўИЎІўЖ Ў≠ўЕЎ≤Ў©вАЭ.
ўЗўК ЎЈЎ±ўКўВЎ™ўЗ ўБўК ўЕўВЎІЎ±Ў®Ў© ЎІўДЎ£ўЕўИЎ±ЎМ ЎЃЎµўИЎµўЛЎІ Ў™ўДўГ ЎІўДЎ™ўК ўДўЕ Ў™ўПўЖЎђўОЎ≤ЎМ ўИўЕЎєЎ±ўИўБ ЎєўЖ вАЬЎ£Ў®ўК Ў±ЎґЎІвАЭ Ў£ўЖўСўЗ ўГЎЂўКЎ±ўЛЎІ ўЕЎІ ўКўИўВўСЎє ўВЎµЎІЎ¶ЎѓўЗ ўВЎ®ўКўД Ў£ўЖ ўКЎђЎ±ўК ЎєўДўКўЗЎІ ЎІўДЎ™ЎєЎѓўКўДЎІЎ™ ЎІўДўДЎІЎ≤ўЕЎ©ЎМ ўЕЎ≥ўДўСўЕўЛЎІ ЎІўДЎ£ўЕЎ± ўДўДўИўВЎ™. ўИЎ®ЎІўДЎ≠ЎѓўКЎЂ ЎєўЖ ЎІўДўИўВЎ™ЎМ ўГЎІўЖ ўЕЎ≠ўЕўСЎѓ ўКЎЃЎ™ЎµЎ± ЎєўЕўДўКўСЎ© ЎІўДЎІЎ™ўСЎµЎІўД Ў®Ў£ЎµЎѓўВЎІЎ¶ўЗЎМ ўДўДЎ™ўЖЎ≥ўКўВ ўБўК Ў•ЎђЎ±ЎІЎ° ўЕўВЎІЎ®ўДЎІЎ™ ўЕЎєўЗўЕ ўДўДЎµЎ≠ўБ ЎІўДЎ™ўК ўКЎ±ЎІЎ≥ўДўЗЎІЎМ ўБўКЎѓЎ®ўСЎђ Ў≠ўИЎІЎ±ЎІЎ™ ўЕЎєўЗўЕ ўЕўЖ ЎєўЖЎѓўКўСЎІЎ™ўЗЎМ ЎѓўИўЖ Ў£ўЖ ўКЎЈўДЎєўЗўЕ ЎєўДўЙ ЎІўДЎ£ўЕЎ±ЎМ ўБўЗўИ ўКЎєЎ±ўБ ўГўКўБ ўКўБўГўСЎ±ўИўЖЎМ ўИўЕЎІ ўЗўК ЎҐЎ±ЎІЎ§ўЗўЕ ўЕўЖ ўЗЎ∞ўЗ ЎІўДЎІЎіўГЎІўДўКўСЎ© Ў£ўИ Ў™ўДўГ. Ў≠ўКўЖ ўКЎіЎІўЗЎѓўИўЖ Ў≠ўИЎІЎ±ЎІЎ™ўЗўЕ Ў™ўДўГ ўБўК ЎІўДЎµЎ≠ўБЎМ ўКЎґЎ≠ўГўИўЖЎМ ўИўКЎ≥Ў™ўЕЎ™ЎєўИўЖ Ў®Ў•ЎђЎІЎ®ЎІЎ™ўЗўЕ ЎІўДЎєўЕўКўВЎ© ЎІўДЎ™ўК ўДўЕ ўКЎ®Ў∞ўДўИЎІ ЎђўЗЎѓўЛЎІ ўБўКўЗЎІ.
ўИЎѓЎІЎєЎІЎ™ ўЕЎґўЕЎ±Ў©
ўВЎ®ўКўД Ў®ўДўИЎЇўЗ Ў≥ўЖўС ЎІўДЎ≥Ў®ЎєўКўЖ Ў®ўИўВЎ™ ўВЎµўКЎ±ЎМ ЎєЎ±ўБ ЎµЎІЎ≠Ў® вАЬўВЎµЎІЎ¶Ўѓ ЎІўДўИЎ≠ЎіЎ©вАЭ Ў£ўЖўСўЗ ўЕЎµЎІЎ® Ў®ЎІўДЎ≥Ў±ЎЈЎІўЖЎМ ўИЎђЎ±ўСЎ® ЎІўДЎєўДЎІЎђ ЎІўДўГўКўЕўКЎІЎ¶ўКўС ўИўДўЕ ўКЎЈўВўЗЎМ ўБЎІўЕЎ™ўЖЎє ЎєўЖ Ў•ЎЈЎІўДЎ© ЎєўЕЎ±ўЗ Ў®ўЗЎ∞ЎІ ЎІўДўЕўВЎѓЎІЎ± ўЕўЖ ЎІўДЎ£ўДўЕ. ўЗўГЎ∞ЎІ Ў™ўИўБўСўК ЎІўДЎіЎІЎєЎ± ўКўИўЕ ЎІўДЎ£Ў±Ў®ЎєЎІЎ° ўБўК 23 ЎҐЎ∞ЎІЎ±/ ўЕЎІЎ±Ў≥ ЎІўДЎєЎІўЕ 2016ЎМ ЎєЎІЎ±ўБўЛЎІ Ў®ЎѓўЖўИўС Ў£ЎђўДўЗЎМ ўБўГЎІўЖЎ™ ЎђўДўС ўДўВЎІЎ°ЎІЎ™ўЗ ўБўК ЎІўДЎ£ЎіўЗЎ± ЎІўДЎ£ЎЃўКЎ±Ў© ЎєЎ®ЎІЎ±Ў© ЎєўЖ ўИЎѓЎІЎєЎІЎ™ ўЕЎґўЕЎ±Ў©.
ЎІўДЎЈЎІўЗўК
ўДЎІЎМ ўДўЕ ўКўДЎ™ўБЎ™ ўЕЎ≠ўЕўСЎѓ ЎІўДЎєЎ®ЎѓЎІўДўДўЗ ўДЎ™ЎѓўИўКўЖ Ў≥ўКЎ±Ў™ўЗЎМ ўЗўИ ЎІўДЎ∞ўК ЎєЎІЎі ўКўИўЕўКўСЎІЎ™ўЗ ЎЈўИўДўЛЎІ ўИЎєЎ±ЎґўЛЎІ ўИЎєўЕўВўЛЎІ. ўДЎ∞ўДўГ ўДўЕ ўЖЎєЎ±ўБ ўГЎЂўКЎ±ўЛЎІ ЎєўЖ Ў™ЎђЎ±Ў®Ў© Ў®ЎІЎ±ўКЎ≥ЎМ ўИўДўЕ ўКўЕўЖўЗЎђ Ў™ЎђЎ±Ў®Ў™ўЗ Ў®ўКўЖ ЎІўДЎµЎ≠ўБ ўИЎІўДўЕЎђўДўСЎІЎ™ЎМ ЎІўДўКЎ≥ЎІЎ±ўК ўЕўЖўЗЎІ ўИЎІўДўКўЕўКўЖўКЎМ ЎІўДўДЎ®ўЖЎІўЖўКўС ўИЎІўДЎєЎ±Ў®ўК. Ў≠ўГЎІўКЎІЎ™ Ў®ЎѓўСЎѓўЗЎІ Ў®ЎІўДЎ≥Ў±Ўѓ ўДўДЎ£ЎµЎѓўВЎІЎ° ЎєўДўЙ ЎЈЎІўИўДЎІЎ™ ЎІўДўЕўВЎІўЗўКЎМ Ў£ўИ Ў≠ўКўЖ ўГЎІўЖ ўКЎѓЎєўИўЗўЕ Ў•ўДўЙ Ў®ўКЎ™ўЗЎМ ўДўКўИўДўЕ ўДўЗўЕ ўЕЎІ ўДЎ∞ўС ўИЎЈЎІЎ® ўЕўЖ ЎµўЖЎє ўКЎѓўКўЗЎМ ўБЎІўДЎЈўЗўК ўЕўИўЗЎ®Ў© ўЕўЖ ўЕўИЎІўЗЎ®ўЗ ЎІўДЎ™ўК Ў£ЎђўЕЎє ЎєўДўКўЗЎІ ўЖЎѓўЕЎІЎ° ўЕЎ≠ўЕўСЎѓЎМ ўИўЗўИ ўКЎєЎ±ўБ Ў™ўЕЎІўЕўЛЎІ Ў£ўЖўСўЖЎІ ЎђўЕўКЎєўЖЎІ ўИЎђЎ®ЎІЎ™ Ў®ЎІЎ¶Ў™Ў© ЎєўДўЙ ўЕЎІЎ¶ЎѓЎ© ўЕўДЎІўГ ЎІўДўЕўИЎ™.

ўЕЎє ўИЎІўДЎѓўЗ ўИЎіўВўКўВЎ™ўКўЗ

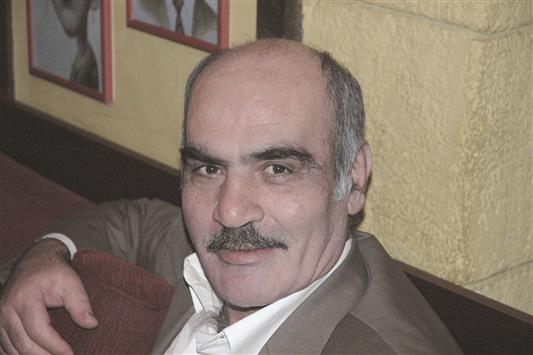
 ЎІўДЎЃўКЎІўЕ | khiyam.com
ЎІўДЎЃўКЎІўЕ | khiyam.com 











Ў™ЎєўДўКўВЎІЎ™: