
عرض عسكري لقوى الامن الداخلي
■ المنحازون إلى المستقبل يرتدون القناع فوق القناع لحماية موقعهم..
■ الحلّ عبر التزام القانون، وخصوصاً لجهة حظر تعاطي السياسة..
النظام الديموقراطي يتطلّب الشفافية، ويحقّ للناس أن يعرفوا ماذا يجري في المؤسسة الرسمية الرئيسية المعنية بأمنهم وسلامتهم. راقبت «الأخبار» تصرّفات ضباط قوى الأمن الداخلي منذ 2005، وتبين لها أن العلاقة بينهم تسيطر عليها أزمة ثقة. كذلك فإن المؤسسة تتآكلها الصراعات السياسية والمذهبية. أما تجاوزات قانون تنظيم قوى الأمن، فحدّث ولا حرج.
ثلاث سنوات مضت على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كانت كافية لنموّ كره عدد من ضباط الشرطة والدرك بعضهم لبعض إلى حدّ غير مسبوق دفعهم أحياناً إلى التعبير عن الخجل من وظيفتهم ومن بزّتهم العسكرية. ولم يكن الكره وليد غضب من تقصير أو إخفاق أو إهمال في مهام حماية رئيس الحكومة الأسبق، إذ إن تشخيص اغتياله بـ«جريمة العصر» مقصود به أنه لم يكن ممكناً منعها. وهذا الوصف الشائع متعارف عليه بين الضباط، رغم حال الارتباك التي أصابت بعضهم لحظة الجريمة.
ولم يكن الكره وليد حقبة سيطرة عنجر على مفاتيح الأمن في لبنان، إذ إن معظم الضباط كانوا على علاقة تواصل وصداقة وتبادل مع ضباط الجيش والأمن السوريين. ولا شكّ أن عدداً منهم لا يمانع في استعادة ذلك الماضي للاستقواء على الآخرين بنفوذ مصدره العلاقات المميّزة مع مسؤولين سوريين. ولعلّ رحيل مرجعية عنجر الأمنية والإدارية، وعدم إبدالها بسلطة قادرة على السيطرة قد زادا الاحتكاكات السلبية بين الضباط.
خلال ثلاث سنوات مضت، كان الصمت ميزة ما ابتُدِع من اجتماعات تنسيق بين الأمنيين، رغم كثرة الكلام. إذ إن جميع الضباط فضّلوا الاحتفاظ بما لديهم من معلومات لعدم ثقة الواحد منهم بالآخر، أو ليحصد وحده المكافآت السياسية والمذهبية المعلنة وغير المعلنة.
وفي الإطار نفسه، يتطلّب البحث عن أسباب المشكلة مراجعة تصنيف المؤسسات الأمنية طائفياً، ونظام المحاصصة السياسية في صفوف ضباط قوى الأمن ومجلس قيادتهم. ويتطلّب أيضاً قراءة في الشخصية المتكبّرة لبعض الضباط والثقة الذكورية والشوفينية بالنفس التي لا تزيد قيمتها أحياناً على استعراضات مسلّحين في مسرح الجريمة قبل حصولها وبعده.
بعد مراجعة دقيقة لتصرفات ضباط قوى الأمن، تبين لـ«الأخبار» أنهم يتوزّعون على الفئات الأربع الآتية:
■ الفئة الأولى: ترجمة للعواطف
منهم من أُصيب بصدمة إثر اغتيال الحريري لم تصبه يوم اغتيال الرئيس رشيد كرامي أو المفتي حسن خالد أو الرئيس بشير الجميّل أو الرئيس رينيه معوّض أو الزعيم كمال جنبلاط. خرج هؤلاء عن وظيفتهم، بحيث غلبت عواطفهم على مهنيتهم، إلى حدّ دفع بعضهم إلى الذوبان الكامل في عائلة الشهيد، تعاطفاً معها في مصابها.
وساعد جوّ التعاطف الجماهيري مع آل الحريري بعض الضباط في الانضمام إلى «ثورة الأرز». في طليعة هؤلاء كانت مجموعة من الضباط الحاقدين على عنجر لأسباب متعدّدة قد يكون بينها عدم تلبية القيّمين عليها مطالبهم. غير أن أغلبية الضباط المتعاطفين مع «ثورة الأرز» كانوا من الذين اعتقدوا أن «جريمة العصر» ستؤدي إلى انكفاء النفوذ السوري في لبنان. دعم هذا الاعتقاد الخاطئ انسحاب الجيش السوري في نيسان 2005 والإعجاب الأميركي والغربي، وحتى العربي، بإدانة القاضي ديتليف ميليس النظام السوري عبر تقاريره، من دون التنبّه إلى ضعف القيمة القانونية للأدلة التي كانت في حوزته.
وللتعمق في فهم هذه الفئة من الضباط، لا بد من التطرّق إلى وقع الصبغة المذهبية لردة الفعل على اغتيال الحريري في أوساط قوى الأمن. فهي المؤسسة المحسوبة على رئيس الحكومة السنّي في العرف اللبناني. غير أن بعض الضباط السنّة لم يتنبّهوا إلى حساسية هذا الشأن في نفوس الضبّاط الآخرين الذين لا يرضون اعتبارهم تابعين لمرجع مذهبي أو طائفي غير مراجعهم. وإثر انضمام مئات السياسيين من طوائف ومذاهب أخرى إلى دارة قريطم، لجأ بعض ضباط قوى الأمن غير السنّة بحذر، وبالسرّ أحياناً، إلى مرجعياتهم المذهبية والسياسية والمناطقية. وانطبق ذلك على ضباط لم يعتقدوا يوماً أن التركيبة المذهبية والطائفية ستدفعهم إلى الانحياز.
بين الضباط من تحمّس لنسف قرينة البراءة، ومن ترجم تلك الحماسة عبر القول علناً إن «سوريا قتلت الحريري» (حتى قبل انطلاق التحقيق الدولي) أو إن «الاستخبارات السورية كانت وراء جريمة عين علق». وساعد التصرّف اللامسؤول لوزير الداخلية في إيقاع الأذى بقوى الأمن عبر استباق المحكمة وإعلان إدانة أجهزة امنية سورية وهو ما لم يذكره القضاء في قراراته اللاحقة بهذه الجريمة. المكافآت التي وزّعت على بعض مَن قيل إنه استنتج علاقة الاستخبارات السورية بالاغتيالات كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير. إذ تبين للبعض أن المكافآت لم تكن مقابل عمل مهني، بل مقابل ما حافظ على شعبية تيار سياسي قرّر الإدانة قبل انعقاد المحكمة.
■ الفئة الثانية: حذر وتكتّم
الفئة الثانية من الضباط تتألف ممن لم يبال بردّة فعل الضباط وقرّر عدم التدخل. تعامل هؤلاء مع الموضوع بفتور، وكان بينهم عمداء استعجلوا موعد التقاعد.
غير أن بعض ضباط الفئة الثانية التحقوا بما أُطلق عليه اسم «شعبة المعلومات»، لكنهم لم يتنبهوا إلى رمزية المسمّى الجديد للفرع، أي التشابه مع ما كان يسمى «الشعبة الثانية». اعتقدوا أن السبيل الصحيح إلى تطوير قوى الأمن يكون عبر التركيز على دعم خلية مصغّرة يتمتّع العاملون فيها بالكفاءة المهنية والاستيعاب التقني الحديث. وبالفعل ارتكزت قوّة «المعلومات» على هؤلاء الضباط الذين لم تكن لديهم الخلفية العاطفية والنزعة المذهبية التي تميّز بها ضباط الفئة الأولى.
وخلال اجتماعات القيادة، التزم بعض الضباط الصمت وأحنوا رؤوسهم خشوعاً للشهيد الكبير أمام المقرّبين منه. ولكن كان لبعض الحوادث تأثير سلبي على رضوخ بعض الضباط المسيحيين والشيعة بشكل خاص للمناخ التعاطفي مع التيار السنّي. أهمّ تلك الأحداث ثلاثة: في شباط 2006 أوقعت أعمال شغب قام بها متظاهرون أصوليون سنّة أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصّة في منطقة الأشرفية التي تتميّز بانتماء معظم سكانها إلى الطوائف المسيحية. وعجزت قوى الأمن عن ضبط الوضع، لا بل تمكّن المتظاهرون من إلحاق أضرار بمطرانية الروم الأرثوذكس.
وأثناء عدوان تمّوز الإسرائيلي خلال صيف العام نفسه، عُرضت على شاشات التلفزيون صور ضابط رفيع في قوى الأمن يتعامل بودّ مع جنود إسرائيليين احتلوا ثكنة مرجعيون. رأى عدد كبير من اللبنانيين، ومن الجنوبيين خصوصاً، ذلك استفزازاً، لا بل خيانة. ووقعت بعد ذلك حادثة الرمل العالي التي شهدت إطلاق نار قوى الأمن على مواطنين، وأدّت إلى استشهاد طفلين من سكان منطقة تتميّز بانتماء غالبية سكانها إلى المذهب الشيعي.
الضباط الشيعة في قوى الأمن وجدوا أنفسهم في موقع لا يحسدون عليه. أما الضباط المسيحيون، ولا سيما الأرثوذكس، فلم تشف استقالة وزير الداخلية السني الشكلية غليلهم.
ردّة الفعل لم تكن راديكالية، بل اقتصرت على فتح قنوات تواصل بمرجعيات مذهبية وطائفية وسياسية. البرود والحذر بقيا سيّدي الموقف، لكن انطلقت مرحلة تسريب كلّ ما يدور في أروقة القيادة إلى التيارات السياسية.
■ الفئة الثالثة للأحزاب
بين ضباط قوى الأمن من تغنّى بـ«شطارته» في تحويل الشرطة إلى شعبة ثانية، ومن حاول بالقدر نفسه إخفاء انحيازه إلى أحزاب وتيارات سياسية عبر التقنع. ولم يسقط القناع بالكامل رغم احتدام التوتر بين الضباط. وأبت المراجع الحزبية الاعتراف بنفوذها علناً. ودخلت قوى الأمن اليوم مرحلة جديدة تفرض على بعض الضباط ارتداء أقنعة فوق الأقنعة أو خلع قناع كان قد ارتداه البعض لحماية موقعه.
عبّر ضباط خلال المرحلة السابقة عن رفضهم لبعض قرارات مجلس القيادة. وفي عدد من المناسبات، بلغ الضغط على القيادة للتراجع عن قراراتها حدّ القطيعة. ولعام ونصف عام، لم يحضر ثلاثة من كبار الضباط اجتماعات مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي. في المقابل، برز أحد الضباط كمتحدّث شبه رسمي لأحد التيارات، وبات يصوغ نصوص التسويات السياسية ويفاوض في شأنها.
أخيراً، بين الضباط من لا يُعرف إلى أي من الفئات الثلاث المذكورة ينتمي. فهو يحيّر زملاءه ويدهش رؤساءه بعدم حماسته لشيء. يؤدي عمله كما يُطلب منه تماماً. هذه الفئة من ضباط قوى الأمن عددها قليل، غير أن يأسها وحزنها عميقان حيال ما تعانيه المؤسسة من مشاكل وصراعات.
■ إعادة بناء المؤسّسة
إن التباغض في أوساط ضباط قوى الأمن لا يعالج بفرض المصالحة بينهم. ولا يداوى بتنازل فئة من الضباط لفئة منافسة. ولا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. لكن معالجة المشكلة تبدأ بتشخيصها جيداً وبالبحث الدقيق عن أسبابها. لا شكّ أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى شلّ مؤسسة الشرطة، هو أنها تعتمد على حكم الأشخاص ومزاجهم السياسي أو حتى الشخصي، لا على حكم النصّ الذي تحدد على أساسه الصلاحيات والواجبات والمحظورات.
إن أزمة الثقة القائمة بين الضباط لا يعالجها تشبث البعض بمواقفهم السابقة، بل باقتناع الجميع بأن قوى الأمن يفترض أن تكون مؤسسة، لا جهازاً أمنياً أو شعبة ثانية لخدمة تيار سياسي على حساب تيار آخر.
أوجاع مؤسّسة
المدير العام «يحبّ السياسة» كما يتّفق مقربون منه، وقائد الدرك غاضب من تجاوزات القانون، وفرع المعلومات يسعى رئيسه إلى التبرؤ من «المستقبل». أما مجلس القيادة، فهو أبتر بسبب انحياز الضباط فيه إلى قوى 14 آذار من جهة، وقوى 8 آذار من الجهة المقابلة. ضباط الحرس الحكومي وحرس مجلس النواب أوفياء لدولة الرئيسين أكثر من وفائهم للمؤسسة.
أضف إلى هذا، تبنّي قيادة قوى الأمن بدعة قانونية تتمثّل بوضع عشرات العمداء في التصرّف، ممّا يشكّل إهداراً للمال العام ولطاقات كان يمكن الإفادة منها.
 الخيام | khiyam.com
الخيام | khiyam.com 




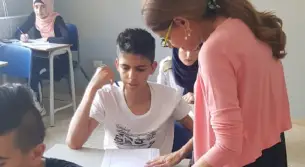






تعليقات: