
متى تتفقد بكركي رعاياها في دمشق بعدما تفقّدتهم في أرجاء الأرض، لا سيّما أن سوريا تكاد تتكلم الفرنسية بطلاقة لافتة اليوم بعد هجمة باريس ـــ ساركوزي الودية نحوها؟ وهل السياسيون اللبنانيون «الأربتعشيون» في إقبالهم اللافت على سوريا هم في مناخ الاستراتيجيا المتداولة والمستهلكة لدينا كمصطلحٍ شائع، أم هم في حمّى الانتخابات البرلمانية وقد انفرطت عقدة سبحتهم، فتشتتوا أيدي سبأ؟ الجنرال ميشال عون يتحضّر لزيارة دمشق قائلاً إن سوريا تعرف اللبنانيين جميعاً، وهو الوحيد الذي لم يعرفه السوريون. نعم الحق معه، لأن لبنان السياسي من الدرجات كلها، كان يقف بحياء وقلب مضطرب على باب اللواء غازي كنعان في عنجر في مواسم انتخابية كهذه وغيرها من المواسم الكبيرة والصغيرة. يحترم الجنرال نفسه فلا يزدوج بين قناعاته ولسانه، مع أن الألسنة المسلولة عليه تلقّم في الصالون السياسي المناهض ليل نهار. ولا نعلم من هو الصالون الذي خلع البصمات العسكرية من صوته، فباتوا يقولون «البطريرك» ميشال عون بات في دمشق. وحتى الدكتور سمير جعجع اقتدى به، وهو يتطلع إلى زيارة دمشق ويصرّح بالأمر، ثم أمين الجميل الذي يفتّش في شجرة العائلة عن أقاربه في طهران، جامعاً بذلك مصر وإيران برابط دموي، ناهيك عن التحولات التي تشهدها الساحة السياسية، بدءاً من لقاءات الدوحة التي تفرز حوارات ومصالحات وتدوير زوايا، أقلّ ما فيها وبعدها التداخل الحاصل بين 14 و8 آذار في لبنان الذي طالما خطف في صراعهما أنفاس اللبنانيين واهتمام العرب والعالم.
وإذا كان هذا المناخ المطبوخ طرياً، لضرورات خارجية وإقليمية، قد افتتحه الزعيم وليد جنبلاط الذي يمثّل اللاقط للإشارات السياسية وتحركات الرياح، وفي عزّ صراخه على الشام الذي لم يقنع الكثيرين من أنه مبطن بمحبة كبرى لدمشق، فإن المشهد السياسي المتبدل الذي عجن اللبنانيين بالسياسة وتقلباتها، يجعلنا نتذكّر الوجه الآخر للمشهد، ونعني به سوريا عاشقة السلوك الاستراتيجي والخطاب النادر تقديساً لقوة الدور، ونتذكّر بالتالي تلك الأغنية التي تقول: «الله حامي سوريا».
أغنية استلّها المطربون والملحنون في سوريا من قفلة لخطاب سياسي أطلقه الرئيس السوري الدكتور بشّار الأسد بثقةٍ عارمة، وسقطت في وجدان السوريين، دليلاً ساطعاً على الصلابة والصبر والتخطيط واقتناص اللحظات الدسمة والمفاجأة التي لطالما اختزنها المطبخ السياسي السوري.
لكنّ المطبخ السوري لا يعرف الارتجال في السياسة. يستعمل عقله في السياسة وينسى لسانه إلى حدّ كبير بخلاف الدول المنبرية مثل لبنان الذي يتقدّم فيه اللسان على التفكير وهو غير الفكر. التفكير ذاتي وموضوعي ووطني ومقبول أخطأ أم أصاب، بينما الفكر جاهز ومستورد ومطلوب، ومهدد بالتعثر والكوارث الوطنية ومرفوض، أخطأ أم أصاب. إنه الفرق بين القمح البلدي والقمح الصليبي، أو الفرق في لبنان في التمييز بين التغيير والغير.
وقد نتذكر مع عنوان هذه الأغنية المذكورة أحداثاً ثلاثة: الإطلالة السورية من ناحية الشمال اللبناني، أولاً، في تحرك عسكري لوجستي بات هو الحديث السائد في الصالونات السياسية المكشوفة والمخبوءة كما في وسائل الإعلام.
وقبلها، ثانياً، الهجمة السياسية العنيفة التي لم تعلن بكاملها على قصر بعبدا بعدما طلب الرئيس السوري في القمة اللبنانية ـــ السورية الأخيرة سدّ تلك الطاقة الشمالية في لبنان، وأعلن عنها في المؤتمر الصحافي الرباعي في دمشق. إلى المعزوفات اللبنانية الفائقة العدائية لسوريا ثالثاً، التي لا يمكن تصورها على الإطلاق، جاءت على ألسن مسيحيين أميركيين أو فرنسيين أو أجانب من أصول لبنانية جاؤوا للتمتع بفصل الصيف وبنوا ثقافاتهم ومواقفهم، كما يبدو، على برامج تلفزيونية لبنانية محددة، لطالما فتكت بالعلاقات السورية ـــ اللبنانية، كما بنوها على مواقف المرجعيات التي تفاخر بأنه لم تطأ أرض دمشق، أو التمثل بمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية من أصول لبنانية يفاخر بأنه بنى قصره من دون الاستعانة بعامل سوري.
لكن... إذا كانت اللوحة اللبنانية المتجددة حيال سوريا منهمكة بالهم الأساسي المتمثل بالانتخابات البرلمانية القريبة، أو نابعة من المرسوم الذي وقعه الدكتور بشار الأسد في العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا الذي قد يساوي إن لم يتجاوز في قيمته، التخلي عن لواء الإسكندرون لدى البعض أو عائدة إلى البروز السوري المتجدد في الشرق الأوسط وبإقرار إقليمي وغربي، أو هذه الأمور مجتمعةً، فإن تلك الجملة «الله حامي سوريا» المصحوبة بابتسامة أسدية، كانت تعني انقشاع غيوم الضغوط اللبنانية والإقليمية والدولية الهائلة التي تعرّضت لها دمشق، وهي لم تعرف حجمها الهائل منذ الاستقلال، قبل عبورها استراتيجياً نحو ضفة الارتياح.
ليس المطلوب تكرار الحبر في البلدين التوأمين سوريا ولبنان اللذين اختلطت دماؤهما، وناضلا معاً أساساً من أجل الاستقلال في وفد ضمّ المغفور لهما فارس الخوري وحميد فرنجية، وكلاهما من لبنان، واستمرت العلاقات في مجرى التاريخ والجغرافيا بأخطائها وصوابها: تقارب حتى الوله والاستجداء في طلب الوحدة بين البلدين من الفئات اللبنانية، مثل الأيام نداولها بين الناس، ورفض سوري قاطع، وتباعد حتى الجفاء والعداء والاستعداء والقطيعة والمناكدة.
ومن الحدود المفتوحة إلى الحدود المقفلة، كان يكفي اتصال من هنا أو هناك، وزيارة من هنا أو هناك لتعود العلاقات إلى الأفضل والأحسن.
ليس المطلوب تكرار الحبر في العلاقات السورية ـــ اللبنانية، بل استرجاع ما قاله صديق سياسي ماروني كبير، رحلة الحج الـ93 للبابا بولس السادس إلى سوريا، «درّة الشرق»، كما وصفها الحبر الأعظم بقوله في 8/5/2001: «أعي بعمق أنني أزور أرضاً عريقة لعبت دوراً حيوياً في تاريخ هذه المنطقة»، داعياً إلى «الالتزام بحوار يسوده الاحترام وعدم التصارع مرة أخرى... والاحترام المتبادل والتفاهم والسلام وإعطاء كل شعبٍ في المنطقة حقوقه المشروعة... من أجل الصفح المتبادل عن كل مرة أهان فيها طرف الآخر».
لم يكن مجرد مصادفة أن يشير قداسة البابا إلى أنه «على مرّ الأزمان، وخصوصاً في بداية القرن العشرين، تعرّضت مجموعات مسيحية عدّة للاضطهاد والعنف... وفي سوريا، وجدت هذه الجماعات ملجأً لها يعيشون فيه بأمنٍ وسلام». هل ننسى مسيحيي العراق في هذا المجال؟
نعم. من أثينا مروراً ببيروت فدمشق ثمّ مالطة، تقفّى البابا يوحنا بولس الثاني خطى بولس الرسول. زار الجامع الأموي الكبير في دمشق في أيار عام 2000، وعندما وقف أمام ضريح يوحنا المعمدان داخل الجامع، صفق له المسلمون مطلقين صرخات: الله أكبر. وكان أول حبر في التاريخ يدخل مسجداً. والغريب، أضاف الصديق الكبير، أن رأس الكنيسة المارونية في لبنان يومها، لم يرافق البابا إلى دمشق، مع أنه رعى المؤمنين المسيحيين في أرجاء الدنيا قاطبةً، وتفقدهم في جولاته الروحية والكنسية في خلال العقدين الغابرين. لم يتفقد رعيته في أرض الشام حتى الآن، مع أنّ الموارنة دلفوا تاريخياً من قرية الرستن (مركز قضاء الرستن في محافظة حمص) نحو جبل لبنان، وكان يمكن، لو حصل، أن تمتد السجادة الحمراء أمامه من المصنع إلى داخل دمشق. قلنا كان من الماضي لكن لا ننسى أخوات كان وفي طليعتهن فعل أصبح حيث القرابة الدموية بين الماضي والمستقبل في لسان العرب وكتب قواعد اللغة العربية.
لماذا تقفّى البابا طريق دمشق، سألت صديقي؟
لأن الكنيسة المارونية في لبنان، أجاب، أبت قطعاً العودة إلى جذورها في سوريا، ولم تلتفت في رحلاتها نحو الشرق، ولربّما امتعضت عندما أطلق رأس الكنيسة الكاثوليكية في لبنان البطريرك لحام مقولة «كنيسة العرب»، صدى فائق التعبير للإرشاد الرسولي، وعلى الرغم من كثرة الاتصالات واللقاءات والوساطات والمحاولات والاجتماعات، وعلى كل المستويات الكنسية والمدنية، إلى تعدد الوفود تحقيقاً لوصل الموارنة بحبل صرّتهم. فكانت زيارة البابا تشجيعاً على التواصل مع سوريا وإطلاق وصية تاريخية للفاتيكان بضرورة انخراط المسيحيين في المحيط العربي والإسلامي ثقافياً ولغوياً وسياسياً وعلى كل المستويات.
هذه هي سوريا، أضاف صديقي، منحها البابا منذ ذلك التاريخ، إقراراً من أعلى سلطة دينية مسيحية في العالم، جاء يعزز الدور الذي تلعبه كدولة استراتيجية في رعاية حوار الحضارات والديانات. وأضاف: «لا تتعب. كيفما مددت يديك نحو المجالس الدولية، أو المجالس العربية الجامعة، فإنك ستجد حضوراً سورياً في نهاية المطاف، وكل حلّ أو ربط كان أحد أطرافه القوية بيد دمشق».
* أستاذ جامعي
 الخيام | khiyam.com
الخيام | khiyam.com 









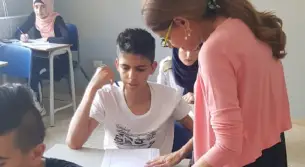

تعليقات: