
Ϻ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ® Ϻ┘äÏ│┘êÏ▒┘èÏ® ┘ä┘ä┘à┘éϺϬ┘ä┘è┘å Ϻ┘äÏúϼϺ┘åÏ¿: Ï¡Ï│ϺϿϺϬ Ϻ┘äÏú┘à┘å ┘êϺ┘äϬ┘â┘ä┘üÏ® Ϻ┘äϺϼϬ┘àϺÏ╣┘èÏ® (Getty)
Ϭ┘ÅÏ╣Ï» ┘àÏ│Ïú┘äÏ® Ϻ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ® ┘à┘å Ïú┘âϽÏ▒ Ϻ┘ä┘éÏÂϺ┘èϺ Ï¡Ï│ϺÏ│┘èÏ® ┘ü┘è Ϻ┘äÏ»┘ê┘ä Ϻ┘äϫϺÏ▒ϼϮ ┘à┘å Ϻ┘äÏ¡Ï▒┘êÏ¿ ┘êϺ┘ä┘åÏ▓ϺÏ╣ϺϬ. ┘ê┘àÏ╣ Ï¿Ï»Ïí ┘àÏ▒Ï¡┘äÏ® ÏÑÏ╣ϺϻϮ Ï¿┘åϺÏí Ϻ┘äÏ»┘ê┘äÏ® Ϻ┘äÏ│┘êÏ▒┘èÏ®Ïî ϬϿÏ▒Ï▓ ┘éÏÂ┘èÏ® Ϻ┘ä┘à┘éϺϬ┘ä┘è┘å Ϻ┘äÏúϼϺ┘åÏ¿ Ϻ┘äÏ░┘è┘å ┘à┘âϽ┘êϺ ┘ü┘è Ϻ┘äÏ¿┘äϺϻ ┘ä┘üϬÏ▒ϺϬ ÏÀ┘ê┘è┘äÏ® ┘êϬÏ▓┘êϼ┘êϺ Ï│┘êÏ▒┘èϺϬ ┘êÏú┘åϼϿ┘êϺ ÏúÏÀ┘üϺ┘äϺ┘ïÏî ┘âÏúÏ¡Ï» ÏúÏ╣┘éÏ» Ϻ┘ä┘à┘ä┘üϺϬ Ϻ┘äϬ┘è ϬϬÏ┤ϺϿ┘â ┘ü┘è┘çϺ Ϻ┘äÏúÏ¿Ï╣Ϻϻ Ϻ┘ä┘éϺ┘å┘ê┘å┘èÏ® ┘êϺ┘äϺϼϬ┘àϺÏ╣┘èÏ® ┘êϺ┘äÏú┘à┘å┘èÏ®.
Ϻ┘äÏ▒Ϫ┘èÏ│ Ϻ┘äÏ│┘êÏ▒┘èÏî ÏúÏ¡┘àÏ» Ϻ┘äÏ┤Ï▒Ï╣Ïî ÏÀÏ▒Ï¡ ┘àÏñÏ«Ï▒Ϻ┘ï ┘ü┘âÏ▒Ï® ┘à┘åÏ¡ Ϻ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ® ┘ä┘çÏñ┘äϺÏí Ϻ┘ä┘à┘éϺϬ┘ä┘è┘å ϿϻϺ┘üÏ╣ ÏÑ┘åÏ│Ϻ┘å┘è. Ï¡┘èϽ ┘èÏ▒┘ë Ïú┘å ÏÑÏ╣ϺϻϮ ϬÏ▒Ï¡┘è┘ä┘ç┘à ┘éÏ» ┘èÏ┤┘â┘ä Ï«ÏÀÏ▒Ϻ┘ï Ï╣┘ä┘ë Ï¡┘èϺϬ┘ç┘à ┘êÏ¡┘èϺϮ ÏúÏ│Ï▒┘ç┘àÏî ┘ü┘è Ï©┘ä Ϻ┘ä┘à┘äϺϡ┘éϺϬ Ϻ┘ä┘éÏÂϺϪ┘èÏ® Ϻ┘äϬ┘è ┘éÏ» ┘èϬÏ╣Ï▒ÏÂ┘ê┘å ┘ä┘çϺ. ┘ä┘â┘å ┘ç┘ä ┘è┘à┘â┘å ϺÏ╣ϬϿϺÏ▒ ┘çÏ░Ϻ Ϻ┘äÏÀÏ▒Ï¡ Ï«ÏÀ┘êÏ® ┘åÏ¡┘ê Ϻ┘äÏ╣ϻϺ┘äÏ® Ϻ┘äϺ┘åϬ┘éϺ┘ä┘èÏ®Ïî Ïú┘à Ïú┘å┘ç ┘éÏ▒ϺÏ▒ ┘àÏ¡┘ü┘ê┘ü ϿϺ┘ä┘àϫϺÏÀÏ▒ Ϻ┘äÏú┘à┘å┘èÏ® ┘êϺ┘ä┘éϺ┘å┘ê┘å┘èÏ® ┘ê┘éÏ» ┘è┘üϬϡ Ϻ┘äϿϺϿ Ïú┘àϺ┘à Ϭϡϻ┘èϺϬ ϼϻ┘èϻϮσ
Ϻ┘äϬϼÏ▒Ï¿Ï® Ϻ┘äÏ¿┘êÏ│┘å┘èÏ®
Ϭ┘éÏ»┘à Ϻ┘äϬϼÏ▒Ï¿Ï® Ϻ┘äÏ¿┘êÏ│┘å┘èÏ® ┘å┘à┘êÏ░ϼϺ┘ï ┘èÏ│Ϭϡ┘é Ϻ┘äϬÏú┘à┘äÏî ÏÑÏ░ Ï┤┘çϻϬ Ϻ┘äÏ¿┘äϺϻ Ϭϻ┘ü┘éϺ┘ï ┘ä┘ä┘à┘éϺϬ┘ä┘è┘å Ϻ┘äÏúϼϺ┘åÏ¿ Ï«┘äϺ┘ä Ϻ┘äÏ¡Ï▒Ï¿ Ϻ┘äÏú┘ç┘ä┘èÏ®Ïî Ï¡┘èϽ ┘éÏ»┘à┘êϺ ϬϡϬ Ï┤Ï╣ϺÏ▒ϺϬ Ϻ┘äϼ┘çϺϻ ┘êϺ┘äÏ»┘üϺÏ╣ Ï╣┘å Ϻ┘ä┘àÏ│┘ä┘à┘è┘å. Ï¿Ï╣Ï» Ϻ┘åϬ┘çϺÏí Ϻ┘ä┘åÏ▓ϺÏ╣Ïî ┘êϺϼ┘çϬ Ϻ┘äÏ¿┘êÏ│┘åÏ® ┘àÏ╣ÏÂ┘äÏ® ┘éϺ┘å┘ê┘å┘èÏ® ϬϬÏ╣┘ä┘é Ï¿┘êÏÂÏ╣ ┘çÏñ┘äϺÏí Ϻ┘ä┘à┘éϺϬ┘ä┘è┘å Ϻ┘äÏ░┘è┘å ϬÏ▓┘êϼ┘êϺ ┘êÏú┘åϼϿ┘êϺ ÏúÏÀ┘üϺ┘äϺ┘ï Ï╣┘ä┘ë ÏúÏ▒ϺÏÂ┘è┘çϺ.
┘ü┘è Ϻ┘äϿϻϺ┘èÏ®Ïî ┘à┘åϡϬ Ϻ┘äÏ│┘äÏÀϺϬ Ϻ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ® ┘ä┘äÏ¿Ï╣Ï Ͽ┘åϺÏí┘ï Ï╣┘ä┘ë Ï©Ï▒┘ê┘ü ϺÏ│ϬϽ┘åϺϪ┘èÏ®Ïî ┘ä┘â┘å Ï│Ï▒Ï╣Ϻ┘å ┘àϺ ϬÏ▒ϺϼÏ╣Ϭ Ï╣┘å ┘çÏ░┘ç Ϻ┘äÏ«ÏÀ┘êÏ® Ï¿Ï╣Ï» ϬÏÁϺÏ╣Ï» Ϻ┘äÏÂÏ║┘êÏÀ Ϻ┘äÏ»┘ê┘ä┘èÏ® ┘êϺϬ┘çϺ┘àϺϬ ϿϬÏ│┘ç┘è┘ä Ï¿┘éϺÏí "Ϻ┘äϼ┘çϺϻ┘è┘è┘å".
┘ê┘ü┘è Ï╣Ϻ┘à 2007Ïî ÏúÏÀ┘ä┘éϬ Ϻ┘äÏ¿┘êÏ│┘åÏ® Ï¡┘à┘äÏ® ┘êϺÏ│Ï╣Ï® ┘äÏ│Ï¡Ï¿ Ϻ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ® ┘à┘à┘å Ï¡ÏÁ┘ä┘êϺ Ï╣┘ä┘è┘çϺ Ï¿ÏÀÏ▒┘é Ï║┘èÏ▒ ┘éϺ┘å┘ê┘å┘èÏ®Ïî ┘àϺ ÏúÏ»┘ë ÏÑ┘ä┘ë ┘àÏ╣ϺÏ▒┘â ┘éϺ┘å┘ê┘å┘èÏ® ┘àÏ╣┘éϻϮ ϺÏ│Ϭ┘àÏ▒Ϭ Ï│┘å┘êϺϬ. ┘êÏ«┘äϺ┘ä Ϭ┘ä┘â Ϻ┘ä┘üϬÏ▒Ï®Ïî Ï¿Ï▒Ï▓Ϭ Ϻ┘åϬ┘éϺϻϺϬ Ï»┘ê┘ä┘èÏ® ϬϬ┘ç┘à Ϻ┘äÏ¡┘â┘ê┘àÏ® Ϻ┘äÏ¿┘êÏ│┘å┘èÏ® ϿϺ┘äϬÏ▒Ϻϫ┘è ┘ü┘è ┘à┘âϺ┘üÏ¡Ï® Ϻ┘äÏÑÏ▒┘çϺϿ ┘êϬÏ│┘ç┘è┘ä Ï¿┘éϺÏí Ïú┘üÏ▒Ϻϻ ┘èÏ┤┘â┘ä┘ê┘å Ϭ┘çÏ»┘èϻϺ┘ï ┘ä┘äÏú┘à┘å Ϻ┘äÏÑ┘é┘ä┘è┘à┘è. ┘ê┘ü┘è ┘å┘çϺ┘èÏ® Ϻ┘ä┘àÏÀϺ┘üÏî Ϭϡ┘ê┘äϬ ┘çÏ░┘ç Ϻ┘ä┘éÏÂ┘èÏ® ÏÑ┘ä┘ë ÏúÏ▓┘àÏ® ┘éϺ┘å┘ê┘å┘èÏ® ┘êÏÑ┘åÏ│Ϻ┘å┘èÏ® ϬϻϺϫ┘äϬ ┘ü┘è┘çϺ ÏúÏ¿Ï╣Ϻϻ Ϻ┘äÏú┘à┘å ┘êϺ┘äÏ│┘èϺϻϮ ┘êϺ┘äÏ¡┘é┘ê┘é Ϻ┘äÏÑ┘åÏ│Ϻ┘å┘èÏ®.
ϬÏñ┘âÏ» Ϭ┘ä┘â Ϻ┘äϬϼÏ▒Ï¿Ï® Ï╣┘ä┘ë Ïú┘å ┘éÏ▒ϺÏ▒ϺϬ ┘à┘åÏ¡ Ϻ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ® ┘ü┘è Ï│┘èϺ┘éϺϬ ┘àϺ Ï¿Ï╣Ï» Ϻ┘äÏ¡Ï▒Ï¿ ┘äϺ ┘èϼϿ Ïú┘å Ϭ┘â┘ê┘å ┘ê┘ä┘èϻϮ Ϻ┘äÏÂÏ║┘êÏÀ Ϻ┘äÏó┘å┘èÏ®Ïî Ï¿┘ä ┘èϼϿ Ïú┘å Ϭ┘ÅÏ¿┘å┘ë Ï╣┘ä┘ë ÏúÏ│Ï│ ┘éϺ┘å┘ê┘å┘èÏ® ┘àϬ┘è┘åÏ® ┘äϬϼ┘åÏ¿ Ϭϡ┘ê┘æ┘ä┘çϺ ÏÑ┘ä┘ë ┘é┘åÏ¿┘äÏ® ┘à┘ê┘é┘êϬϮ Ϭ┘çϻϻ Ϻ┘äÏú┘à┘å ┘êϺ┘äϺÏ│Ϭ┘éÏ▒ϺÏ▒.
Ï┤Ï▒┘êÏÀ ÏÁϺÏ▒┘àÏ®
┘ü┘è Ϻ┘äÏ│┘èϺ┘é Ϻ┘äÏ│┘êÏ▒┘èÏî ϬϽ┘èÏ▒ ┘àÏ│Ïú┘äÏ® Ϻ┘ä┘à┘éϺϬ┘ä┘è┘å Ϻ┘äÏúϼϺ┘åÏ¿ ϬÏ│ϺÏñ┘äϺϬ Ï¡┘ê┘ä Ϻ┘äÏÑÏÀϺÏ▒ Ϻ┘ä┘éϺ┘å┘ê┘å┘è Ϻ┘äÏ░┘è ┘è┘åÏ©┘à ┘à┘åÏ¡ Ϻ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ®. ┘ü┘àÏ╣Ï©┘à ┘çÏñ┘äϺÏí ϻϫ┘ä┘êϺ Ϻ┘äÏ¿┘äϺϻ Ï¿ÏÀÏ▒┘é Ï║┘èÏ▒ ┘éϺ┘å┘ê┘å┘èÏ® ┘êϺ┘åÏ«Ï▒ÏÀ┘êϺ ┘ü┘è ┘üÏÁϺϪ┘ä ┘àÏ│┘äÏ¡Ï® ┘àÏÁ┘å┘üÏ® Ï╣┘ä┘ë ┘é┘êϺϪ┘à Ϻ┘äÏÑÏ▒┘çϺϿ. ┘ü┘ç┘ä ┘à┘å Ϻ┘ä┘àÏ╣┘é┘ê┘ä Ïú┘å ┘è┘Å┘à┘åÏ¡┘êϺ Ϻ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ® Ï»┘ê┘å ┘àÏ▒ϺÏ╣ϺϮ Ϻ┘ä┘àϫϺÏÀÏ▒ Ϻ┘äÏú┘à┘å┘èÏ® ┘êϺ┘äϺϼϬ┘àϺÏ╣┘èÏ® ┘ü┘è Ϻ┘äÏ¿┘äϺϻ Ϻ┘äϬ┘è ϬÏ┤┘çÏ» Ϻ┘å┘éÏ│Ϻ┘àϺϬ ϡϺϻϮ ┘ü┘è ┘çÏ░Ϻ Ϻ┘äÏ│┘èϺ┘éσ ┘äϺ Ï│┘è┘àϺ Ïú┘å Ϻ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ® ┘ä┘èÏ│Ϭ ┘àϼÏ▒Ï» ┘êϽ┘è┘éÏ® Ϭ┘à┘åÏ¡ Ï¡┘é Ϻ┘äÏÑ┘éϺ┘àÏ® ┘êϺ┘äÏ╣┘à┘äÏî Ï¿┘ä ┘ç┘è Ï╣┘éÏ» ϺϼϬ┘àϺÏ╣┘è ┘èϬÏÂ┘à┘å Ï¡┘é┘ê┘éϺ┘ï ┘ê┘êϺϼϿϺϬ. ┘äÏ░┘ä┘âÏî ÏÑÏ░Ϻ ┘éÏ▒Ï▒Ϭ Ϻ┘äÏ»┘ê┘äÏ® Ϻ┘äÏ│┘êÏ▒┘èÏ® Ϻ┘ä┘àÏÂ┘è ┘éÏ»┘àϺ┘ï ┘ü┘è ┘çÏ░Ϻ Ϻ┘äϺϬϼϺ┘çÏî ┘è┘åÏ¿Ï║┘è ┘êÏÂÏ╣ Ï┤Ï▒┘êÏÀ ÏÁϺÏ▒┘àÏ® ϬÏ┤┘à┘ä ÏÑϽϿϺϬ Ï¡Ï│┘å Ϻ┘äÏ│┘èÏ▒Ï® ┘êϺ┘äÏ│┘ä┘ê┘âÏî ┘êϺ┘äÏ«┘ä┘ê ┘à┘å Ϻ┘äÏ│ϼ┘äϺϬ Ϻ┘äÏÑϼÏ▒Ϻ┘à┘èÏ®Ïî ┘êϺ┘äϺ┘äϬÏ▓Ϻ┘à ϿϺ┘ä┘é┘êϺ┘å┘è┘åÏî ┘êÏÑϽϿϺϬ Ϻ┘äÏ▒Ï║Ï¿Ï® ┘ü┘è Ϻ┘äϺ┘åÏ»┘àϺϼ ┘êϬ┘ü┘ç┘à Ϻ┘äϬ┘å┘êÏ╣ ┘êϺ┘äϬÏ╣ϻϻ ┘ü┘è Ϻ┘ä┘àϼϬ┘àÏ╣ Ϻ┘äÏ│┘êÏ▒┘è.
┘ä┘â┘å ÏÑÏ░Ϻ ┘âϺ┘å Ϻ┘ä┘à┘éϺϬ┘ä┘ê┘å Ϻ┘äÏúϼϺ┘åÏ¿ Ϻ┘äÏ░┘è┘å ϬÏ▓┘êϼ┘êϺ Ï│┘êÏ▒┘èϺϬ ┘èÏ│Ϭϡ┘é┘ê┘å Ϻ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ®Ïî ┘ü┘ä┘àϺÏ░Ϻ ┘äϺ ┘è┘àϬϻ ┘çÏ░Ϻ Ϻ┘äÏ¡┘é ┘äÏ┤Ï▒ϺϪϡ ÏúÏ«Ï▒┘ë ┘à┘ç┘àÏ┤Ï® ┘à┘åÏ░ Ï╣┘é┘êÏ»Ïî ┘àϽ┘ä Ϻ┘ä┘ü┘äÏ│ÏÀ┘è┘å┘è┘è┘å Ϻ┘äÏ│┘êÏ▒┘è┘è┘å Ϻ┘äÏ░┘è┘å ┘ê┘äÏ»┘êϺ ┘êϬÏ▒Ï¿┘êϺ ┘ü┘è Ϻ┘äÏ¿┘äϺϻ ┘ê┘äϺ ┘èÏ▓Ϻ┘ä┘ê┘å ┘è┘ÅÏ╣Ϻ┘à┘ä┘ê┘å ┘âÏúϼϺ┘åÏ¿. ÏÑ┘å Ϻ┘äϬÏ╣Ϻ┘à┘ä Ϻ┘äϺ┘åϬ┘éϺϪ┘è ┘ü┘è ┘çÏ░Ϻ Ϻ┘ä┘à┘ä┘ü ┘äϺ ┘èÏ╣┘âÏ│ ϺÏ▓Ï»┘êϺϼ┘èÏ® ┘ü┘è ϬÏÀÏ¿┘è┘é Ϻ┘ä┘éϺ┘å┘ê┘å ┘üÏ¡Ï│Ï¿Ïî Ï¿┘ä ┘èÏ╣Ï▓Ï▓ ┘à┘åϺϫ Ϻ┘äÏÑ┘éÏÁϺÏí ┘êϺ┘äÏÑϡϿϺÏÀ ┘äÏ»┘ë Ï┤Ï▒ϺϪϡ ┘àϼϬ┘àÏ╣┘èÏ® Ï╣Ϻ┘åϬ ┘à┘å Ϻ┘äϬ┘ç┘à┘èÏ┤.
┘ê┘ü┘è Ϻ┘ä┘ê┘éϬ Ϻ┘äÏ░┘è ┘èϬϡϻϽ ┘ü┘è┘ç Ϻ┘äÏ┤Ï▒Ï╣ Ï╣┘å Ï¡┘àϺ┘èÏ® Ϻ┘ä┘à┘éϺϬ┘ä┘è┘å Ϻ┘äÏúϼϺ┘åÏ¿ ┘à┘å ┘àϫϺÏÀÏ▒ Ϻ┘äϬÏ▒Ï¡┘è┘äÏî ┘èϬÏ║Ϻ┘ü┘ä Ï╣┘å ÏÂÏ▒┘êÏ▒Ï® Ï¡┘àϺ┘èÏ® Ϻ┘ä┘àϼϬ┘àÏ╣ Ϻ┘äÏ│┘êÏ▒┘è ┘à┘å Ϻ┘ä┘àϫϺÏÀÏ▒ Ϻ┘äÏú┘à┘å┘èÏ® Ϻ┘ä┘åϺϬϼϮ Ï╣┘å ÏÑÏ»┘àϺϼ Ïú┘üÏ▒Ϻϻ ϺÏ▒ϬϿÏÀ┘êϺ Ͽϼ┘àϺÏ╣ϺϬ ┘àÏ│┘äÏ¡Ï® ┘ü┘è ┘àÏñÏ│Ï│ϺϬ Ϻ┘äÏ»┘ê┘äÏ®. ┘ç┘åϺ ϬϿÏ▒Ï▓ ÏÂÏ▒┘êÏ▒Ï® ┘êÏÂÏ╣ ÏÂ┘êϺϿÏÀ ÏÁϺÏ▒┘àÏ® ┘ä┘äϺ┘åϬÏ│ϺϿ ÏÑ┘ä┘ë Ϻ┘ä┘êÏ▓ϺÏ▒ϺϬ Ϻ┘äÏ│┘èϺϻ┘èÏ® ┘âϺ┘äÏ»┘üϺÏ╣ ┘êϺ┘äϻϺϫ┘ä┘èÏ®Ïî ┘àÏ╣ Ϭϡϻ┘èÏ» ┘üϬÏ▒Ï® Ï▓┘à┘å┘èÏ® Ï¿┘è┘å Ï¡ÏÁ┘ê┘ä Ϻ┘ä┘üÏ▒Ï» Ï╣┘ä┘ë Ϻ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ® ┘êÏ¿┘è┘å Ϻ┘äÏ¡┘é ┘ü┘è Ϻ┘äϺ┘åÏÂ┘àϺ┘à ┘äϬ┘ä┘â Ϻ┘ä┘àÏñÏ│Ï│ϺϬÏî ┘êϺÏ┤ϬÏ▒ϺÏÀ Ï«┘ä┘ê Ϻ┘äÏ│ϼ┘ä ┘à┘å Ïú┘è ϺÏ▒ϬϿϺÏÀϺϬ Ͽϼ┘àϺÏ╣ϺϬ ┘àÏ│┘äÏ¡Ï®.
Ϻ┘äÏ╣ϻϺ┘äÏ® Ϻ┘äϺ┘åϬ┘éϺ┘ä┘èÏ®
Ïú┘àϺ Ϻ┘ä┘à┘ä┘ü Ϻ┘äÏúÏ«ÏÀÏ▒Ïî ┘ü┘ç┘ê Ϻ┘äÏ╣ϻϺ┘äÏ® Ϻ┘äϺ┘åϬ┘éϺ┘ä┘èÏ®. ÏÑÏ░Ϻ ┘âϺ┘å Ϻ┘ä┘çÏ»┘ü ┘à┘å Ϻ┘äϬϼ┘å┘èÏ│ ┘ç┘ê Ϭϡ┘é┘è┘é Ϻ┘äÏ╣ϻϺ┘äÏ® ┘êϬϼ┘åÏ¿ Ϻ┘äÏ╣┘å┘ü Ϻ┘ä┘àÏ│Ϭ┘éÏ¿┘ä┘èÏî ┘ü┘äϺ Ï¿Ï» Ïú┘å ϬÏ┤┘à┘ä Ϻ┘ä┘àϡϺÏ│Ï¿Ï® ┘â┘ä ┘à┘å Ϭ┘êÏ▒ÏÀ ┘ü┘è ÏÑÏ▒Ϻ┘éÏ® Ï»┘àϺÏí Ϻ┘äÏ│┘êÏ▒┘è┘è┘åÏî Ï│┘êϺÏí ┘âϺ┘å Ïúϼ┘åÏ¿┘èϺ┘ï Ïú┘ê Ï│┘êÏ▒┘èϺ┘ïÏî ϬϺϿÏ╣Ϻ┘ï ┘ä┘ä┘åϩϺ┘à Ïú┘ê ┘ä┘ä┘àÏ╣ϺÏ▒ÏÂÏ®.
┘â┘àϺ ┘äϺ ┘èϼ┘êÏ▓ Ïú┘å ┘èϬϡ┘ê┘ä Ϻ┘äÏ«ÏÀϺϿ ÏÑ┘ä┘ë ϺÏ│Ϭ┘çϻϺ┘ü Ϻ┘ä┘à┘éϺϬ┘ä┘è┘å Ϻ┘äÏúϼϺ┘åÏ¿ Ï¡ÏÁÏ▒┘èϺ┘ïÏî Ï¿┘ä ┘èϼϿ Ϻ┘äϬÏ╣Ϻ┘à┘ä ┘àÏ╣ ┘à┘ä┘ü Ϻ┘äϼÏ▒ϺϪ┘à Ï¿┘àÏ╣Ϻ┘è┘èÏ▒ ┘éϺ┘å┘ê┘å┘èÏ® Ï┤Ϻ┘à┘äÏ®Ïî Ϭ┘åÏ©Ï▒ ÏÑ┘ä┘ë Ϻ┘äϼÏ▒┘è┘àÏ® ┘âϼÏ▒┘è┘àÏ®Ïî Ï¿Ï║Ï Ϻ┘ä┘åÏ©Ï▒ Ï╣┘å ϼ┘åÏ│┘èÏ® Ϻ┘ä┘üϺÏ╣┘ä Ïú┘ê Ϻ┘åϬ┘àϺϪ┘ç.
┘ü┘è Ϻ┘ä┘å┘çϺ┘èÏ®Ïî ÏÑ┘å ┘à┘åÏ¡ Ϻ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ® Ϻ┘äÏ│┘êÏ▒┘èÏ® ┘ä┘ä┘à┘éϺϬ┘ä┘è┘å Ϻ┘äÏúϼϺ┘åÏ¿ ┘ä┘èÏ│ ┘éÏ▒ϺÏ▒Ϻ┘ï Ï¿Ï│┘èÏÀϺ┘ï ┘è┘à┘â┘å ϺϬϫϺÏ░┘ç ϿϻϺ┘üÏ╣ Ϻ┘äÏ▒Ï¡┘àÏ® Ïú┘ê ϬϡϬ ÏÂÏ║ÏÀ Ϻ┘äÏ©Ï▒┘ê┘ü Ϻ┘äÏó┘å┘èÏ®Ïî Ï¿┘ä ┘ç┘ê ┘éÏ▒ϺÏ▒ Ï│┘èϺϻ┘è ┘èϬÏÀ┘äÏ¿ ┘àÏ▒ϺϼÏ╣Ï® Ï┤Ϻ┘à┘äÏ® ┘ä┘à┘åÏ©┘ê┘àÏ® Ϻ┘ä┘é┘êϺ┘å┘è┘å Ϻ┘ä┘àϬÏ╣┘ä┘éÏ® ϿϺ┘äϼ┘åÏ│┘èÏ® ┘êϺ┘äÏÑ┘éϺ┘àÏ®Ïî ┘àÏ╣ ┘àÏ▒ϺÏ╣ϺϮ ┘àÏÁ┘äÏ¡Ï® Ϻ┘ä┘àϼϬ┘àÏ╣ Ϻ┘äÏ│┘êÏ▒┘è Ïú┘ê┘äϺ┘ïÏî Ï»┘ê┘å ÏÑÏ║┘üϺ┘ä Ϻ┘äÏ¡┘é┘ê┘é Ϻ┘äÏÑ┘åÏ│Ϻ┘å┘èÏ® ┘ä┘ä┘à┘é┘è┘à┘è┘å.
Ϻ┘ä┘àÏÀ┘ä┘êÏ¿ ┘ä┘èÏ│ ┘àϼÏ▒Ï» Ï│┘å ┘é┘êϺ┘å┘è┘å ϼϻ┘èϻϮÏî Ï¿┘ä Ï¿┘åϺÏí Ï╣┘éÏ» ϺϼϬ┘àϺÏ╣┘è ϼϻ┘èÏ» ┘è┘é┘ê┘à Ï╣┘ä┘ë ┘é┘êϺÏ╣Ï» Ϻ┘äÏ╣ϻϺ┘äÏ® ┘êϺ┘ä┘àÏ│Ϻ┘êϺϮÏî ┘ê┘èÏÂÏ╣ ÏúÏ│Ï│Ϻ┘ï ┘éϺ┘å┘ê┘å┘èÏ® ┘êϺÏÂÏ¡Ï® ┘ä┘äϬϼ┘å┘èÏ│Ïî ┘ê┘èÏÂ┘à┘å ┘ü┘è Ϻ┘ä┘ê┘éϬ Ï░ϺϬ┘ç Ï¡┘àϺ┘èÏ® Ϻ┘ä┘àϼϬ┘àÏ╣ ┘à┘å Ϻ┘äϺ┘åÏ▓┘äϺ┘é ┘åÏ¡┘ê Ϻ┘ä┘ü┘êÏÂ┘ë Ϻ┘äÏú┘à┘å┘èÏ® ┘êϺ┘äϺϼϬ┘àϺÏ╣┘èÏ®.
 Ϻ┘äÏ«┘èϺ┘à | khiyam.com
Ϻ┘äÏ«┘èϺ┘à | khiyam.com 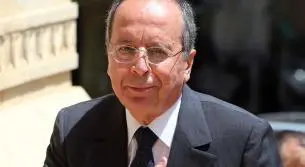








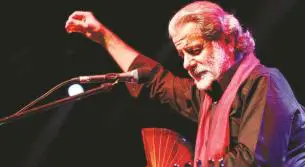


ϬÏ╣┘ä┘è┘éϺϬ: