
ž¦┘䞣┘Ŗž¦ž® ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģ┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ž│┘łž▒┘Ŗž¦ ┘łž▒ž¼ž¦┘ä ž¦┘äž┤ž▒žĘž® - ┘Ŗž│ž¬žĄž»ž▒ ž╣┘éž» ž¦┘äž▓┘łž¦ž¼ ž¦┘ä┘ł┘ć┘ģ┘Ŗ ž©┘ģž│ž¦ž╣ž»ž® ž©ž╣žČ ┘ģž╣┘éž©┘Ŗ ž¦┘ä┘ģž╣ž¦┘ģ┘䞦ž¬ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘鞥ž▒ ž¦┘äž╣ž»┘ä┘Ŗ (Getty)
ž╣ž¦┘ģ 2017žī ┘āž¦┘垬 ž¦┘ä┘éž©žČž® ž¦┘䞯┘ģ┘å┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ž│┘łž▒┘Ŗž® ┘éž» ž©┘äž║ž¬ ž░ž▒┘łž¬┘枦. ┘ā┘ä ž¬┘üžĄ┘Ŗ┘ä ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞣┘Ŗž¦ž® ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģ┘Ŗž® ┘āž¦┘å ┘Ŗ┘ģž▒ ž╣ž©ž▒ ž©┘łž¦ž©ž® ž¦┘ä┘ģž▒ž¦┘éž©ž® ┘łž¦┘䞦ž┤ž¬ž©ž¦┘ć. žŁž¬┘ē ž¦ž│ž¬ž”ž¼ž¦ž▒ ž┤┘éž® žĄž║┘Ŗž▒ž® ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å ┘ģž│žŻ┘äž® ž╣ž¦ž»┘Ŗž®žī ž©┘ä ž▒žŁ┘äž® žźž¼ž©ž¦ž▒┘Ŗž® žź┘ä┘ē žŻž▒┘ł┘éž® ž¦┘ä┘üž▒┘łž╣ ž¦┘䞯┘ģ┘å┘Ŗž®. ┘ć┘垦┘āžī žŁ┘Ŗž½ ž¬ž©ž»žŻ ž¦┘䞯ž│ž”┘äž® ┘ģ┘å ž¦┘ä┘łž▒┘é ┘ł┘䞦 ž¬┘垬┘ć┘Ŗ žź┘䞦 ž╣┘åž» ž¼ž░┘łž▒ ž¦┘äž╣ž¦ž”┘äž®. ž╣┘ä┘Ŗ┘ā žŻ┘å ž¬┘ģ┘䞯 ž¦ž│ž¬┘ģž¦ž▒ž® ┘䞦 ž¬┘āž¬┘ü┘Ŗ ž©ž¦ž│┘ģ┘ā ┘ł┘ģ┘ć┘垬┘āžī ž©┘ä ž¬┘ģž¬ž» žź┘ä┘ē ž¦┘䞯ž¼ž»ž¦ž» ┘łž¦┘䞯ž╣┘ģž¦┘ģ ┘łž¦┘䞯ž«┘łž¦┘äžī ┘łž¦┘垬┘ģž¦žĪž¦ž¬┘ć┘ģ ž¦┘䞣ž▓ž©┘Ŗž® ┘łž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®žī ┘ł┘ģ┘å ž│┘Ŗ┘éžĘ┘å ┘ģž╣┘ā ž¬žŁž¬ ž¦┘äž│┘é┘ü ž░ž¦ž¬┘ć. ┘ł┘āžŻ┘å ž¦ž│ž¬ž”ž¼ž¦ž▒ ž║ž▒┘üž® ┘Ŗž╣┘å┘Ŗ ž©ž¦┘äžČž▒┘łž▒ž® žźž╣┘䞦┘å ž¬ž¦ž▒┘Ŗž«┘ā ž¦┘äž╣ž¦ž”┘ä┘Ŗ žŻ┘ģž¦┘ģ ž│┘äžĘž® ž¬┘üž¬ž┤ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ģž¦žČ┘Ŗ ┘éž©┘ä žŻ┘å ž¬ž│┘ģžŁ ┘ä┘ā ž©ž¦┘äž╣┘Ŗž┤ ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞣ž¦žČž▒.
žŻž┤ž©ž¦žŁ ž¦┘ä┘ģž¦žČ┘Ŗ
┘ü┘Ŗ ž░┘ä┘ā ž¦┘ä┘ģ┘āž¬ž© ž¦┘äžČ┘Ŗ┘éžī ž▒┘ģ┘ē žŻžŁž» ž╣┘垦žĄž▒ ž¦┘䞯┘ģ┘å ž│žżž¦┘ä┘ć ┘ü┘Ŗ ┘łž¼┘ć┘Ŗ ž©ž©ž▒┘łž»: "ž╣┘ģ┘ā ┘āž¦┘å ž┤┘Ŗ┘łž╣┘Ŗž¦┘ŗžī ┘ģ┘ł ┘ć┘Ŗ┘āž¤"
┘āž¦┘å ž¦┘äž│žżž¦┘ä žŻ┘éž▒ž© žź┘ä┘ē ┘üž«┘æ ┘ģ┘å┘ć žź┘ä┘ē ž¦ž│ž¬┘üž│ž¦ž▒. ┘ü┘Ŗ ┘䞣žĖž® ┘鞥┘Ŗž▒ž® ž¬┘āž»┘æž│ ž»ž¦ž«┘ä┘Ŗ žĄž▒ž¦ž╣ ┘ģž▒┘Ŗž▒: ┘ć┘ä žŻ┘Å┘å┘āž▒ ž¬ž¦ž▒┘Ŗž« ž╣┘ģ┘Ŗ ž¦┘ä┘åžČž¦┘ä┘Ŗ ┘䞯žŁžĄ┘ä ž╣┘ä┘ē ž┤┘éž® žŻž│┘ā┘å┘枦žī žŻ┘ģ žŻ┘łž¦ž¼┘ć ž¦┘䞣┘é┘Ŗ┘éž® ┘łžŻž¼ž¦ž▓┘ü ž©žŻ┘å žŻž©┘é┘ē ┘ģž┤ž▒┘æž»ž®ž¤ ┘ć┘ä ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å žŻ┘å ┘Ŗž¬žŁ┘ł┘æ┘ä žźž▒ž½ ž▒ž¼┘ä ┘éžČ┘ē ž│┘å┘łž¦ž¬ ┘ģ┘å žŁ┘Ŗž¦ž¬┘ć ž©┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘āž¬ž© žź┘ä┘ē ž╣┘éž©ž® ┘ü┘Ŗ ┘łž¼┘ć ž│┘ā┘å ┘ģžż┘鞬ž¤
┘éž▒ž▒ž¬ žŻ┘å žŻ┘åžĄ┘ü ž╣┘ģ┘Ŗ. ┘é┘䞬 "┘åž╣┘ģ" ž©žĄ┘łž¬ ž©ž»ž¦ ┘ä┘Ŗ žŻž┤ž©┘ć ž©žźž╣┘䞦┘å ┘ł┘䞦žĪ ┘ä┘䞬ž¦ž▒┘Ŗž« žŻ┘āž½ž▒ ┘ģ┘å┘ć žźž¼ž¦ž©ž® ž╣┘ä┘ē ž¦ž│ž¬ž¼┘łž¦ž©. ┘āž¦┘å ┘łž¦žČžŁž¦┘ŗ žŻ┘å ž¦┘äž╣┘åžĄž▒ ┘Ŗž╣ž▒┘ü ž¦┘äž¼┘łž¦ž© ┘ģž│ž©┘鞦┘ŗžī ┘Ŗž╣ž▒┘ü ž¬┘üž¦žĄ┘Ŗ┘ä ž╣ž¦ž”┘䞬┘Ŗ ┘ā┘ģž¦ ┘Ŗž╣ž▒┘ü ž¬┘üž¦žĄ┘Ŗ┘ä žŁ┘Ŗž¦ž® žó┘䞦┘ü ž¦┘äž│┘łž▒┘Ŗ┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘ģ┘łž▓ž╣┘Ŗ┘å ž©┘Ŗ┘å ┘ģ┘ä┘üž¦ž¬ ┘łžŻžČž¦ž©┘Ŗž▒. ┘ł┘ģž╣ ž░┘ä┘āžī žĖ┘ä ž¦┘äž│žżž¦┘ä ┘ģž╣┘ä┘鞦┘ŗ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ć┘łž¦žĪ: ┘ģž¦ ž¦┘äž╣┘䞦┘éž® ž©┘Ŗ┘å ž¦┘垬┘ģž¦žĪ žŁž▓ž©┘Ŗ ┘ģžČ┘ē ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ž╣┘é┘łž»žī ┘łž©┘Ŗ┘å žŁ┘é┘Ŗ ┘ü┘Ŗ ž¦ž│ž¬ž”ž¼ž¦ž▒ ž┤┘éž®ž¤
ž¬žŻ┘ģ┘ä┘å┘Ŗ ž¦┘äž▒ž¼┘ä žĘ┘ł┘Ŗ┘䞦┘ŗžī ž½┘ģ ž¦┘鞬ž▒ž© ┘ł┘ć┘ģž│ ┘ł┘āžŻ┘å┘ć ┘Ŗ┘āž┤┘ü ž│ž▒ž¦┘ŗ: "ž»ž«┘ä┘āŌĆ” ž┤┘ł ┘Ŗž╣┘å┘Ŗ ž┤┘Ŗ┘łž╣┘Ŗž¤"
┘āž¦┘垬 ž¦┘ä┘ģ┘üž¦ž▒┘éž® ┘鞦ž│┘Ŗž®: ž│┘äžĘž® ž¬žŁž¦ž│ž©┘ā ž╣┘ä┘ē žźž▒ž½ ž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗ ┘䞦 ž¬┘ü┘ć┘ģ┘ćžī ┘ł┘ģ┘łžĖ┘ü ┘ŖžŁ┘é┘é ┘ģž╣┘ā ž©ž¦ž│┘ģ ž¦┘䞬ž¦ž▒┘Ŗž« ┘ł┘ć┘ł ┘䞦 ┘Ŗ┘ģ┘ä┘ā žŻž»┘å┘ē ┘ģž╣ž▒┘üž® ž©┘ģž╣┘垦┘ć ┘ģž¬┘垦ž│┘Ŗž¦┘ŗ žŻ┘å┘ā ž╣┘åž»┘ģž¦ ž¬žĘž╣┘å ž¦┘䞬ž¦ž▒┘Ŗž« ┘ü┘Ŗ ž«ž¦žĄž▒ž¬┘ć ž│┘Ŗž©ž¬┘äž╣┘ā ž¦┘䞣ž¦žČž▒.. ┘䞣žĖž¬┘枦 žŻž»ž▒┘āž¬ žŻ┘å ž¦┘äž«┘ł┘ü ┘ü┘Ŗ ž│┘łž▒┘Ŗž® ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å ┘ģž▒ž¬ž©žĘ┘ŗž¦ ┘ü┘éžĘ ž©ž¦┘äž▒┘鞦ž©ž®žī ž©┘ä ž©ž╣ž©ž½┘Ŗž® ┘ćž░┘ć ž¦┘äž▒┘鞦ž©ž® ┘å┘üž│┘枦žø ┘ģž▒ž¦┘éž©ž® ž¬ž│ž¬ž»ž╣┘Ŗ žŻž┤ž©ž¦žŁ ž¦┘ä┘ģž¦žČ┘Ŗ ž»┘ł┘å žŻ┘å ž¬┘ü┘ć┘ģ┘枦žī ┘łž¬ž│ž¬ž╣┘ģ┘ä┘枦 žŻž»ž¦ž® ┘äžźž░┘䞦┘ä ž¦┘䞣ž¦žČž▒.
┘ä┘ģ ž¬┘ā┘å ž¦┘ä┘łž▒žĘž® ┘ü┘Ŗ ┘ģž¼ž▒ž» ž¦┘ä┘ł┘é┘ł┘ü žŻ┘ģž¦┘ģ ž╣┘åžĄž▒ žŻ┘ģ┘å ┘Ŗž│žŻ┘ä ┘ł┘Ŗž»┘ł┘æ┘åžī ž©┘ä ┘ü┘Ŗ žźž»ž▒ž¦┘ā žŻ┘å ┘ģ┘å ┘Ŗ┘ģž│┘ā ž¦┘ä┘é┘ä┘ģ ┘䞦 ┘Ŗž¼┘Ŗž» žŁž¬┘ē ž¦┘ä┘āž¬ž¦ž©ž®. ┘ā┘垬 žŻž▒ž¦┘éž© ž¦ž▒ž¬ž©ž¦┘ā┘ć ┘ģž╣ ž¦┘䞣ž▒┘ł┘üžī ┘łžŻž┤ž╣ž▒ žŻ┘å ┘ā┘ä ┘ā┘ä┘ģž® žŻ┘é┘ł┘ä┘枦 ┘éž» ž¬┘Åž¬ž▒ž¼┘ģ ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘łž▒┘é ┘ģž┤┘ł┘æ┘ćž®žī ┘ä┘ā┘å┘枦 ┘ģž╣ ž░┘ä┘ā ž│ž¬ž¬žŁ┘ł┘æ┘ä žź┘ä┘ē ž¼ž▓žĪ ┘ģ┘å ┘ģ┘ä┘ü žŻ┘ģ┘å┘Ŗ ┘éž» ┘Ŗ┘䞦ž▓┘ģ┘å┘Ŗ ┘äž│┘å┘łž¦ž¬. ž┤ž╣ž▒ž¬ žŻ┘å┘å┘Ŗ ┘äž│ž¬ žŻ┘ģž¦┘ģ ┘ģ┘łžĖ┘ü ┘Ŗž»┘ł┘æ┘å ž┤┘ā┘ł┘ē žŻ┘ł žĘ┘äž©┘ŗž¦žī ž©┘ä žŻ┘ģž¦┘ģ ž│┘äžĘž® ž╣┘ģ┘Ŗž¦žĪ ┘䞦 ž¬┘ü┘ć┘ģ ž¬┘ģž¦┘ģ┘ŗž¦ ┘ģž¦ ž¬┘āž¬ž©žī ┘ä┘ā┘å┘枦 ž¬žĄž▒┘æ ž╣┘ä┘ē žŻ┘å ┘ģž¦ ž¬┘āž¬ž©┘ć ┘ć┘ł ž¦┘䞣┘é┘Ŗ┘éž® ž¦┘ä┘ģžĘ┘ä┘éž®.
žŁž¦┘ł┘䞬 žŻ┘å žŻ┘Åž«┘ü┘ü ┘ģ┘å žŁž»ž® ž¦┘ä┘ģ┘ł┘é┘üžī ┘ü┘é┘䞬 ┘ä┘ć žź┘å ž░┘ä┘ā ž¦┘䞣ž▓ž© ž¦┘äž░┘Ŗ žŻž┤ž¦ž▒ žź┘ä┘Ŗ┘ć ┘ä┘ģ ┘Ŗž╣ž» ┘ä┘ć žŻ┘Ŗ ┘łž¼┘łž» ┘Ŗ┘Åž░┘āž▒žī ┘łžź┘å ž¦┘ä┘łž¦┘éž╣ ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģ ┘ģžŁ┘ā┘ł┘ģ ž©žŁž▓ž© ž¦┘äž©ž╣ž½žī ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžĘž▒ ┘łž¦┘ä┘łžŁ┘Ŗž». ž©ž»ž¦ ┘ł┘āžŻ┘å┘å┘Ŗ žŻ┘éž»┘æ┘ģ ┘ä┘ć ž©ž»┘Ŗ┘ć┘Ŗž¦ž¬ ┘Ŗž╣ž▒┘ü┘枦 ž¦┘äž¼┘ģ┘Ŗž╣žī ┘ä┘ā┘å┘ć ž¦ž│ž¬┘ģž╣ ž©žź┘ģž╣ž¦┘å ž½┘ģ ž¦ž©ž¬ž│┘ģ ž¦ž©ž¬ž│ž¦┘ģž® ž║ž¦┘ģžČž®žī ┘ł┘āžŻ┘å ž¦┘䞯┘ģž▒ ┘䞦 ┘Ŗž¬ž╣┘ä┘é ž©žĄž»┘é ┘é┘ł┘ä┘Ŗžī ž©┘ä ž©ž¬ž│ž¼┘Ŗ┘ä ž¦ž╣ž¬ž▒ž¦┘ü┘Ŗ ž©žĘž▒┘Ŗ┘éž® ┘ģž¦.
žŻ┘å┘ć┘ē ž¦┘äž¼┘äž│ž® ž©ž╣ž©ž¦ž▒ž® ┘ģ┘āž▒┘æž▒ž® ž¦ž╣ž¬ž¦ž» ž¦┘äž│┘łž▒┘Ŗ┘ł┘å ž│┘ģž¦ž╣┘枦: "ž▒ž¦ž¼ž╣┘Ŗ┘垦 ž©ž╣ž» žŻž│ž©┘łž╣." ž½┘ģ žŻžČž¦┘ü ž¬┘łžČ┘ŖžŁ┘ŗž¦ ž©┘ä┘ćž¼ž® ┘ģ┘å ┘Ŗ┘éž»┘æ┘ģ ┘åžĄ┘ŖžŁž®žī ┘䞦 ž¬┘ćž»┘Ŗž»ž¦┘ŗ: "ž¦┘äžźž¼ž▒ž¦žĪ žČž▒┘łž▒┘ŖŌĆ” ┘ü┘Ŗ ž«┘䞦┘Ŗž¦ ┘垦ž”┘ģž® ž©ž¬ž│ž¬žŻž¼ž▒ ž©┘Ŗ┘łž¬ ž©ž»┘ģž┤┘éžī ž╣┘ģ ž¬ž│ž¬ž╣ž» ┘äž┤┘Ŗ ┘āž¦┘å┘łž¦ ┘Ŗž│┘ģ┘æ┘ł┘ć ž│ž¦ž╣ž® ž¦┘䞥┘üž▒".
žźž▒┘枦ž©
┘āž¦┘垬 ž¦┘äž¼┘ģ┘äž® ┘łžŁž»┘枦 ┘ā┘ü┘Ŗ┘äž® ž©┘āž┤┘ü ž¦┘ä┘ģ┘üž¦ž▒┘éž®: ┘åžĖž¦┘ģ ┘Ŗž©ž▒┘æž▒ žźž░┘䞦┘ä ┘ģ┘łž¦žĘ┘å┘Ŗ┘ć ž©ž░ž▒┘Ŗž╣ž® ┘ģ┘łž¦ž¼┘ćž® "ž¦┘äž«┘䞦┘Ŗž¦ ž¦┘ä┘垦ž”┘ģž®"žī ž©┘Ŗ┘å┘ģž¦ ┘Ŗ┘üž▒žČ ž╣┘ä┘ē ┘ā┘ä ┘üž▒ž» žŻ┘å ┘Ŗž©ž▒┘æž” ┘å┘üž│┘ć ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģž¦žČ┘Ŗ ┘éž©┘ä žŻ┘å ┘Ŗž│┘ā┘å žŁž¦žČž▒┘ŗž¦ ┘ćž┤┘枦┘ŗ. ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å ž¦┘äžź┘Ŗž¼ž¦ž▒ ┘ģž¼ž▒┘æž» ž╣┘éž» ž©┘Ŗ┘å ┘ģž¦┘ä┘ā ┘ł┘ģž│ž¬žŻž¼ž▒žī ž©┘ä ž╣ž©┘łž▒┘ŗž¦ ┘éž│ž▒┘Ŗž¦┘ŗ ┘ģ┘å ž©┘łž¦ž©ž® ž¦┘äž«┘ł┘üžī ž©┘łž¦ž©ž® ┘Ŗž¬ž╣┘Ŗ┘æ┘å ž╣┘ä┘Ŗ┘ā žŻ┘å ž¬ž¬ž▒┘ā ž╣┘åž»┘枦 ž¼ž▓žĪž¦┘ŗ ┘ģ┘å ┘āž▒ž¦┘ģž¬┘āžī ┘łž▒ž©┘ģž¦ ┘ģ┘å ž░ž¦┘āž▒ž¬┘ā.
┘ü┘Ŗ ž¬┘ä┘ā ž¦┘ä┘䞣žĖž® žŻž»ž▒┘āž¬ žŻ┘å ž¦┘䞯ž▓┘ģž® ┘ä┘ģ ž¬┘ā┘å ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž©žŁž½ ž╣┘å ž│┘é┘ü ┘ŖžŁ┘ģ┘Ŗ┘å┘Ŗžī ž©┘ä ┘ü┘Ŗ ┘ģ┘łž¦ž¼┘ćž® ž©┘å┘Ŗž® ┘āž¦┘ģ┘äž® ž¬┘ÅžĄž▒┘æ ž╣┘ä┘ē žŻ┘å ž¬ž¬žŁ┘ā┘æ┘ģ ┘ü┘Ŗ žŁ┘Ŗž¦ž¬┘āžī žŁž¬┘ē ┘ü┘Ŗ žŻž©ž│žĘ ž¬┘üž¦žĄ┘Ŗ┘ä┘枦. ž¦┘äž©┘Ŗž¬ ┘ä┘ģ ┘Ŗž╣ž» ┘ģž¼ž▒┘æž» ž¼ž»ž▒ž¦┘åžī ž©┘ä žĄž¦ž▒ ž¦┘ģž¬ž»ž¦ž»ž¦┘ŗ ┘ä┘ģž▒ž¦┘éž©ž® ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘ł"ž│ž¦ž╣ž® ž¦┘䞥┘üž▒" ┘ä┘ģ ž¬┘ā┘å ž¬┘ćž»┘Ŗž»ž¦┘ŗ ž║ž¦┘ģžČž¦┘ŗ ž©┘éž»ž▒ ┘ģž¦ ┘āž¦┘垬 ž│ž¦ž╣ž® ┘Ŗ┘ł┘ģ┘Ŗž® ┘Ŗž╣┘Ŗž┤┘枦 ž¦┘äž│┘łž▒┘Ŗ┘ł┘å ┘ü┘Ŗ žĄ┘ģž¬žī ┘ā┘ä┘ģž¦ ┘łž¼ž»┘łž¦ žŻ┘å┘üž│┘ć┘ģ ┘ģžČžĘž▒┘Ŗ┘å žź┘ä┘ē ž¦┘䞬ž©ž▒žż ┘ģ┘å žŻ┘å┘üž│┘ć┘ģ ┘ā┘Ŗ ┘Ŗž│ž¬┘ģž▒┘łž¦ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž╣┘Ŗž┤.
ž¦žŁž¬┘䞦┘ä ž»┘ģž┤┘é
ž©ž╣ž» ž«┘ģž│ž® ž╣ž┤ž▒ ┘Ŗ┘ł┘ģž¦┘ŗ ┘ģ┘å ž¦┘䞦┘垬žĖž¦ž▒ ┘łž¦┘äž░┘枦ž© ┘łž¦┘äžź┘Ŗž¦ž©žī žŁžĄ┘䞬 žŻž«┘Ŗž▒ž¦┘ŗ ž╣┘ä┘ē ž╣┘éž» ž¦┘äžź┘Ŗž¼ž¦ž▒. ┘ä┘ā┘å ž¦┘äž╣┘éž» ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å ┘å┘枦┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģžĘž¦┘üžī ž©┘ä ž©ž»ž¦┘Ŗž® ┘ģž▒ž¦┘éž©ž® ┘ģž│ž¬┘ģž▒ž®. žźž░ ž©ž¦ž¬ ž╣┘ä┘Ŗ┘æ┘Ä žŻ┘å "žŻ┘Åž┤┘ć┘Éž▒" ┘ćž░ž¦ ž¦┘äž╣┘éž» ž┤┘ćž▒┘Ŗž¦┘ŗ žŻ┘ģž¦┘ģ ž»┘łž▒┘Ŗž® žŻ┘ģ┘å┘Ŗž® ž¬žŻž¬┘Ŗ ž©žŁž¼┘æž® "ž¦┘䞬┘üž¬┘Ŗž┤ ž¦┘äž»┘łž▒┘Ŗ" ┘ä┘䞬žŻ┘āž» ┘ģ┘å žŻžŁ┘é┘Ŗž¬┘Ŗ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž│┘ā┘å. ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘鞬žĄž▒ ž¦┘䞯┘ģž▒ ž╣┘ä┘ē ž¦┘䞬žŁ┘é┘é ┘ģ┘å ž¦┘䞯┘łž▒ž¦┘éžī ž©┘ä ┘āž¦┘å ┘Ŗž┤┘ģ┘ä ž¦┘鞬žŁž¦┘ģ ž¦┘ä┘ģ┘åž▓┘ä ┘łž¬┘üž¬┘Ŗž┤┘ć ž║ž▒┘üž®┘ŗ ž║ž▒┘üž®žī ┘ł┘āžŻ┘å ž¦┘äž©┘Ŗž¬ ž¦┘ä┘ģžżž¼ž▒ ┘ģž┤ž▒┘łž╣ ž«┘ä┘Ŗž® ┘垦ž”┘ģž® ┘Ŗ┘åž©ž║┘Ŗ ┘üžČžŁ┘枦 ┘ā┘ä ž┤┘ćž▒ ┘ģ┘å ž¼ž»┘Ŗž».
┘āž¦┘垬 ž¦┘äž░ž▒┘Ŗž╣ž® ž¼ž¦┘ćž▓ž® ž»┘ł┘ģž¦┘ŗ: "žČž▒┘łž▒ž¦ž¬ žŻ┘ģ┘å┘Ŗž®" ┘ł"┘ģž«ž¦žĘž▒ ž¦┘äž«┘䞦┘Ŗž¦ ž¦┘ä┘垦ž”┘ģž®". ┘ä┘ā┘å ┘ģž¦ ž©ž»ž¦ ┘ä┘Ŗ žŻ┘łžČžŁ ┘ć┘ł žŻ┘å ┘ćž░┘ć ž¦┘äž░ž▒┘Ŗž╣ž® ┘ä┘ģ ž¬┘Åž│ž¬ž«ž»┘ģ ┘ü┘éžĘ ┘䞦ž│ž¬ž©ž¦žŁž® žŁ┘Ŗž¦ž® ž¦┘ä┘垦ž│ ž¦┘äž«ž¦žĄž®žī ž©┘ä žŻ┘ŖžČž¦┘ŗ ┘ä┘üž¬žŁ ž©ž¦ž© ž¼ž»┘Ŗž» ┘ä┘䞦ž│ž¬ž▒ž▓ž¦┘éžī žŁ┘Ŗž½ ž¬žŁ┘ł┘æ┘䞬 ž¦┘䞣┘ģ┘䞦ž¬ ž¦┘䞯┘ģ┘å┘Ŗž® žź┘ä┘ē ┘łž│┘Ŗ┘äž® žČž║žĘ ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘ģž│ž¬žŻž¼ž▒┘Ŗ┘å ┘łž¦┘ä┘ģž¦┘ä┘ā┘Ŗ┘å ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž│┘łž¦žĪžī ž¬ž░┘ā┘æž▒┘ć┘ģ ž©žŻ┘å ž©┘鞦žĪ┘ć┘ģ ┘ü┘Ŗ ž©┘Ŗ┘łž¬┘ć┘ģ ┘ģž┤ž▒┘łžĘ ž©ž¦┘äž▒žČž¦ ž¦┘䞯┘ģ┘å┘Ŗ ┘éž©┘ä žŻ┘Ŗ ž┤┘ŖžĪ žóž«ž▒.
ž¬ž│ž¬žŁžČž▒┘å┘Ŗ ┘ć┘垦 žĄ┘łž▒ž® ž¦┘äž©┘Ŗž¬ ž¦┘äž»┘ģž┤┘é┘Ŗ ž¦┘ä┘éž»┘Ŗ┘ģ ž¦┘äž░┘Ŗ ž│┘ā┘垬 ┘ü┘Ŗ┘ć ┘Ŗ┘ł┘ģž¦┘ŗ. ž©┘Ŗž¬ ┘āž©┘Ŗž▒ ž¬ž¬┘鞦žĘž╣ ┘ü┘Ŗ žŻž▒┘ł┘鞬┘ć ž¦┘䞣┘āž¦┘Ŗž¦ž¬žī ž¼┘ģž╣┘å┘Ŗ ž©ž«┘ģž│ ┘üž¬┘Ŗž¦ž¬ ┘łž▒ž¼┘ä ┘łžŁ┘Ŗž»žī ┘ā┘垦 ┘åž╣┘Ŗž┤ ┘āž╣ž¦ž”┘äž® ┘łž¦žŁž»ž® ž▒ž║┘ģ ž¦ž«ž¬┘䞦┘ü┘垦. žČžŁ┘ā┘垦 ┘āž¦┘å ┘Ŗž│ž©┘é┘垦 ┘ā┘ä ┘ģž│ž¦žĪ žŁ┘Ŗ┘å ┘åžĘ┘ä┘é ┘å┘āž¦ž¬┘垦 ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ž©ž╣ž©ž¦ž▒ž®: "┘ü┘Ŗ ž©┘Ŗž¬┘垦 ž▒ž¼┘ä!" ┘ü┘Ŗ ┘ģž┤┘ćž» ž¦ž╣ž¬ž¦ž»ž¬┘ć ž»┘ģž┤┘é ┘äž╣┘é┘łž» žĘ┘ł┘Ŗ┘äž®.
┘āž¦┘垬 ž¬┘ä┘ā ž¦┘äž©┘Ŗ┘łž¬ ž¦┘äž»┘ģž┤┘é┘Ŗž® ž¦┘ä┘éž»┘Ŗ┘ģž® žĄ┘łž▒ž® ž╣┘å ┘ģž¼ž¬┘ģž╣ ┘Ŗž¬ž┤ž¦ž▒┘ā ž¦┘ä┘ģ┘āž¦┘å ž©žŻž▒┘ŖžŁ┘Ŗž®: ž║ž▒┘ü ž¬žżž¼┘æ┘Äž▒ ┘äžĘ┘䞦ž© ž¼ž¦┘ģž╣ž¦ž¬žī ┘ģ┘łžĖ┘ü┘Ŗ┘åžī ž┤ž¦ž©ž¦ž¬ ┘Ŗž©žŁž½┘å ž╣┘å ┘üž▒žĄž® ┘ä┘äž╣┘ģ┘äžī ┘łž┤ž©ž¦┘å ž║ž▒ž©ž¦žĪ ž¼┘ģž╣┘ć┘ģ ž│┘é┘ü ┘łž¦žŁž» ┘üžŻžĄž©žŁ┘łž¦ "žŻ┘ć┘ä ž©┘Ŗž¬" ┘ł┘ä┘ł ┘ģ┘å ž»┘ł┘å ┘éž▒ž¦ž©ž®. ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å žŻžŁž» ┘Ŗ┘üž¬┘æž┤ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘å┘łž¦┘Ŗž¦žī ┘ł┘ä┘ģ ž¬┘ā┘å ž¦┘䞦ž│ž¬┘ģž¦ž▒ž¦ž¬ ž¦┘䞯┘ģ┘å┘Ŗž® ž¬ž│ž©┘é ž╣┘é┘łž» ž¦┘äžź┘Ŗž¼ž¦ž▒. ┘āž¦┘å ž¦┘äž©┘Ŗž¬ ┘ģ┘āž¦┘å┘ŗž¦ ┘ä┘äž│┘ā┘Ŗ┘åž®žī ┘ł┘ä┘䞬ž¼ž¦ž▒ž© ž¦┘䞯┘ł┘ä┘ē ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞦ž│ž¬┘é┘䞦┘ä ž¦┘äž┤ž«žĄ┘Ŗžī ┘䞦 ž│ž¦žŁž® ┘ģ┘łž¦ž¼┘ćž® ┘ģž╣ ž▒ž¼┘ä ž¦┘䞯┘ģ┘å.
┘ä┘ā┘å ž»┘ģž┤┘é ž¦┘䞬┘Ŗ ž╣ž▒┘ü┘垦┘枦žī ž©ž©┘Ŗ┘łž¬┘枦 ž¦┘ä┘ģž┤ž▒ž╣ž® ┘ä┘äžČžŁ┘āž¦ž¬ ┘łž¦┘äž║ž▒ž©ž¦žĪžī ž¬žŁ┘ł┘æ┘䞬 ┘ü┘Ŗ žĖ┘ä ž¦┘ä┘éž©žČž® ž¦┘䞯┘ģ┘å┘Ŗž® žź┘ä┘ē ┘ģž»┘Ŗ┘åž® žŻž«ž▒┘ē: ┘ā┘ä ž║ž▒┘üž® ž«ž¦žČž╣ž® ┘ä┘䞦ž┤ž¬ž©ž¦┘ćžī ┘ł┘ā┘ä ž╣┘éž» žź┘Ŗž¼ž¦ž▒ ┘ŖžŁž¬ž¦ž¼ ž«ž¬┘ģ┘ŗž¦ ┘ü┘ł┘é ž«ž¬┘ģžī ┘ł┘ā┘ä ┘ģž│ž¬žŻž¼ž▒ ┘ģžĘž¦┘äž© ž©žŻ┘å ┘Ŗž©ž▒┘æž” ┘å┘üž│┘ć ž»┘łž▒┘Ŗ┘ŗž¦ žŻ┘ģž¦┘ģ ž▓ž¦ž”ž▒ ž©ž▓┘Ŗ ž╣ž│┘āž▒┘Ŗ.
ž¦┘äž©┘Ŗž¬ ž¦┘äž░┘Ŗ ┘āž¦┘å ┘Ŗ┘ł┘ģž¦┘ŗ ┘üžČž¦žĪ┘ŗ ┘ä┘䞣┘Ŗž¦ž® ž¦┘ä┘ģž┤ž¬ž▒┘āž®žī žĄž¦ž▒ ž┤ž¦┘ćž»ž¦┘ŗ ž╣┘ä┘ē ┘ā┘Ŗ┘ü┘Ŗ┘æž® ž¬ž¼┘Ŗ┘Ŗž▒ ž¦┘äž│┘äžĘž® ┘ä┘äž░ž▒┘Ŗž╣ž® ž¦┘䞯┘ģ┘å┘Ŗž® ┘ģ┘å žŻž¼┘ä ž¦┘äž│┘ŖžĘž▒ž® ┘łž¦┘䞦ž©ž¬ž▓ž¦ž▓. ┘ģž¦ ž©┘Ŗ┘å "┘ü┘Ŗ ž©┘Ŗž¬┘垦 ž▒ž¼┘ä" ž¦┘䞬┘Ŗ ┘āž¦┘垬 ┘å┘āž¬ž® ┘Ŗ┘ł┘ģ┘Ŗž® ž©ž▒┘Ŗž”ž®žī ┘ł"┘ü┘Ŗ ž©┘Ŗž¬┘垦 ž»┘łž▒┘Ŗž®" ž¦┘䞬┘Ŗ žĄž¦ž▒ž¬ ┘łž¦┘éž╣ž¦┘ŗ ž┤┘ćž▒┘Ŗž¦┘ŗ ž½┘é┘Ŗ┘䞦┘ŗžī ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å ┘é┘Ŗž¦ž│ ž¦┘䞬žŁ┘ł┘æ┘ä ž¦┘äž╣┘ģ┘Ŗ┘é ž¦┘äž░┘Ŗ žŻžĄž¦ž© ž»┘ģž┤┘é ┘łžŁ┘Ŗž¦ž® ž│┘āž¦┘å┘枦.
┘ä┘ģ ž¬┘ā┘å ž¦┘ä┘ģž│ž¦┘ā┘åž® ž▒ž║┘ģ ┘é┘䞬┘枦 žī ┘éž©┘ä ž│┘å┘łž¦ž¬ ž¦┘䞣ž▒ž© ┘łž¦┘ä┘éž©žČž® ž¦┘䞯┘ģ┘å┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģžŁ┘ā┘ģž®žī žĖž¦┘ćž▒ž® ž║ž▒┘Ŗž©ž® ž╣┘ä┘ē ž»┘ģž┤┘é. ┘ü┘Ŗ ┘āž½┘Ŗž▒ ┘ģ┘å ž¦┘äž©┘Ŗ┘łž¬ ž¦┘ä┘ģž│ž¬┘é┘äž®žī ┘āž¦┘å ž┤ž¦ž© ┘ł┘üž¬ž¦ž® ┘Ŗž«ž¬ž¦ž▒ž¦┘å žŻ┘å ┘Ŗž╣┘Ŗž┤ž¦ ┘ģž╣ž¦┘ŗ ž¬žŁž¬ ž│┘é┘ü ┘łž¦žŁž»žī ž©┘łžĄ┘ü┘ć ž«┘Ŗž¦ž▒ž¦┘ŗ ž┤ž«žĄ┘Ŗž¦┘ŗ ┘Ŗž»ž«┘ä ┘ü┘Ŗ ┘åžĘž¦┘é ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž® ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗž® ž©ž║žČ ž¦┘ä┘åžĖž▒ žź┘å ┘ā┘垬 ┘ģž╣┘枦 ž¦┘ł žČž»┘枦 . ┘āž¦┘å ž¦┘䞯┘ģž▒ ┘Ŗ┘Åž╣ž»┘æ ž¼ž▓žĪž¦┘ŗ ┘ģ┘å ž¬┘å┘ł┘æž╣ ž¦┘䞣┘Ŗž¦ž® ž¦┘ä┘ģž»┘å┘Ŗž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž╣ž▒┘üž¬┘枦 ž¦┘äž╣ž¦žĄ┘ģž®žī ž©┘ä žź┘å ž©ž╣žČ ž¦┘ä┘ģž¦┘ä┘ā┘Ŗ┘å ┘āž¦┘å┘łž¦ ┘Ŗž╣ž¬ž©ž▒┘ł┘å┘ć ┘ģžĄž»ž▒ ž▒ž▓┘é žĘž©┘Ŗž╣┘Ŗž¦┘ŗžī ž¬┘ģž¦┘ģž¦┘ŗ ┘āž¦ž│ž¬ž”ž¼ž¦ž▒ ž¦┘äž║ž▒┘ü ┘ä┘äžĘ┘䞦ž© žŻ┘ł ž¦┘ä┘ģ┘łžĖ┘ü┘Ŗ┘å.
┘ä┘ā┘å ┘ćž░┘ć ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž® ž│ž▒ž╣ž¦┘å ┘ģž¦ ž¬žŁ┘ł┘æ┘䞬 žź┘ä┘ē ž│ž¦žŁž® ž¦ž©ž¬ž▓ž¦ž▓. žźž░ ž©ž¦ž¬ žŻ┘Ŗ ž¦┘āž¬ž┤ž¦┘ü ┘ä┘ģž│ž¦┘ā┘åž® ž«┘䞦┘ä žŁ┘ģ┘äž® ž¬┘üž¬┘Ŗž┤ žŻ┘ģ┘å┘Ŗ ┘Ŗ┘ÅžŁ┘ł┘æ┘É┘ä ž│ž¦┘ā┘å┘Ŗ ž¦┘äž©┘Ŗž¬ ┘ģž©ž¦ž┤ž▒ž® žź┘ä┘ē "┘éžČ┘Ŗž® žŻž«┘䞦┘é┘Ŗž®". ┘䞦 ┘Ŗ┘Å┘üž▒ž¼ ž╣┘å┘ć┘ģž¦ žź┘䞦 ž©ž╣ž» ž»┘üž╣ ┘ģž©┘äž║ ┘ģžŁž»ž» ┘ģž│ž©┘鞦┘ŗžī ┘Ŗ┘Åž▒┘ü┘é ž╣ž¦ž»ž® ž©┘ģžŁž¦žČž▒ž® ┘łž╣žĖ┘Ŗž® ž¬┘Å┘ä┘é┘ē ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘üž¬ž¦ž® ž«žĄ┘łžĄž¦┘ŗžī ┘ģžČž¦┘üž¦┘ŗ žź┘ä┘Ŗ┘枦 ž¬┘ćž»┘Ŗž» žĄž▒┘ŖžŁ ž©žźž©┘䞦ž║ ž╣ž¦ž”┘䞬┘枦 žźž░ž¦ ž¬┘āž▒┘æž▒ ž¦┘䞯┘ģž▒. ┘ć┘āž░ž¦ ž¬žŁ┘ł┘æ┘ä ┘ģž¦ ┘Ŗ┘üž¬ž▒žČ žŻ┘å┘ć ž┤žŻ┘å ž«ž¦žĄ ž©┘Ŗ┘å ž©ž¦┘äž║┘Ŗ┘å ž▒ž¦ž┤ž»┘Ŗ┘å žź┘ä┘ē ┘ģžĄž»ž▒ ž▒ž▓┘é ž¼ž»┘Ŗž» ┘äž╣┘垦žĄž▒ ž¦┘䞯┘ģ┘åžī ┘ŖžČž╣┘ł┘å ž¦┘䞯ž«┘䞦┘é ┘łž¦ž¼┘ćž®┘ŗ ž©┘Ŗ┘å┘ģž¦ ┘Ŗ┘ģž»┘æ┘ł┘å žŻ┘Ŗž»┘Ŗ┘ć┘ģ žź┘ä┘ē ž¼┘Ŗ┘łž© ž¦┘ä┘垦ž│.
┘ü┘Ŗ ž«žČ┘ģ ┘ćž░┘ć ž¦┘䞯ž¼┘łž¦žĪ ž¦┘äž«ž¦┘å┘éž®žī ┘łž¼ž» ž©ž╣žČ ž¦┘ä┘ģžŁž¦┘ģ┘Ŗ┘å ┘ģž»ž«┘䞦┘ŗ žóž«ž▒ ┘ä┘䞦ž│ž¬ž½┘ģž¦ž▒ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘é┘ģž╣ ž░ž¦ž¬┘ć. ┘ü┘éž» ž¦┘垬ž┤ž▒ž¬ ž╣┘é┘łž» ž▓┘łž¦ž¼ ┘ł┘ć┘ģ┘Ŗž®žī ┘ģžĘž©┘łž╣ž® ┘ł┘ģž«ž¬┘ł┘ģž® ┘ł┘ģžĄž»┘æ┘éž® ž┤┘ā┘ä┘Ŗž¦┘ŗ ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģžŁž¦┘ā┘ģžī ┘Ŗ┘Åž│ž¬žŁžČž▒ ┘ü┘Ŗ┘枦 ž┤┘ć┘łž» ┘ģž»┘ü┘łž╣┘ł┘å ┘ģž│ž©┘鞦┘ŗžī ┘ģ┘鞦ž©┘ä 300 ž»┘ł┘䞦ž▒ ┘ä┘äž╣┘éž» ž¦┘ä┘łž¦žŁž». ž©┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘łž½┘Ŗ┘éž® ž¦┘ä┘ģž▓┘ł┘æž▒ž®žī ┘āž¦┘å ž¦┘äž┤ž¦ž© ┘łž¦┘ä┘üž¬ž¦ž® ┘ŖžŁžĄ┘䞦┘å ž╣┘ä┘ē "žŁžĄž¦┘åž®" ┘ģžż┘鞬ž® ┘ģ┘å žŁ┘ģ┘䞦ž¬ ž¦┘䞬┘üž¬┘Ŗž┤žī ┘łž¬ž░┘āž▒ž® ž╣ž©┘łž▒ ž¬┘ģ┘åžŁ┘ć┘ģ ž┤┘Ŗž”ž¦┘ŗ ┘ģ┘å žŁž▒┘Ŗž® ž┤ž«žĄ┘Ŗž® ┘āž¦┘å ┘Ŗ┘åž©ž║┘Ŗ žŻ┘å ž¬┘ā┘ł┘å ž©ž»┘Ŗ┘ć┘Ŗž® ┘ģ┘å ž»┘ł┘å žŻ┘łž▒ž¦┘é ž▓ž¦ž”┘üž®.
ž¦┘ä┘ģ┘üž¦ž▒┘éž® ž¦┘ä┘鞦ž│┘Ŗž® žŻ┘å ┘ćž░┘ć ž¦┘äž╣┘é┘łž» ž¦┘ä┘ł┘ć┘ģ┘Ŗž® ┘ä┘ģ ž¬┘ā┘å ž¬ž╣ž©┘Ŗž▒ž¦┘ŗ ž╣┘å ž▒ž║ž©ž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞦┘䞬┘üž¦┘ü ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ž©┘éž»ž▒ ┘ģž¦ ┘āž¦┘垬 ž¦┘åž╣┘āž¦ž│ž¦┘ŗ ┘䞣ž¦┘äž® ž¦ž«ž¬┘垦┘é ž¦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗžī ž¼ž╣┘ä žŁž¬┘ē žŻž©ž│žĘ ž«┘Ŗž¦ž▒ž¦ž¬ ž¦┘䞣┘Ŗž¦ž® ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģ┘Ŗž® ┘ģž▒┘ć┘ł┘åž® ž©ž▒žČž¦ ž¦┘䞯ž¼┘ćž▓ž® ž¦┘䞯┘ģ┘å┘Ŗž® žŻ┘ł ┘éž»ž▒ž¬┘ā ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž»┘üž╣. ┘ä┘éž» ž¬žŁ┘ł┘æ┘䞬 ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž® ž¦┘äž┤ž«žĄ┘Ŗž® žź┘ä┘ē ž©┘åž» ┘Ŗ┘Åž©ž¦ž╣ ┘ł┘Ŗ┘Åž┤ž¬ž▒┘ēžī ┘łž¦┘ä┘łž▒┘é ž¦┘äž▒ž│┘ģ┘Ŗ žź┘ä┘ē ž║žĘž¦žĪ ┘ćž┤┘æ ┘ŖžŁ┘ģ┘Ŗ ┘ģ┘å ┘ģž»ž¦┘ć┘ģž®žī ┘䞦 žŻ┘āž½ž▒.
┘ł┘ģž½┘ä ┘ā┘ä žŻž┤┘āž¦┘ä ž¦┘äžČž║žĘ ž¦┘ä┘ģž¬ž▒ž¦┘ā┘ģž®žī ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å ┘ä┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘łžČž╣ žŻ┘å ┘Ŗž│ž¬┘ģž▒ ┘ģ┘å ž»┘ł┘å ž¦┘å┘üž¼ž¦ž▒. žźž░ žŻž│┘ć┘ģž¬ ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ģ┘ģž¦ž▒ž│ž¦ž¬ ┘Ć┘Ć ž¼┘åž©┘ŗž¦ žź┘ä┘ē ž¼┘åž© ┘ģž╣ ž│┘Ŗž¦ž│ž¦ž¬ ž¦┘ä┘é┘ģž╣ ž¦┘䞯┘łž│ž╣ ┘Ć┘Ć ┘ü┘Ŗ ž▓┘Ŗž¦ž»ž® ž¦┘äž║žČž© ž¦┘ä┘ģ┘āž©┘łž¬ ž»ž¦ž«┘ä ž¦┘äž╣ž¦žĄ┘ģž®žī ┘éž©┘ä žŻ┘å ┘Ŗ┘å┘üž¼ž▒ ┘ģž¼ž»ž»ž¦┘ŗ ┘ü┘Ŗ ┘łž¼┘ć ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž©ž¦ž”ž».
žźž╣ž¦ž»ž® ž¬ž»┘ł┘Ŗž▒
┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ģ┘ü┘ć┘ł┘ģ ž¦┘äž╣ž¦┘ģžī ž¬┘Åž╣ž▒┘æ┘Ä┘ü ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž® ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗž® ž©žŻ┘å┘枦 ž¦┘ä┘łž¼┘ć ž¦┘䞯┘łž│ž╣ ┘ä┘äž»┘Ŗ┘ģ┘éž▒ž¦žĘ┘Ŗž® ž¦┘ä┘āž¦┘ģ┘äž®: ┘éž»ž▒ž® ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘łž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž¦ž¬ ž╣┘ä┘ē ž¦┘䞬ž╣ž©┘Ŗž▒ ž╣┘å ž░┘łž¦ž¬┘ć┘ģ ┘łž¦┘äž╣┘Ŗž┤ ┘ā┘ģž¦ ┘Ŗž┤ž¦žż┘ł┘åžī ┘ģ┘å ž»┘ł┘å ┘łžĄž¦┘Ŗž® žŻ┘ł žČž║┘łžĘ žŻ┘ł ž«┘ł┘ü ┘ģ┘å ┘ģž│ž¦žĪ┘äž® ž║┘Ŗž▒ ┘ģž©ž▒ž▒ž®. ┘łž¬┘Åž╣ž»┘æ ┘ģ┘å žŻž╣┘ģ┘é ┘łžŻž«žĘž▒ žŻž┤┘āž¦┘ä ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž¦ž¬žī žźž░ ž¬┘ģž│┘æ ž¦┘䞣┘Ŗž¦ž® ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģ┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģž©ž¦ž┤ž▒ž®žī ┘ģ┘å žĘž▒┘Ŗ┘éž® ž¦┘ä┘äž©ž¦ž│ žź┘ä┘ē ž¦ž«ž¬┘Ŗž¦ž▒ ž¦┘äž┤ž▒┘Ŗ┘āžī ┘ł┘ģ┘å žŻ┘ģž¦┘ā┘å ž¦┘ä┘ä┘鞦žĪ žź┘ä┘ē žŻž©ž│žĘ žŻž┤┘āž¦┘ä ž¦┘䞬┘üž¦ž╣┘ä ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗ.
┘łž▒ž║┘ģ ž▒žŁ┘Ŗ┘ä ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž│ž¦ž©┘éžī ┘łž▒ž║┘ģ ž¦┘äž«žĘ┘łž¦ž¬ ž¦┘äž¼ž¦ž»ž® ┘䞬┘å┘é┘Ŗž® ž¦┘ä┘éžČž¦žĪ ┘ģ┘å ž©ž╣žČ ┘ģžĖž¦┘ćž▒ ž¦┘ä┘üž│ž¦ž» ž¦┘䞬┘Ŗ ┘åž«ž▒ž¬ ž©┘å┘Ŗž¬┘ć ┘äž╣┘é┘łž»žī ┘üžź┘å ž¦┘ä┘é┘Ŗ┘łž» ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗž® ┘ä┘ģ ž¬┘Åž▒┘üž╣ ž©ž¦┘ä┘āž¦┘ģ┘ä. ┘üž©ž¦ž│┘ģ "ž¦┘䞯┘ģ┘å ž¦┘äž╣ž¦┘ģ"žī žĖ┘ćž▒ž¬ ž╣┘垦žĄž▒ ž©┘ģ┘䞦ž©ž│ ┘ģž»┘å┘Ŗž® ┘Ŗ┘ł┘é┘ü┘ł┘å ž¦┘äž┤ž¦ž©ž¦ž¬ ┘łž¦┘äž┤ž©ž¦┘å ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž┤┘łž¦ž▒ž╣ žŻ┘ł ž¦┘ä┘ģžĘž¦ž╣┘ģžī ┘ł┘Ŗž«žČž╣┘ł┘å┘ć┘ģ ┘䞬žŁ┘é┘Ŗ┘é ┘ü┘łž▒┘Ŗ žŁ┘ł┘ä žĘž©┘Ŗž╣ž® ž¦┘äž╣┘䞦┘éž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬ž¼┘ģž╣┘ć┘ģ. ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ģ┘鞦ž©┘äžī ž¬ž│ž╣┘ē ž¼┘枦ž¬ žŻ┘ģ┘å┘Ŗž® žŻž«ž▒┘ē žź┘ä┘ē žČž©žĘ ┘ģž½┘ä ┘ćž░┘ć ž¦┘䞣┘łž¦ž»ž½ ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗž®žī ┘ł┘ģžŁž¦┘ł┘äž® ž¦žŁž¬┘łž¦žĪ žŁž¦┘äž® ž¦┘äž║žČž© ┘äž»┘ē ž¦┘äž┤ž©ž¦ž© ž©ž╣ž» ž¬ž╣ž▒žČ┘ć┘ģ ┘ä┘ģž½┘ä ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ģ┘łž¦┘é┘ü.
žŁž¦ž»ž½ž® ž¦┘äž┤ž¦ž© (┘ü.ž╣) ┘ä┘Ŗž│ž¬ ž¦ž│ž¬ž½┘垦žĪ┘ŗžī ž©┘ä ž¬┘Åž╣ž»┘æ ┘å┘ģ┘łž░ž¼ž¦┘ŗ žĄž¦ž▒ž«ž¦┘ŗ. ┘ü┘éž» žŻ┘ł┘é┘ü┘ć ž╣┘垦žĄž▒ žŻ┘ģ┘å žŻž½┘垦žĪ ┘łž¼┘łž»┘ć ž©ž▒┘ü┘éž® žĄž»┘Ŗ┘鞬┘ćžī ┘łžŁž¦┘ł┘ä žŻ┘å ┘Ŗ┘łžČžŁ žŻ┘å┘枦 ž▒┘ü┘Ŗ┘éž® žĘ┘ü┘ł┘䞬┘ćžī žź┘䞦 žŻ┘å ž░┘ä┘ā ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ģ┘åž╣ ž¬ž╣ž▒žČ┘ć ┘äžČž▒ž©ž¦ž¬ ┘ģ┘łž¼ž╣ž® žŻ┘ģž¦┘ģ ž¦┘ä┘ģž¦ž▒ž®žī ┘ü┘Ŗ┘ģž¦ ┘āž¦┘垬 žĄž▒ž«ž¦ž¬ ž¦┘ä┘üž¬ž¦ž® ž¬ž│ž¬ž║┘Ŗž½ ž»┘ł┘å ž¼ž»┘ł┘ē. žŁž¦┘ł┘ä ž©ž╣žČ ž¦┘ä┘ģž¦ž▒ž® ž¦┘䞬ž»ž«┘äžī ┘ä┘ā┘å┘ć┘ģ ž│ž▒ž╣ž¦┘å ┘ģž¦ ž¬ž▒ž¦ž¼ž╣┘łž¦ žŻ┘ģž¦┘ģ ž¦┘ä┘éž©žČž® ž¦┘䞯┘ģ┘å┘Ŗž®žī ┘ä┘Ŗ┘Å┘鞬ž¦ž» ž¦┘äž┤ž¦ž© ┘éž©┘ä žŻ┘å ┘Ŗž¬ž»ž«┘ä ž╣┘åžĄž▒ žŻ┘ģ┘å žóž«ž▒ ┘ł┘Ŗž╣┘Ŗž» ┘ä┘ć ┘āž▒ž¦┘ģž¬┘ćžī ┘ģ┘éž»┘ģž¦┘ŗ ┘ä┘ć ž¦ž╣ž¬ž░ž¦ž▒ž¦┘ŗ ž╣┘ģ┘枦 ┘üž╣┘ä┘ć ž▓┘ģ┘Ŗ┘ä┘ć žŻ┘ģž¦┘ģ ž¦┘äž¼┘ģ┘Ŗž╣.
┘ä┘ģ ┘Ŗž¬┘ł┘é┘ü ž¦┘䞯┘ģž▒ ž╣┘åž» ž¦┘ä┘ģ┘䞦žŁ┘鞦ž¬ ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗž®. ┘ü┘ü┘Ŗ ž«žĘ┘łž® ž©ž»ž¬ ž▒┘ģž▓┘Ŗž® ┘ä┘ā┘å┘枦 ┘āž¦ž┤┘üž®žī ž¬┘ģ žĘž▒ž» ž©ž╣žČ ž¦┘äž┤ž©ž¦ž© ┘ģ┘å žŁž»┘Ŗ┘éž® ž¦┘ä┘éž┤┘äž® ž¦┘äž┤┘ć┘Ŗž▒ž® ┘ü┘Ŗ ž»┘ģž┤┘éžī ž©ž╣ž»┘ģž¦ ž¬žŁ┘ł┘æ┘䞬 žź┘ä┘ē ┘ģž│ž¦žŁž® ┘Ŗž¼┘äž│ ┘ü┘Ŗ┘枦 ž¦┘äž┤ž©ž¦ž© ┘łž¦┘ä┘üž¬┘Ŗž¦ž¬ ┘ģž╣ž¦┘ŗ. ┘éž» ┘Ŗ┘Å┘åžĖž▒ žź┘ä┘ē ┘ćž░┘ć ž¦┘äž¼┘äž│ž¦ž¬ ž╣┘ä┘ē žŻ┘å┘枦 ┘ģ┘ģž¦ž▒ž│ž¦ž¬ ┘üž▒ž»┘Ŗž®žī ┘łž▒ž©┘ģž¦ "┘ģ┘å┘ü┘䞬ž®"žī ┘ä┘ā┘å┘枦 ┘ü┘Ŗ ž¼┘ł┘ćž▒┘枦 ┘āž¦┘垬 žŻž┤┘āž¦┘䞦┘ŗ žĘž©┘Ŗž╣┘Ŗž® ┘ä┘䞬┘䞦┘é┘Ŗ ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗ. ž║┘Ŗž▒ žŻ┘å ž¦┘äž▒ž│ž¦┘äž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž©ž╣ž½┘枦 ┘ģ┘åž╣ ž¦┘äž¼┘ä┘łž│ ┘ģ┘å ┘éž©┘ä ž©ž╣žČ ž¦┘äž¼┘枦ž¬ ┘āž¦┘垬 ┘łž¦žČžŁž®: žŻ┘Ŗ ┘ģž│ž¦žŁž® ┘ä┘䞣ž▒┘Ŗž®žī žŁž¬┘ē ┘łžź┘å ┘āž¦┘垬 ┘ģž¼ž▒ž» žŁž¼ž¦ž▒ž® ┘Ŗž¼┘äž│ ž╣┘ä┘Ŗ┘枦 ž¦┘ä┘垦ž│žī ž│ž¬┘Å┘鞬┘äž╣ žźž░ž¦ ┘䞦┘ģž│ž¬ žŁž»┘łž» "ž¦┘䞬žŁž▒ž▒ ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗ" ž║┘Ŗž▒ ž¦┘ä┘ģž▒ž║┘łž© ┘ü┘Ŗ┘ć.
┘Ŗž¬žČžŁ žŻ┘å ┘ģž▒žŁ┘äž® ┘ģž¦ ž©ž╣ž» ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ┘ä┘ģ ž¬žŁ┘ģ┘ä ž¦┘å┘üž▒ž¦ž¼ž¦┘ŗ ž¦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗž¦┘ŗ ┘āž¦┘ģ┘䞦┘ŗžī ž©┘ä ž┤┘ćž»ž¬ ┘ģ┘ģž¦ž▒ž│ž¦ž¬ ┘ģ┘å┘ü┘䞬ž® ž¬┘Å┘å┘ü┘æ┘Äž░ žŻžŁ┘Ŗž¦┘垦┘ŗ ž©žŻž»┘łž¦ž¬ ž╣┘å┘Ŗ┘üž® ┘ł┘ģž©ž¦ž┤ž▒ž®. ┘üž¦┘䞣ž▒┘Ŗž® ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗž®žī ž¦┘䞬┘Ŗ ┘Ŗ┘Å┘üž¬ž▒žČ žŻ┘å ž¬┘ā┘ł┘å žĄ┘ģ┘枦┘ģ žŻ┘ģž¦┘å ┘ä┘ä┘ģž¼ž¬┘ģž╣ ž¦┘ä┘ģž»┘å┘Ŗžī ž¬┘Åž«ž¬ž▓┘ä ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦ž│ž¬ž¼┘łž¦ž© ž╣ž¦ž©ž▒ žŻ┘ł ┘ü┘Ŗ ž¬┘ü┘ā┘Ŗ┘ā žŁž»┘Ŗ┘éž® ┘āž¦┘垬 ž¬žŁž¬žČ┘å ┘ä┘鞦žĪž¦ž¬ ž┤ž©ž¦ž©┘Ŗž® ž©ž│┘ŖžĘž®.
┘ł┘ā┘ģž¦ ž¦ž│ž¬┘Åž«ž»┘ģž¬ ž│ž¦ž©┘鞦┘ŗ ž╣┘é┘łž» ž¦┘äž▓┘łž¦ž¼ ž¦┘ä┘ł┘ć┘ģ┘Ŗž® ┘ä┘䞬žŁž¦┘Ŗ┘ä ž╣┘ä┘ē žŁ┘ģ┘䞦ž¬ ž¦┘䞬┘üž¬┘Ŗž┤ ž»ž¦ž«┘ä ž¦┘äž©┘Ŗ┘łž¬ ž¦┘äž»┘ģž┤┘é┘Ŗž®žī ž╣ž¦ž»ž¬ ┘ćž░┘ć ž¦┘äžĖž¦┘ćž▒ž® žź┘ä┘ē ž¦┘ä┘łž¦ž¼┘ćž® ž©žĄ┘Ŗž║ž® ž¼ž»┘Ŗž»ž® ┘łžŻ┘āž½ž▒ ž╣┘䞦┘å┘Ŗž®: ┘łž½ž¦ž”┘é ž¼ž¦┘ćž▓ž® ┘Ŗ┘Åž┤┘ć┘Äž▒ ž©┘枦 ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž┤┘łž¦ž▒ž╣ ┘łž¦┘ä┘ģ┘鞦┘ć┘Ŗžī ┘䞬ž¬žŁ┘ł┘æ┘ä žź┘ä┘ē ┘łž│┘Ŗ┘äž® "ž┤ž▒ž╣┘åž®" ┘ģžĄžĘ┘åž╣ž® ┘ä┘äž╣┘䞦┘鞦ž¬ žŻ┘ģž¦┘ģ ž©ž╣žČ ž»┘łž▒┘Ŗž¦ž¬ ž¦┘䞯┘ģ┘å ┘łžŁ┘łž¦ž¼ž▓ ž¦┘䞬┘üž¬┘Ŗž┤.
┘ģž▒ž® žŻž«ž▒┘ēžī ┘łž¼ž» ž©ž╣žČ ž¦┘ä┘ģžŁž¦┘ģ┘Ŗ┘å ┘ü┘Ŗ ┘ćž░ž¦ ž¦┘äž©ž¦ž© ┘üž▒žĄž® ž▒ž▓┘é ┘ģž│ž¬┘ģž▒ž®žī žźž░ ┘ŖžĄž╣ž© ž╣┘ä┘ē žŻ┘Ŗ ž│┘äžĘž®žī ┘ģ┘ć┘ģž¦ ž¦ž┤ž¬ž»ž¬ ┘éž©žČž¬┘枦žī žŻ┘å ž¬ž║┘ä┘é ž¼┘ģ┘Ŗž╣ ┘ģ┘垦┘üž░ ž¦┘ä┘üž│ž¦ž». ž¬┘ÅžŁž▒┘æ┘Äž▒ ž¦┘äž╣┘é┘łž» ž©ž¦┘䞥┘Ŗž║ž® ž░ž¦ž¬┘枦žī ┘ģž╣ ž┤┘ć┘łž» ┘ł┘ć┘ģ┘Ŗ┘Ŗ┘å ┘łžŻž«ž¬ž¦┘ģ ž┤┘ā┘ä┘Ŗž®žī ┘ä┘ā┘å ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ģž▒ž® ž©ž│ž╣ž▒ žŻž╣┘ä┘ē ┘łžĄ┘ä žź┘ä┘ē 500 ž»┘ł┘䞦ž▒žī ž½┘ģ┘å ┘łž▒┘éž® ž¬┘ģ┘åžŁ žĄž¦žŁž©┘枦 ž┤ž╣┘łž▒ž¦┘ŗ ž©ž¦┘䞯┘ģž¦┘å žŻ┘ģž¦┘ģ žŻ┘Ŗ ž│žżž¦┘ä ┘éž» ┘Ŗž¬ž╣ž▒žČ ┘ä┘ć.
┘Ŗž▒┘ł┘Ŗ ž¦┘äž┤ž¦ž© "ž│.ž▓" ┘ä┘Ć"ž¦┘ä┘ģž»┘å" ž¬ž¼ž▒ž©ž¬┘ć ┘ģž╣ ┘ćž░┘ć ž¦┘äž╣┘é┘łž»žī ┘鞦ž”┘䞦┘ŗ: "┘ā┘垬 žŻž╣┘Ŗž┤ žŁž¦┘äž® ┘é┘ä┘é ┘ā┘ä┘ģž¦ ž«žĘž▒ž¬ ž©ž©ž¦┘ä┘Ŗ ┘ü┘āž▒ž® ž¦┘äž«ž▒┘łž¼ ┘ģž╣ žĄž»┘Ŗ┘鞦ž¬┘Ŗžī žŻ┘ł žŁž¬┘ē ž▒žż┘Ŗž® žŁž©┘Ŗž©ž¬┘Ŗ. ž░ž¦ž¬ ┘ģž▒ž®žī žŻ┘Å┘ł┘é┘ü žĄž»┘Ŗ┘é┘Ŗ ž©ž▒┘ü┘éž® žŁž©┘Ŗž©ž¬┘ć ž╣┘ä┘ē žŁž¦ž¼ž▓ ž╣┘åž» ┘ģž»ž«┘ä ž¼ž▒┘ģž¦┘垦žī ┘䞬ž©ž»žŻ ž▒žŁ┘äž® ž¦┘䞬žŁ┘é┘Ŗ┘é žŁ┘ł┘ä žĘž©┘Ŗž╣ž® ž¦┘äž╣┘䞦┘éž® ž©┘Ŗ┘å┘ć┘ģž¦"žī ┘éž©┘ä žŻ┘å ┘Ŗ┘Åž¬ž▒┘ā ┘ü┘Ŗ žŁž¦┘ä ž│ž©┘Ŗ┘ä┘ć ž©ž╣ž» ┘åžŁ┘ł ┘åžĄ┘ü ž│ž¦ž╣ž® ┘ģ┘å ž¦┘䞯ž«ž░ ┘łž¦┘äž▒ž»žī žŻ┘å┘枬┘枦 žŻ┘ŖžČž¦┘ŗ ž¬ž»ž«┘ä ž╣┘åžĄž▒ žŻ┘ģ┘å žóž«ž▒ ž│┘ģžŁ ┘ä┘ć┘ģž¦ ž©ž¦┘ä┘ģž║ž¦ž»ž▒ž®.
┘ł┘ŖžČ┘Ŗ┘ü: "žŻž«ž©ž▒┘å┘Ŗ žŻžŁž» žŻžĄž»┘鞦ž”┘Ŗ žŻ┘å┘ć ž¬ž¼ž¦┘łž▓ ž¦┘ä┘ģ┘ł┘é┘ü ┘å┘üž│┘ć ž©ž╣ž» žŻ┘å ž¦ž│ž¬žĄž»ž▒ ž╣┘éž» ž▓┘łž¦ž¼ ┘ł┘ć┘ģ┘Ŗž¦┘ŗ ž©┘ģž│ž¦ž╣ž»ž® ž©ž╣žČ ┘ģž╣┘éž©┘Ŗ ž¦┘ä┘ģž╣ž¦┘ģ┘䞦ž¬ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘鞥ž▒ ž¦┘äž╣ž»┘ä┘Ŗ. ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å ž¦┘䞣┘ä ┘ģž½ž¦┘ä┘Ŗž¦┘ŗžī ┘ä┘ā┘å┘ć ž╣┘ä┘ē ž¦┘䞯┘é┘ä ┘ł┘ü┘æž▒ ┘ä┘ć žŁ┘ģž¦┘Ŗž® ┘ģžż┘鞬ž® ┘ģ┘å ž¦┘䞬┘ł┘é┘Ŗ┘ü. ┘łž│ž▒ž╣ž¦┘å ┘ģž¦ ž¦┘åž│žŁž© ┘ćž░ž¦ "ž¦┘䞣┘ä" ž╣┘ä┘ē ┘āž½┘Ŗž▒ ┘ģ┘å ž¦┘äž┤ž©ž¦ž© ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž╣ž¦žĄ┘ģž®žī žŁž¬┘ē žĄž¦ž▒ ž¦┘äž╣┘éž» ž¦┘ä┘ł┘ć┘ģ┘Ŗ žŻž┤ž©┘ć ž©ž¬ž░┘āž▒ž® ┘ģž▒┘łž▒žī žŻ┘ł ž©žĘž¦┘éž® ž┤ž«žĄ┘Ŗž® ┘Ŗ┘Åž┤┘ćž▒┘枦 ž¦┘äž┤ž¦ž© ┘ä┘Ŗ┘ģžČ┘Ŗ ┘ü┘Ŗ žŁž¦┘ä ž│ž©┘Ŗ┘ä┘ć".
┘Ŗž▒┘ł┘Ŗ "ž│.ž▓" žŻžŁž» ž¦┘ä┘ģ┘łž¦┘é┘ü ž¦┘äžĘž▒┘Ŗ┘üž® ┘łž¦┘ä┘ģžż┘ä┘ģž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬ž╣┘āž│ ž¦┘ä┘ģ┘üž¦ž▒┘éž® ž©┘łžČ┘łžŁžī ┘鞦ž”┘䞦┘ŗ: "žŻ┘ł┘é┘ü┘å┘Ŗ ž╣┘åžĄž▒ žĄž║┘Ŗž▒ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž│┘å ┘łžĘ┘äž© ž▒žż┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘éž». žŻ┘ģž│┘ā ž¦┘ä┘łž▒┘éž® ž©ž¦┘ä┘ģ┘é┘ä┘łž©žī ┘łž¬žĖž¦┘ćž▒ ž©žŻ┘å┘ć ┘Ŗ┘éž▒žŻ┘枦žī ž½┘ģ žŻ┘ł┘ģžŻ ž©ž▒žŻž│┘ć ┘łžŻž╣ž¦ž»┘枦 ┘ä┘Ŗ ž©ž¦ž©ž¬ž│ž¦┘ģž® ž©ž¦ž▒ž»ž®. ž¬ž¦ž©ž╣ž¬ žĘž▒┘Ŗ┘é┘Ŗ ┘łžŻ┘垦 žŻžČžŁ┘ā ┘ü┘Ŗ ž»ž¦ž«┘ä┘Ŗ ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģž┤┘ćž»žī ž¬┘ģž¦┘ģž¦┘ŗ ┘ā┘ģž¦ žČžŁ┘āž¬ ┘Ŗ┘ł┘ģž¦┘ŗ žŁ┘Ŗ┘å žĘ┘Å┘äž© ┘ģ┘å┘Ŗ ž┤ž▒žŁ ┘ģž╣┘å┘ē ž¦┘䞣ž▓ž© ž¦┘äž┤┘Ŗ┘łž╣┘Ŗ ┘äž╣┘åžĄž▒ žóž«ž▒ ┘䞦 ┘Ŗž╣ž▒┘ü ž╣┘å┘ć ž┤┘Ŗž”ž¦┘ŗ".
žŁž¦┘䞦ž¬ ┘üž▒ž»┘Ŗž®
┘éž» ž¬ž©ž»┘ł ž©ž╣žČ ž¦┘䞦┘垬┘枦┘āž¦ž¬ ž¦┘䞬┘Ŗ ┘Ŗž┤┘ćž»┘枦 ž¦┘äž┤ž¦ž▒ž╣ ž¦┘äž»┘ģž┤┘é┘Ŗ ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģ žŁž¦┘䞦ž¬ ┘üž▒ž»┘Ŗž® ┘ģž╣ž▓┘ł┘äž®žī ┘Ŗ┘å┘üž░┘枦 ž╣┘垦žĄž▒ ┘ģ┘å┘ü┘䞬ž® ┘łž¼ž»┘łž¦ žŻ┘å┘üž│┘ć┘ģ ┘üž¼žŻž® ┘ü┘Ŗ ┘é┘äž© ž¦┘äž╣ž¦žĄ┘ģž® ž░ž¦ž¬ ž¦┘䞬ž▒┘ā┘Ŗž©ž® ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģž╣┘éž»ž®. žź┘䞦 žŻ┘å ┘ćž░┘ć ž¦┘䞣ž¦┘䞦ž¬žī ž©ž¬┘āž▒ž¦ž▒┘枦žī ┘ä┘ģ ž¬ž╣ž» ž╣ž¦ž©ž▒ž®žø ž©┘ä ž©ž¦ž¬ž¬ ž¬žżž│ž│ ┘ä┘łž¦┘éž╣ ┘üž│ž¦ž» ž¼ž»┘Ŗž»žī ž©žŻž»┘łž¦ž¬ ┘łžŻž│┘ģž¦žĪ ┘ģž«ž¬┘ä┘üž®žī ž¬žŁž¦┘ł┘ä ž¦┘䞣┘ā┘ł┘ģž® ž¼ž¦┘ćž»ž® ž¦┘䞬ž«┘䞥 ┘ģ┘å┘ć ┘łž│žĘ ž¦┘åž┤ž║ž¦┘ä┘枦 ž©žźž╣ž¦ž»ž® ž¬ž▒ž¬┘Ŗž© žŻ┘łž▒ž¦┘é ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘ł┘ģž╣ž¦┘äž¼ž® ž¦┘äžźž▒ž½ ž¦┘äž½┘é┘Ŗ┘ä ž¦┘äž░┘Ŗ ž«┘ä┘æ┘ü┘ć ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž│ž¦ž©┘é.
 ž¦┘äž«┘Ŗž¦┘ģ | khiyam.com
ž¦┘äž«┘Ŗž¦┘ģ | khiyam.com 





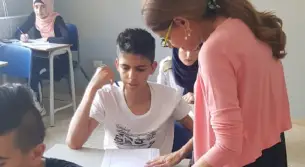





ž¬ž╣┘ä┘Ŗ┘鞦ž¬: