
ž©ž╣ž» ┘åž┤ž▒ ┘ģ┘鞦┘ä ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ž¦┘䞬┘Ŗ ┘Ŗž«ž┤┘ł┘å┘枦 žŻ┘ģž│žī ┘łžĄ┘䞬┘å┘Ŗ ž¬ž╣┘ä┘Ŗ┘鞦ž¬ ┘łžóž▒ž¦žĪ ┘é┘Ŗ┘æ┘ģž® ┘ģ┘å ┘éž▒ž¦žĪ ┘ł┘ģž½┘é┘ü┘Ŗ┘åžī ž©┘Ŗ┘å┘ć┘ģ ┘ģ┘å ž¬┘ģ┘å┘æ┘ē žŻ┘å žŻž¬┘łž│ž╣ žŻ┘āž½ž▒ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ü┘éž▒ž¦ž¬ ž¦┘ä┘ģž¬žĄ┘äž® ž©ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘䞣ž»┘Ŗž½ž® ┘łž╣┘䞦┘鞬┘枦 ž©ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž®.
┘łž©┘Ŗ┘å┘ģž¦ ž¬ž¬┘āž▒ž▒ ┘ģž┤ž¦┘ćž» ž¦┘䞦┘åž│žŁž¦ž© ┘ģ┘å ┘ģž¼┘äž│ ž¦┘ä┘łž▓ž▒ž¦žĪ ž©žŁž¼ž® žŻ┘å '┘ģž¦ ž©┘Å┘å┘Ŗ ž╣┘ä┘ē ž©ž¦žĘ┘ä ┘ć┘ł ž©ž¦žĘ┘ä'žī ┘Ŗž©┘é┘ē ž¦┘äž│žżž¦┘ä ž¦┘䞯ž╣┘ģ┘é: ┘ć┘ä ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å ┘ä┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® žŻ┘å ž¬┘äž║┘Ŗ ž¦┘ä┘ģ┘łž¦žĘ┘åž®žī žŻ┘ł ┘ä┘ä┘ģ┘łž¦žĘ┘åž® žŻ┘å ž¬ž¬ž¼ž¦┘ć┘ä ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž®ž¤ ┘ćž░ž¦ ┘ģž¦ žŁž¦┘ł┘䞬 ┘ģ┘鞦ž▒ž©ž¬┘ć ┘ü┘Ŗ ┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘ģ┘鞦┘äŌĆ”"
ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģžī žŻžČž╣ ž©┘Ŗ┘å žŻ┘Ŗž»┘Ŗ┘ā┘ģ ┘ģ┘鞦┘ä┘Ŗ ž¦┘äž¼ž»┘Ŗž» ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘łž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łž¦┘ä┘ģ┘łž¦žĘ┘åž®žī ┘ģžŁž¦┘ł┘äž® ┘ä┘éž▒ž¦žĪž® žŻž╣┘ģ┘é ┘ä┘äž╣┘䞦┘éž® ž©┘Ŗ┘å ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ā┘ģ┘ā┘ł┘æ┘å žŻžĄ┘Ŗ┘äžī ┘łž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘āžźžĘž¦ž▒ ž¼ž¦┘ģž╣
ž╣┘å┘łž¦┘å ž¦┘ä┘ģ┘鞦┘ä: ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘łž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łž¦┘ä┘ģ┘łž¦žĘ┘åž®
ž©┘é┘ä┘ģ: ┘ģ┘Ŗ žŁž│┘Ŗ┘å ž╣ž©ž»ž¦┘ä┘ä┘ć
┘ü┘Ŗ ┘äž©┘垦┘åžī ┘Ŗž¬┘āž▒ž▒ ž¦┘äž«žĘž¦ž© ž¦┘äž░┘Ŗ ┘ŖžČž╣ ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ü┘Ŗ ┘ģ┘łž¦ž¼┘ćž® ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘ł┘āžŻ┘å┘ć┘ģž¦ ž«žĄ┘ģž¦┘å ┘䞦 ┘Ŗ┘䞬┘é┘Ŗž¦┘å. ┘ä┘ā┘å ž¦┘䞣┘é┘Ŗ┘éž® žŻ┘å ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ä┘ģ ž¬┘ā┘å ┘Ŗ┘ł┘ģ┘ŗž¦ ┘å┘é┘ŖžČ┘ŗž¦ ┘ä┘äž»┘ł┘äž®žī ž©┘ä žŁ┘ģ┘䞬 ┘ü┘Ŗ ž¼┘ł┘ćž▒┘枦 ┘é┘Ŗ┘ģ ž¦┘äž╣ž»┘ä ┘łž¦┘ä┘āž▒ž¦┘ģž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬┘Åž╣ž» žŻž│ž¦ž│ žŻ┘Ŗ ž│┘äžĘž® ž┤ž▒ž╣┘Ŗž®. ž║┘Ŗž▒ žŻ┘å ┘ģž¦ ┘åž╣┘Ŗž┤┘ć ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģ ┘ć┘ł ž¬žĄž¦ž»┘ģ žĖž▒┘ü┘Ŗžī ž¬┘üž▒žČ┘ć ž»┘ł┘äž® ┘ģžŻž▓┘ł┘ģž®žī ┘ģž▒ž¬┘ć┘åž®žī ž╣ž¦ž¼ž▓ž® ž╣┘å žŻ┘å ž¬┘ā┘ł┘å žŁž¦┘ģ┘Ŗž® ┘äž¼┘ģ┘Ŗž╣ ┘ģ┘łž¦žĘ┘å┘Ŗ┘枦žī ┘ģ┘鞦ž©┘ä ž╣┘é┘Ŗž»ž® ž¬žŁ┘ł┘æ┘䞬 žź┘ä┘ē žČ┘ģž¦┘åž® ž©┘鞦žĪ ┘ü┘Ŗ ┘łž¼┘ć ž¦┘ä┘ć┘Ŗ┘ģ┘åž® ž¦┘äž«ž¦ž▒ž¼┘Ŗž® ┘łž¦┘ä┘ģž┤ž▒┘łž╣ ž¦┘䞯┘ģ┘Ŗž▒┘ā┘ŖŌĆōž¦┘äžźž│ž▒ž¦ž”┘Ŗ┘ä┘Ŗ.
ž¦┘䞦┘䞬┘鞦žĪ ž©┘Ŗ┘å ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘łž¦┘äž»┘ł┘äž®
┘ü┘Ŗ ┘å┘鞦žĘ ┘āž½┘Ŗž▒ž®žī ┘Ŗ┘䞬┘é┘Ŗ ž¦┘ä┘ģž│ž¦ž▒ž¦┘å:
- *ž¦┘äž╣ž»┘ä* žŻžĄ┘ä ž»┘Ŗ┘å┘Ŗ ž╣┘åž» ž¦┘äž┤┘Ŗž╣ž®žī ┘ł┘ć┘ł ┘āž░┘ä┘ā žŻž│ž¦ž│ ž¦┘䞣┘ā┘ģ ┘ü┘Ŗ žŻ┘Ŗ ž»┘ł┘äž® ž╣ž¦ž»┘äž®.
- *ž¦┘ä┘āž▒ž¦┘ģž® ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å┘Ŗž®* ┘é┘Ŗ┘ģž® ┘ģž▒┘āž▓┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž®žī ┘ł┘ć┘Ŗ ž¼┘ł┘ćž▒ ž¦┘äžźž╣┘䞦┘å ž¦┘äž╣ž¦┘ä┘ģ┘Ŗ ┘䞣┘é┘ł┘é ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å ┘łž¦┘äž»ž│ž¦ž¬┘Ŗž▒ ž¦┘䞣ž»┘Ŗž½ž®.
- *ž▒┘üžČ ž¦┘äžĖ┘ä┘ģ* ž┤ž╣ž¦ž▒ ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ģ┘åž░ ┘āž▒ž©┘䞦žĪžī ┘ł┘ć┘ł žŻ┘ŖžČ┘ŗž¦ ┘ģž©ž»žŻ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ┘łžŁ┘é ž¦┘äž┤ž╣┘łž© ┘ü┘Ŗ ž¬┘éž▒┘Ŗž▒ ┘ģžĄ┘Ŗž▒┘枦.
- *žŁ┘ģž¦┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģž¼ž¬┘ģž╣* ┘łž¦ž¼ž© ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž╣ž©ž▒ ž¼┘Ŗž┤┘枦 ┘ł┘é┘łž¦┘å┘Ŗ┘å┘枦žī ┘ł┘łž¦ž¼ž© ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ž╣ž©ž▒ ž¦┘ä┘ģ┘鞦┘ł┘ģž® ┘łž¦┘䞬žČžŁ┘Ŗž®.
┘ć┘垦žī ž¬ž¬žČžŁ ž¦┘ä┘ģž┤ž¬ž▒┘āž¦ž¬: ž╣┘é┘Ŗž»ž® ž¬ž▓ž▒ž╣ ž¦┘ä┘ģž╣┘å┘ēžī ┘łž»┘ł┘äž® ž¬┘ł┘üž▒ ž¦┘䞣┘ģž¦┘Ŗž®žī ┘łž¦┘ä┘ģ┘łž¦žĘ┘åž® ┘ć┘Ŗ ž¦┘äž▒ž¦ž©žĘ ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗž¼┘ģž╣ ž¦┘ä┘üž▒ž» ž©ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž®.
ž¦┘䞦ž«ž¬┘䞦┘üž¦ž¬ ┘ł┘ģ┘āž¦┘ģ┘å ž¦┘䞬žĄž¦ž»┘ģ
┘ä┘ā┘å ž¦┘äž«┘䞦┘ü ┘ŖžĖ┘ćž▒ ž╣┘åž» ž¦┘䞬┘üž¦žĄ┘Ŗ┘ä:
- ┘ģžĄž»ž▒ ž¦┘äž┤ž▒ž╣┘Ŗž®: ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ž¬ž│ž¬┘ģž»┘枦 ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ä┘ć ┘ł┘ģ┘å┘ćž¼ ž¦┘äž╣ž»┘ä ž¦┘äž░┘Ŗ žŻž▒ž│ž¦┘ć žŻ┘ć┘ä ž¦┘äž©┘Ŗž¬ (ž╣)žī ž©┘Ŗ┘å┘ģž¦ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘䞣ž»┘Ŗž½ž® ž¬ž¼ž╣┘ä┘枦 ┘ģ┘å ž¦┘äž┤ž╣ž© ž╣ž©ž▒ ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒.
- ž¦žŁž¬┘āž¦ž▒ ž¦┘äž│┘䞦žŁ: ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¬ž▒┘ē žŻ┘å ž¦┘äž╣┘å┘ü ž¦┘äž┤ž▒ž╣┘Ŗ žŁ┘é┘枦 ┘łžŁž»┘枦žī ž©┘Ŗ┘å┘ģž¦ ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ž¬ž¼┘Ŗž▓ ž¦┘äž»┘üž¦ž╣ žŁ┘Ŗ┘å ž¬ž║┘Ŗž© ž¦┘äž»┘ł┘äž® žŻ┘ł ž¬ž╣ž¼ž▓.
- ž¦┘ä┘ć┘ł┘Ŗž®: ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¬ž│ž╣┘ē ┘ä┘ć┘ł┘Ŗž® ┘łžĘ┘å┘Ŗž® ž¼ž¦┘ģž╣ž®žī ž©┘Ŗ┘å┘ģž¦ ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ž¬┘Åž©┘é┘Ŗ ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘ć┘ł┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģž░┘ćž©┘Ŗž® ┘āž¼ž▓žĪ žŻžĄ┘Ŗ┘ä ┘ģ┘å ž¦┘䞦┘垬┘ģž¦žĪ.
┘ćž░ž¦ ž¦┘䞬ž©ž¦┘Ŗ┘å ┘䞦 ┘Ŗ┘Å┘äž║┘Ŗ ž¦┘ä┘ģž┤ž¬ž▒┘āž¦ž¬žī ┘ä┘ā┘å┘ć ┘Ŗ┘üž│ž▒ ž│ž©ž© ž¦┘䞬žĄž¦ž»┘ģ ┘ü┘Ŗ ┘łž¦┘éž╣ ┘ćž┤┘æ ┘ł┘ģž╣┘éž» ┘ā┘äž©┘垦┘å.
ž¬┘łžĄ┘Ŗ┘ü žŁž¦┘ä ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘äž©┘垦┘å┘Ŗž®
┘ä┘ģ ž¬┘ā┘å ž¦┘ä┘ģž┤┘ā┘äž® ┘Ŗ┘ł┘ģ┘ŗž¦ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘üž▒ž¦ž║ ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗ ┘łžŁž»┘ćžī ┘ü┘枦 ┘ć┘Ŗ ž¦┘äž│┘äžĘž® ┘ģ┘āž¬┘ģ┘äž®: ž▒ž”┘Ŗž│ ┘ä┘äž¼┘ģ┘ć┘łž▒┘Ŗž®žī ž▒ž”┘Ŗž│ ┘ä┘䞣┘ā┘ł┘ģž®žī ┘łž▒ž”┘Ŗž│ ┘ä┘ģž¼┘äž│ ž¦┘ä┘å┘łž¦ž©žī ┘ł┘ģž╣ ž░┘ä┘ā ┘ä┘ģ ž¬ž¬ž©ž»┘æ┘ä ž¦┘䞣ž¦┘ä. ┘ģ┘å ž¼┘ćž®žī žźž│ž▒ž¦ž”┘Ŗ┘ä ž¬ž│ž¬ž©┘ŖžŁ ž¦┘äž¼┘å┘łž© ┘łž¦┘äž©┘鞦ž╣ ž©┘䞦 ž▒ž¦ž»ž╣: ž║ž¦ž▒ž¦ž¬ ┘łž¦ž║ž¬┘Ŗž¦┘䞦ž¬ ┘ģ┘łž½┘æ┘éž® ┘ģ┘å ž¦┘äžČž¦žŁ┘Ŗž® žź┘ä┘ē ┘é┘äž© ž¦┘äž╣ž¦žĄ┘ģž®žī ┘łž«ž▒┘ł┘鞦ž¬ ž¼┘ł┘Ŗž® ┘Ŗ┘ł┘ģ┘Ŗž® ž║┘Ŗž▒ žóž©┘ćž® ž©žŻ┘Ŗ ž¦ž¬┘üž¦┘é žŻ┘ł žźž╣┘䞦┘å ┘ł┘é┘ü žźžĘ┘䞦┘é ž¦┘ä┘垦ž▒. ┘ł┘ģ┘å ž¼┘ćž® žŻž«ž▒┘ēžī ž¬žŻž¬┘Ŗ ž¦┘䞦ž│ž¬ž©ž¦žŁž® ž¦┘ä┘ģž╣┘å┘ł┘Ŗž® ┘ä┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ┘ģ┘å ž¦┘äžźž»ž¦ž▒ž® ž¦┘䞯┘ģ┘Ŗž▒┘ā┘Ŗž® ž╣ž©ž▒ ┘ģž©ž╣┘łž½┘Ŗ┘枦: ┘ü┘Ć *┘ģ┘łž▒ž║ž¦┘å žŻ┘łž▒ž¬ž¦ž║┘łž│* žŁžČž▒ž¬ žź┘ä┘ē ž¦┘ä┘鞥ž▒ ž¦┘äž¼┘ģ┘ć┘łž▒┘Ŗ ┘ģž¬┘é┘ä┘æž»ž® *┘åž¼┘ģž® ž»ž¦┘ł┘łž»žī ž¦┘äž▒┘ģž▓ ž¦┘䞥ž▒┘ŖžŁ ┘ä┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘äž╣ž»┘łž®žī ┘łžŻž┤ž¦ž»ž¬ ž©žźž│ž▒ž¦ž”┘Ŗ┘ä ž¦┘䞬┘Ŗ ┘éžČž¬ ž╣┘ä┘ē žŁž▓ž© ž¦┘ä┘ä┘ć ž¦┘äž░┘Ŗ ┘ć┘ł ┘ģ┘ā┘ł┘å ┘äž©┘垦┘å┘Ŗ ┘łž¦ž▓┘å ž░ž¦ž¬ ž╣┘é┘Ŗž»ž® žźž│┘䞦┘ģ┘Ŗž® ž┤┘Ŗž╣┘Ŗž® ┘Ŗž╣ž¬ž▓ ž©┘枦žī ┘ā┘ģž¦ ž¦ž│ž¬ž«┘üž¬ ž©ž▓ž╣┘Ŗ┘ģ ž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗ ┘āž©┘Ŗž▒ ┘ł ┘łž¦ž▓┘å ž©ž╣ž©ž¦ž▒ž¦ž¬ ž▒ž«┘ŖžĄž® ┘䞦 ž¬┘ä┘Ŗ┘é ž©┘äž║ž® ž¦┘äž»ž©┘ä┘ł┘ģž¦ž│┘Ŗž®. ž½┘ģ ž¼ž¦žĪ **ž¬┘ł┘ģž¦ž│ ž©ž▒ž¦┘āžī žĄž»┘Ŗ┘é ž¬ž▒ž¦┘ģž© ž¦┘ä┘ģ┘éž▒┘æž©žī ┘ä┘Ŗ┘å┘éžČ ž¦┘ä┘łž╣┘łž» ┘ł┘Ŗ┘ć┘Ŗ┘å ž¦┘䞥žŁž¦┘ü┘Ŗ┘Ŗ┘å ┘ģ┘å ž©┘䞦žĘ ž¦┘ä┘鞥ž▒ ┘å┘üž│┘ćžī ┘ģžż┘ā┘æž»┘ŗž¦ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģ ž¦┘䞬ž¦┘ä┘Ŗ žŻ┘å ┘ģž¦ ┘鞦┘ä┘ć ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å ž▓┘ä┘æž® ┘äž│ž¦┘å ž©┘ä ┘ģ┘ł┘é┘ü┘ŗž¦ ┘ģ┘鞥┘łž»┘ŗž¦. ┘ł┘ģž¦ ┘Ŗž▓┘Ŗž» ž¦┘äžĘ┘Ŗ┘å ž©┘äž® žŻ┘å ž¦┘䞣┘ā┘ł┘ģž® ┘å┘üž│┘枦žī ž©ž»┘ä žŻ┘å ž¬ž»ž¦┘üž╣ ž╣┘å ž│┘Ŗž¦ž»ž¬┘枦žī žóž½ž▒ž¬ ž¦┘䞥┘ģž¬ žŻ┘ģž¦┘ģ ┘ā┘ä ┘ćž░┘ć ž¦┘䞦ž╣ž¬ž»ž¦žĪž¦ž¬žī ž©┘ä ž░┘ćž©ž¬ žŻž©ž╣ž» žŁ┘Ŗ┘å žŻ┘üž▒ž¼ž¬ ž╣┘å ž╣┘ģ┘Ŗ┘ä ┘ģžŁ┘ā┘ł┘ģ ž©ž«┘ģž│ ž╣ž┤ž▒ž® ž│┘åž® ž©ž¼ž▒┘ģ ž¦┘äž╣┘ģž¦┘äž®žī ┘ł┘ć┘ł ž¦┘ä┘ģž│žż┘ł┘ä ž¦┘ä┘ģž©ž¦ž┤ž▒ ž╣┘å **ž¬┘üž¼┘Ŗž▒ ŌĆ£ž¦┘äž©┘Ŗž¼ž▒ŌĆØ* ž¦┘äž░┘Ŗ žŻ┘łž»┘ē ž©žŁ┘Ŗž¦ž® ž¦┘äž╣ž┤ž▒ž¦ž¬ ┘łž¬ž│ž©┘æž© ž©žźž╣ž¦┘鞦ž¬ ž»ž¦ž”┘ģž® ┘ä┘āž½┘Ŗž▒┘Ŗ┘åžī ┘䞬ž│┘ä┘æ┘ģ┘ć ┘ģ┘å ž»┘ł┘å ┘é┘Ŗž» žŻ┘ł ž┤ž▒žĘ žź┘ä┘ē ž¦┘ä┘ā┘Ŗž¦┘å ž¦┘äžźž│ž▒ž¦ž”┘Ŗ┘ä┘Ŗ. ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ł┘鞦ž”ž╣ ┘ģž¼ž¬┘ģž╣ž® ž¬ž©ž▒┘ć┘å žŻ┘å ž¦┘āž¬┘ģž¦┘ä ž¦┘äž│┘äžĘž® ┘ä┘ģ ┘Ŗž║┘Ŗ┘æž▒ ž┤┘Ŗž”┘ŗž¦:
┘ģ┘łž¦┘é┘ü ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łžĄ┘ģž¬┘枦 žŻ┘ģž¦┘ģ ┘ćž░┘ć ž¦┘䞦ž╣ž¬ž»ž¦žĪž¦ž¬ ž»┘üž╣ž¬ ž¦┘ä┘ģ┘łž¦žĘ┘å┘Ŗ┘å žź┘ä┘ē ž¦┘äž┤ž╣┘łž▒ ž©žŻ┘å┘枦 ž«ž¦žČž╣ž® ┘äžČž║┘łžĘ žŻ┘ł ž¬ž»ž«┘䞦ž¬ ž«ž¦ž▒ž¼┘Ŗž®žī ž©ž»┘ä žŻ┘å ž¬┘ā┘ł┘å ┘ģž╣ž©┘æž▒ž® ž╣┘å žźž▒ž¦ž»ž® ž│┘Ŗž¦ž»┘Ŗž® ┘ģž│ž¬┘é┘äž®žī
┘łž╣ž¦ž¼ž▓ž® ž╣┘å žĄ┘ł┘å ž│┘Ŗž¦ž»ž¬┘枦 žŻ┘ł žŁ┘ģž¦┘Ŗž® ž┤ž╣ž©┘枦žī ┘ł┘䞦 ┘üž▒┘é žź┘å ┘āž¦┘垬 ž¦┘ä┘āž▒ž¦ž│┘Ŗ ┘ģž┤ž║┘ł┘äž® žŻ┘ł ┘üž¦ž▒ž║ž®žī ┘üž¦┘ä┘ģž┤┘ā┘äž® žŻž╣┘ģ┘é ┘ģ┘å ž¦┘䞯ž┤ž«ž¦žĄžī ┘ł┘ć┘Ŗ ┘ü┘Ŗ ž©┘å┘Ŗž® ž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®ŌĆōž¦┘鞬žĄž¦ž»┘Ŗž® ┘ģ┘āž©┘æ┘äž® ž©ž¦┘äž«ž¦ž▒ž¼ ž¬┘ģ┘åž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ģ┘å žŻ┘å ž¬┘ā┘ł┘å ┘üž╣┘ä┘ŗž¦ ž»┘ł┘äž® ž│┘Ŗž¦ž»ž®.
┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģž│žż┘ł┘ä ž╣┘å ž║┘Ŗž¦ž© ž¦┘äž»┘ł┘äž®ž¤
ž│┘Ŗ┘é┘ł┘ä ž©ž╣žČ┘ć┘ģ žź┘å ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ć┘Ŗ ž¦┘䞬┘Ŗ ┘ģ┘åž╣ž¬ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ģ┘å ž¦┘ä┘å┘ć┘łžČžī ┘łžź┘å ž¦┘äž│┘䞦žŁ ž«ž¦ž▒ž¼ ž¦┘äž┤ž▒ž╣┘Ŗž® ┘Ŗž│┘éžĘ ž¦┘ä┘ģ┘łž¦žĘ┘åž®. ┘ä┘ā┘å ┘ćž░ž¦ ž¦┘äž«žĘž¦ž© ž¦┘ä┘ģ┘āž▒ž▒ ┘Ŗž¬┘枦┘ł┘ē žŻ┘ģž¦┘ģ ž¦┘ä┘ł┘鞦ž”ž╣: ┘üž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘ģ┘āž¬┘ģ┘äž® ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ┘ć┘Ŗ ž¦┘䞬┘Ŗ ž│┘ä┘æ┘ģž¬ ž╣┘ģ┘Ŗ┘ä┘ŗž¦ ┘鞦ž¬┘ä┘ŗž¦ ┘ä┘äž╣ž»┘ł ┘ģ┘å ž»┘ł┘å ┘é┘Ŗž» žŻ┘ł ž┤ž▒žĘžī ┘łžĄ┘ģž¬ž¬ žŻ┘ģž¦┘ģ ž¦ž║ž¬┘Ŗž¦┘䞦ž¬ ┘łž¦ž╣ž¬ž»ž¦žĪž¦ž¬ ┘Ŗ┘ł┘ģ┘Ŗž®žī ┘ü┘Ŗ┘ģž¦ ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘łžŁž»┘枦 ┘ģ┘åž╣ž¬ ž│┘é┘łžĘ ž¦┘ä┘éž▒┘ē ┘łž¦┘ä┘垦ž│. ┘üžŻ┘Ŗ ┘ģ┘łž¦žĘ┘åž® ┘ćž░┘ć ž¦┘䞬┘Ŗ ┘䞦 ž¬žŁ┘ģ┘Ŗ ž»┘ģ┘ŗž¦ ┘ł┘䞦 ž¬žĄ┘ł┘å ┘āž▒ž¦┘ģž®ž¤
žź┘å ž¦┘ä┘ģ┘łž¦žĘ┘åž® ž¦┘䞣┘é┘Ŗ┘é┘Ŗž® ┘ä┘Ŗž│ž¬ ┘åžĄ┘ŗž¦ ž¼ž¦┘ģž»┘ŗž¦ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒žī ž©┘ä ┘éž»ž▒ž® ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž╣┘ä┘ē žŁ┘ģž¦┘Ŗž® ž┤ž╣ž©┘枦 ž©ž╣ž»┘ä ┘ł┘ģž│ž¦┘łž¦ž®. ┘łžĘž¦┘ä┘ģž¦ žŻ┘å žŻžĄžŁž¦ž© ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ć┘ģ ┘ģ┘ā┘ł┘æ┘å ┘äž©┘垦┘å┘Ŗ ┘ģž╣ž¬ž©ž▒ ┘łž▒ž¦ž│ž«žī ┘üžź┘å ž¦┘䞬┘ü┘ā┘Ŗž▒ ┘ü┘Ŗ ž╣ž▓┘ä┘ć┘ģ ž╣┘å ┘ģž┤ž▒┘łž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ä┘Ŗž│ ┘ü┘éžĘ ┘ł┘ć┘ģ┘ŗž¦žī ž©┘ä ┘ģž║ž¦┘äžĘž® ┘ä┘ä┘łž¦┘éž╣ ┘łž«┘Ŗž¦┘åž® ┘ä┘ü┘āž▒ž® ž¦┘ä┘ģ┘łž¦žĘ┘åž® ┘å┘üž│┘枦. ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘äž╣ž¦ž»┘äž® ┘䞦 ž¬┘é┘ł┘ģ ž©žź┘鞥ž¦žĪ ┘ģ┘ā┘ł┘æ┘垦ž¬ ž┤ž╣ž©┘枦žī ž©┘ä ž©žź┘Ŗž¼ž¦ž» žŁ┘ä┘ł┘ä ž¼ž¦┘ģž╣ž® ž¬ž¼ž╣┘ä ž¦┘äž¼┘ģ┘Ŗž╣ ž┤ž▒┘āž¦žĪ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž®. ┘ł┘ā┘ä ┘ģ┘å ┘Ŗž¬žĄ┘łž▒ žŻ┘å ┘äž©┘垦┘å ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å žŻ┘å ┘Ŗ┘Åž©┘å┘ē ž©ž¦ž│ž¬ž©ž╣ž¦ž» ┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘ģ┘ā┘ł┘æ┘åžī žź┘å┘ģž¦ ┘Ŗž║ž¦┘äžĘ ┘å┘üž│┘ć žŻ┘ł┘ä┘ŗž¦ ┘ł┘Ŗž║ž¦┘äžĘ ž¦┘ä┘łž¦┘éž╣žī ┘ł┘ŖžĄž©žŁ ┘ć┘ł ž¦┘äž╣ž½ž▒ž® ž¦┘䞣┘é┘Ŗ┘é┘Ŗž® žŻ┘ģž¦┘ģ ┘é┘Ŗž¦┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž®.
žź┘å ┘ģž¦ žŻž▒┘Ŗž» ž¦┘䞬žŻ┘ā┘Ŗž» ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ┘ć┘垦 ┘ć┘ł žŻ┘å ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘䞦 ž¬┘äž║┘Ŗ ž¦┘ä┘ģ┘łž¦žĘ┘åž® ┘ł┘䞦 ž¬ž¬ž╣ž¦ž▒žČ ┘ģž╣┘枦. ┘üž¦┘ä┘ģ┘łž¦žĘ┘åž® ┘ć┘Ŗ ž¦┘äžźžĘž¦ž▒ ž¦┘äž░┘Ŗ ┘ŖžŁ┘üžĖ ž¦┘ä┘ģž│ž¦┘łž¦ž® ž©┘Ŗ┘å ž¦┘äž¼┘ģ┘Ŗž╣žī ┘łž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ć┘Ŗ ž¦┘äž©ž╣ž» ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗ┘ģ┘åžŁ ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å ž¦┘ä┘ģž╣┘å┘ē ┘łž¦┘ä┘āž▒ž¦┘ģž®. ┘łžŻžĄžŁž¦ž© ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å žŻ┘å ┘Ŗ┘ā┘ł┘å┘łž¦ ┘ģ┘łž¦žĘ┘å┘Ŗ┘å žĄž¦┘䞣┘Ŗ┘å ┘ł┘ģž«┘䞥┘Ŗ┘å ┘ü┘Ŗ žĖ┘ä ž»┘ł┘äž® ž╣ž¦ž»┘äž® ┘łž│┘Ŗž»ž®žī ž¬ž┤ž╣ž▒┘ć┘ģ ž©ž¦┘䞣┘ģž¦┘Ŗž® ┘łž¦┘䞯┘ģž¦┘å ┘łž¦┘äž╣ž»┘ä. žŻ┘ģž¦ ┘ģ┘å ┘Ŗž¬žĄ┘łž▒ žŻ┘å ž©žź┘ģ┘āž¦┘å┘ć ž©┘垦žĪ ž»┘ł┘äž® ž╣ž©ž▒ ž¬ž¼ž¦┘ć┘ä ┘ģ┘ā┘ł┘æ┘å ┘äž©┘垦┘å┘Ŗ ┘āž¦┘ģ┘ä ž©ž│ž©ž© ž╣┘é┘Ŗž»ž¬┘ćžī ┘üžź┘å┘ć ┘䞦 ┘Ŗž«ž»┘ģ ┘ģž┤ž▒┘łž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž©┘ä ┘Ŗ┘üž¬žŁ ž¦┘äž©ž¦ž© ┘ä┘䞬žĄž¦ž»┘ģ ┘łž¦┘䞦┘å┘éž│ž¦┘ģ
#ž¦┘䞣┘ä ┘Ŗ┘ā┘ģ┘å ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžźž¬ž¼ž¦┘ć ┘åžŁ┘ł ž▒žż┘Ŗž® ž¼ž¦┘ģž╣ž®
ž¦┘䞣┘ä ┘䞦 ┘Ŗ┘ā┘ł┘å ž©žź┘äž║ž¦žĪ ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ł┘䞦 ž©žź┘äž║ž¦žĪ ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ž©┘ä ž©ž«┘ä┘é žĄ┘Ŗž║ž® ž¬┘āž¦┘ģ┘ä:
- ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¬┘ģž¦ž▒ž│ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ┘łž¬ž©┘å┘Ŗ ž¦┘ä┘ģžżž│ž│ž¦ž¬ ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž╣ž»ž¦┘äž® ┘łž¦┘ä┘ģž│ž¦┘łž¦ž®.
- ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ž¬ž©┘é┘ē žČ┘ģž¦┘åž® žŻž«┘䞦┘é┘Ŗž® ┘ł┘ģž╣┘å┘ł┘Ŗž® ž¬ž░┘ā┘æž▒ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž©┘łž¦ž¼ž©ž¦ž¬┘枦žī ┘łž¬┘å┘ćžČ ž│ž¦ž╣ž® ž¦┘äž╣ž¼ž▓.
┘ü┘Ŗ ž¦┘äžĖž▒┘ł┘ü ž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣┘Ŗž®žī ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¬žŁž¬┘āž▒ ž¦┘äž╣┘å┘ü ž¦┘äž┤ž▒ž╣┘Ŗ. žŻ┘ģž¦ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžĖž▒┘ł┘ü ž¦┘䞦ž│ž¬ž½┘垦ž”┘Ŗž®žī ž¬žĄž©žŁ ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ć┘Ŗ ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬ž│ž»┘æ ž¦┘ä┘üž▒ž¦ž║ ┘łž¬žŁ┘ģ┘Ŗ ž¦┘ä┘łžĘ┘å žŁž¬┘ē ž¬ž│ž¬ž╣┘Ŗž» ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž╣ž¦┘ü┘Ŗž¬┘枦.
ž«ž¬ž¦┘ģž¦žī žź┘å ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ä┘Ŗž│ž¬ ž╣ž¦ž”┘é┘ŗž¦ žŻ┘ģž¦┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ž©┘ä ž┤ž▒┘Ŗ┘ā┘ŗž¦ ┘ä┘枦 ┘ģž¬┘ē ┘āž¦┘垬 ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž╣ž¦ž»┘äž® ┘łž│┘Ŗž»ž®. ┘łž¦┘ä┘łž¦┘éž╣ žŻ┘å ┘ģ┘å ┘Ŗ┘ģ┘åž╣ ┘é┘Ŗž¦┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ü┘Ŗ ┘äž©┘垦┘å ┘ä┘Ŗž│ ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ł┘䞦 ž¼┘ģ┘ć┘łž▒┘枦žī ž©┘ä ž¦┘ä┘ģž┤ž▒┘łž╣ ž¦┘äž«ž¦ž▒ž¼┘Ŗ ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗ┘üž▒žČ ž¦┘ä┘łžĄž¦┘Ŗž® ┘ł┘Ŗž▓ž▒ž╣ ž¦┘䞦┘å┘éž│ž¦┘ģ. ┘äž░┘ä┘āžī ┘üžź┘å ž¦┘äžĘž▒┘Ŗ┘é žź┘ä┘ē ž»┘ł┘äž® ┘é┘ł┘Ŗž® ┘䞦 ┘Ŗ┘ģž▒┘æ ž╣ž©ž▒ ┘ģ┘枦ž¼┘ģž® ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® žŻ┘ł ž╣ž▓┘ä žŻžĄžŁž¦ž©┘枦žī ž©┘ä ž╣ž©ž▒ ž¬žŁž▒┘Ŗž▒ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ģ┘å ž¦┘䞦ž▒ž¬┘枦┘å ┘łž¦┘äž©žŁž½ ž╣┘å ž¦┘ä┘ģž┤ž¬ž▒┘āž¦ž¬.
┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ģž┤ž¬ž▒┘āž¦ž¬ ┘łž¦žČžŁž® ┘łž©ž│┘ŖžĘž®:
ž¦┘äž╣ž»┘äžī ž¦┘ä┘āž▒ž¦┘ģž®žī žŁ┘ģž¦┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģž¼ž¬┘ģž╣žī ┘łž▒┘üžČ ž¦┘äžĖ┘ä┘ģ.
┘ł┘ć┘Ŗ ┘ģž¦ ┘Ŗ┘䞬┘é┘Ŗ ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ž¦┘ä┘äž©┘垦┘å┘Ŗ┘ł┘å ž¼┘ģ┘Ŗž╣┘ŗž¦žī ┘ł┘ģž¦ ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å žŻ┘å ┘Ŗ┘ā┘ł┘å žŻž│ž¦ž│ ž¦┘äž╣┘éž» ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗ ž¦┘äž¼ž»┘Ŗž».
┘é┘Ŗ┘ģ ž¬ž¬┘鞦žĘž╣ ┘ü┘Ŗ┘枦 ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ģž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘ł┘䞦 ž¬ž«žĄ žĘž¦ž”┘üž® ┘łž¦žŁž»ž® žŻ┘ł žŁž▓ž©┘ŗž¦ ┘łž¦žŁž»┘ŗž¦žī ž©┘ä ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å žŻ┘å ž¬┘䞬┘é┘Ŗ žŁ┘ł┘ä┘枦 ┘ģž«ž¬┘ä┘ü ž¦┘ä┘ģž╣ž¬┘éž»ž¦ž¬ ┘łž¦┘䞦┘垬┘ģž¦žĪž¦ž¬. ┘łž╣┘ä┘ē ž¦┘äž»┘ł┘äž® žŻ┘å ž¬ž│ž╣┘ē žź┘ä┘ē ┘ü┘ć┘ģ ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ģž┤ž¬ž▒┘āž¦ž¬ ┘łž¦┘䞦ž╣ž¬ž▒ž¦┘ü ž©┘枦žī ┘䞦 žź┘ä┘ē ┘üž▒žČ ┘å┘ģ┘łž░ž¼ ┘łž¦žŁž» žŻ┘ł žź┘äž║ž¦žĪ ž¦┘䞬ž╣ž»ž».
┘üž¦┘äž╣┘鞦ž”ž» ┘䞦 ž¬┘Å┘ģžŁ┘ē ┘ł┘䞦 ž¬┘Å┘üž▒┘ĞȞī žź┘å┘ģž¦ ž¬┘Åž╣ž¦ž┤ ┘ü┘Ŗ ┘łž¼ž»ž¦┘å ž¦┘ä┘垦ž│. ┘ł┘ģž¦ ┘ŖžČ┘ģ┘å ž¦┘äž╣┘Ŗž┤ ž¦┘ä┘ģž┤ž¬ž▒┘ā ┘ł┘é┘Ŗž¦┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ć┘ł ž¦┘䞬ž▒┘ā┘Ŗž▓ ž╣┘ä┘ē ┘ģž¦ ┘ć┘ł ┘ģž┤ž¬ž▒┘āžī ┘łž¦┘äž©┘垦žĪ ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ┘䞥┘Ŗž¦ž║ž® ┘ģ┘łž¦žĘ┘åž® ž¼ž¦┘ģž╣ž®žī žŁ┘Ŗž½ ┘Ŗž┤ž╣ž▒ ┘ā┘ä ┘ģ┘łž¦žĘ┘å žŻ┘å ┘āž▒ž¦┘ģž¬┘ć ┘ģžĄž¦┘åž® ž©ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ┘łžŻ┘å ž¦┘垬┘ģž¦žĪ┘ć ┘䞦 ┘Ŗž¬┘垦┘éžČ ┘ģž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž©┘ä ┘Ŗž╣ž▓┘æž▓┘枦.
┘ł┘äž╣┘ä ž¦┘䞬žŁž»┘Ŗ ž¦┘䞯┘āž©ž▒ ┘ć┘ł ž¬žŁ┘ł┘Ŗ┘ä ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘é┘Ŗ┘ģ ž¦┘ä┘ģž┤ž¬ž▒┘āž® ┘ģ┘å ┘ģž©ž¦ž»ž” žŻž«┘䞦┘é┘Ŗž® žź┘ä┘ē ž╣┘éž» ž¦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗ ┘ģ┘äž▓┘ģžī ž¬┘Åž¬ž▒ž¼┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒ ┘łž¦┘ä┘é┘łž¦┘å┘Ŗ┘åžī ž©žŁ┘Ŗž½ ž¬žĄž©žŁ ž¦┘äž╣ž»┘ä ┘łž¦┘ä┘āž▒ž¦┘ģž® ┘łžŁ┘ģž¦┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģž¼ž¬┘ģž╣ ┘łž▒┘üžČ ž¦┘äžĖ┘ä┘ģ ž½┘łž¦ž©ž¬ ┘łžĘ┘å┘Ŗž® ┘ü┘ł┘é ž¦┘䞦┘å┘éž│ž¦┘ģž¦ž¬žī ┘łžČ┘ģž¦┘åž® ┘ä┘é┘Ŗž¦┘ģ ž»┘ł┘äž® ž╣ž¦ž»┘äž® ž│┘Ŗž»ž® ž¬ž│ž¬┘łž╣ž© ž¦┘äž¼┘ģ┘Ŗž╣.
┘üž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ä┘Ŗž│ž¬ ž╣ž¦ž”┘é┘ŗž¦ žŻ┘ģž¦┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ģž¬┘ē ž¦┘䞬┘鞬ž¦ ž╣┘ä┘ē ┘é┘Ŗ┘ģ ž¦┘äž╣ž»┘ä ┘łž¦┘ä┘āž▒ž¦┘ģž®ŌĆ” ┘ä┘ā┘å ž╣┘ä┘ē žŁž¦┘ģ┘ä┘Ŗ ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® žŻ┘å┘üž│┘ć┘ģ žŻ┘å ┘Ŗž│ž╣┘łž¦ ž»ž¦ž”┘ģ┘ŗž¦ ┘äž▒ž»┘ģ ž¦┘ä┘üž¼┘łž® ž©┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘ü┘āž▒ ┘łž¦┘ä┘ģ┘ģž¦ž▒ž│ž®žī žŁž¬┘ē ž¬ž©┘é┘ē ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ģžĄž»ž▒ ┘é┘łž® žŻž«┘䞦┘é┘Ŗž® žŻž▒┘üž╣ ┘ģ┘å ž¦┘䞦┘垬┘鞦ž»
ž¦┘ä┘ģž▒ž¦ž¼ž╣
ž¼┘ģ┘Ŗž╣ ž¦┘ä┘ł┘鞦ž”ž╣ ┘łž¦┘䞯žŁž»ž¦ž½ ž¦┘ä┘łž¦ž▒ž»ž® ┘ü┘Ŗ ┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘ģ┘鞦┘ä ┘ģ┘łž½┘éž® ┘ü┘Ŗ ž¬┘鞦ž▒┘Ŗž▒ žźž«ž©ž¦ž▒┘Ŗž® ┘ģ┘åž┤┘łž▒ž® ž©┘Ŗ┘å ž╣ž¦┘ģ┘Ŗ 2024ŌĆō2025žī ┘ģ┘å┘枦 ┘ģž¦ ┘łž▒ž» ┘ü┘Ŗ ┘ł┘āž¦┘䞦ž¬ ž╣ž¦┘ä┘ģ┘Ŗž® ┘ģž½┘ä ž▒┘ł┘Ŗž¬ž▒ž▓ ┘ł┘ł┘āž¦┘äž® žŻž│┘łž┤┘Ŗž¬ž» ž©ž▒ž│žī ┘ł┘ü┘Ŗ ┘łž│ž¦ž”┘ä žźž╣┘䞦┘ģ ž╣ž▒ž©┘Ŗž® ┘ł┘äž©┘垦┘å┘Ŗž® ┘ģ┘å ž©┘Ŗ┘å┘枦 ž¦┘äž¼ž▓┘Ŗž▒ž®žī ┘łž¦┘䞯ž«ž©ž¦ž▒žī ┘łž¦┘ä┘ĆLBCžī ┘łž║┘Ŗž▒┘枦.
-ž¼ž¦┘å ž¼ž¦┘ā ž▒┘łž│┘łžī ž¦┘äž╣┘éž» ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗžī 1762 (ž¦┘ä┘åžĄ ž¦┘ä┘ā┘䞦ž│┘Ŗ┘ā┘Ŗ ž¦┘ä┘ģžżž│ž│ ┘ä┘ģ┘ü┘ć┘ł┘ģ ž¦┘äž╣┘éž» ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗžī ┘ģž¬┘ł┘üž▒ ž©žĄ┘Ŗž║ž® PDF┬Āž╣┘ä┘ē┬Āž¦┘äžź┘垬ž▒┘垬
 ž¦┘äž«┘Ŗž¦┘ģ | khiyam.com
ž¦┘äž«┘Ŗž¦┘ģ | khiyam.com 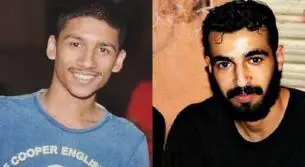











ž¬ž╣┘ä┘Ŗ┘鞦ž¬: